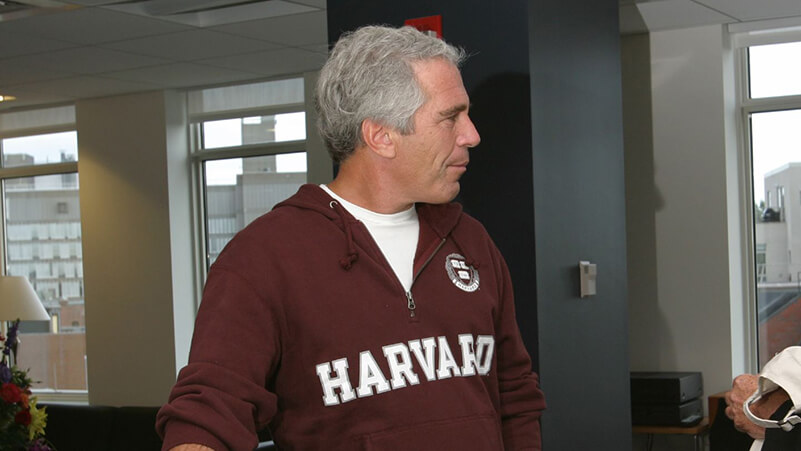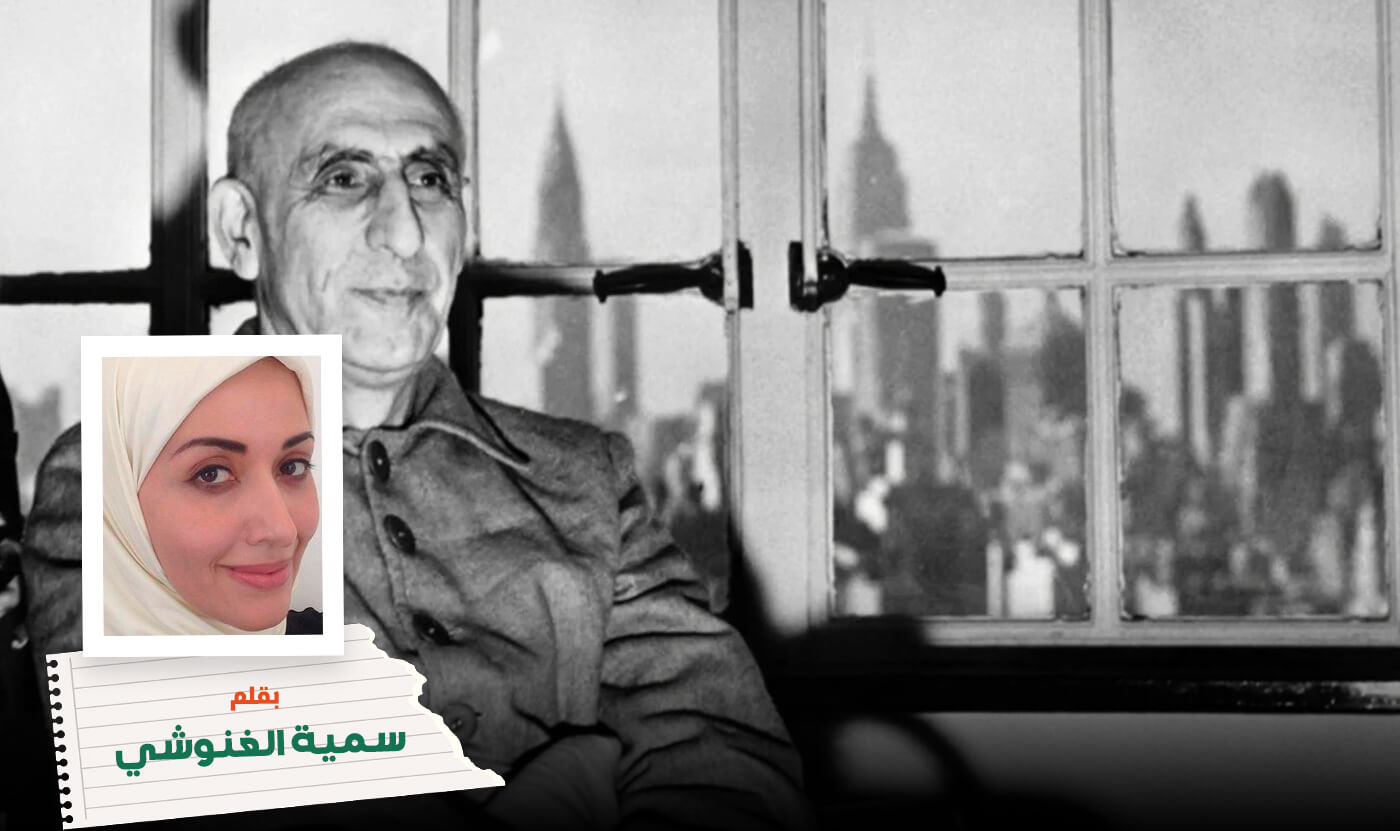بقلم ديفيد هيرست
ترجمة وتحرير نجاح خاطر
من المغري اختزال كل الفوضى والكراهية والدماء التي سُفكت في عام 2025 في إطار رجل واحد: ألا وهو دونالد ترامب، فهو يستحق عن جدارة لقب أسوأ رئيس في التاريخ الأميركي الحديث، لكنه في الوقت ذاته الأكثر تأثيرًا وتسبباً بنتائج كارثية.
غير أن التركيز على ترامب وحده يُخفي حقيقة أعمق وهي أن عام 2025 لم يكن مجرد انحرافً عابر، بل تتويجًا لخمسةٍ وعشرين عامًا من الفشل الأميركي المتراكم، فشلٌ لم يأت وليد نزوة فرد، بل نتاج عقلية كاملة عاجزة عن التعلّم من أخطائها أو ممارسة أي شكل من أشكال القيادة العالمية الرشيدة.
في عهد الرئيس ترامب، قصفت الولايات المتحدة إيران، وفتحت الطريق أمام دولة الاحتلال لغزو جنوب سوريا، واستُكمل تدمير غزة، وبدأ تنفيذ مشروع ضم الضفة الغربية المحتلة، أما التطهير العرقي في السودان، المموّل والمسلّح إماراتيًا، فلم يكن ليحظى بأكثر من تجاهل بارد، ما أدى إلى سقوط ما يصل إلى نصف مليون سوداني لا يعنون له شيئًا.
بعد ثلاثة أشهر فقط من الكشف عن ما وصفه ترامب بـ”خطة السلام الجميلة والكبيرة”، تشكّلت في غزة حقيقة ميدانية تناقضها بالكامل: وصفة قبيحة وحقيرة لحرب بلا نهاية.
لم تكتفِ دولة الاحتلال بترك أكثر من مليوني فلسطيني في غزة يرتجفون بردًا وجوعاً داخل خيام مهترئة، بل حتى عندما أغرقتهم العواصف، علت الهتافات في داخل دولة الاحتلال احتفالًا، وتحوّل قتل الفلسطينيين إلى هوس قومي داخلها.
وكان وزير الحرب في دولة الاحتلال، إسرائيل كاتس، قد أعلن مؤخرًا خططًا لتوطين شمال غزة بشكل دائم، قائلًا: “نحن في عمق غزة، ولن نغادرها أبدًا، لن يكون هناك شيء اسمه الانسحاب الكامل، نحن هنا للحماية ومنع تكرار ما حدث”، وهكذا تبخّرت أي آمال بانسحاب شامل كما روّجت له خطة ترامب.
انهيار أخلاقي شامل
تنقّل ترامب بين موسكو وكييف، من دون أن يتمكّن خلال عام كامل من تحقيق ما وعد به ناخبيه خلال أيام معدودة، وعندما قُتل المخرج السينمائي الأميركي بوب راينر وزوجته على يد ابنهما، في مأساة إنسانية يفترض أن تثير تعاطف أي أب، انفجر ترامب بحقده المعتاد، وأعلن على منصته “تروث سوشال” أن راينر يتحمّل مسؤولية مقتله لأنه “أصاب الآخرين بالجنون” بهوسه بعدائه لترامب.
هذه هي الذهنية التي علّقت عليها معظم الأنظمة العربية الثرية آمالها، ودفعَت لها أموالًا طائلة، وتنتظر منها الخلاص، لم يُعلَّق في التاريخ هذا الكم من التوقعات على عقلية بهذا الضيق.
إنه الرجل ذاته الذي تنتظر منه سوريا أن يضغط على دولة الاحتلال لوقف تسليح الدروز في السويداء، وفق تحقيق لصحيفة واشنطن بوست، وهو الرجل الذي تأمل تركيا أن يُجبر الأكراد على الإندماج في جيش وطني سوري لم يولد بعد، والذي تراهن عليه قطر لإنشاء قوة استقرار دولية على حدود غزة، والذي تطلب منه السعودية مفاعلًا نوويًا، والذي يعتمد عليه رئيس مصر ، بل ربما الزعيم العربي التالي الآيل للسقوط، للبقاء السياسي.
وسط هذا المشهد العبثي، لا يوجد رابح حقيقي سوى القوة الغائبة عن الفوضى، ألا وهي الصين، فإن القصة الكبرى لعام 2025 هي تثبيت موقع الصين كوليّ عهدٍ للنظام العالمي، وكقائدٍ قادمٍ سلّمته الولايات المتحدة مفاتيح الصعود على طبقٍ من فضة.
إن ما كان أكثر فائدة للصين من كل استراتيجياتها وصبرها وتخطيطها، هو الانهيار الأخلاقي الأميركي، فكل ما كان على بكين فعله هو تحمّل نوبات غضب ترامب التجارية، ومشاهدة الولايات المتحدة وهي تنهار تحت ثقلها الذاتي.
كيف يتحوّل النصر إلى هزيمة؟
كيف انتزعت الولايات المتحدة الهزيمة من فم النصر؟ الجواب هو الغطرسة، جنون العظمة، والإيمان بأنها آخر رجل واقف في الساحة، وبالتالي الرجل الوحيد الذي يحق له الوقوف، هذه كلها أجزاء من الصورة.
لذلك، فإن النخب الليبرالية المنتهية الصلاحية في أميركا وأوروبا، التي حكمت لعقود طويلة، تخدع نفسها حين تُرجع فوضى 2025 إلى صعود اليمين المتطرف داخليًا وخارجيًا فقط، ما نشهده ليس نهاية عام سيئ فحسب، بل نهاية الربع الأول من القرن، وبدايته كانت كارثية.
عند مقارنة قوة الولايات المتحدة والغرب في عيد الميلاد عام 1991 ، عندما شاهدت العلم السوفيتي يُنزل عن مبنى البرلمان الروسي، بما آلت إليه الأمور اليوم، لا يمكن الوصول إلا إلى نتيجة واحدة: أن الولايات المتحدة خسرت الفرصة التي امتلكتها بأن تصبح القائد العالمي الأوحد، بل أهدرت تلك الفرصة بالكامل.
ففي عام 1991، كانت الولايات المتحدة تحتكر استخدام القوة خارج حدودها، أما اليوم، فتتوزع هجمات الطائرات المسيّرة بين دول وفاعلين من دول أخرى، ففي عام 1991، كانت روسيا منهارة، أما اليوم فقد أصبحت تهدد أوكرانيا وأوروبا الغربية بأسرها.
آنذاك، كان الشارع الروسي مواليًا للغرب إلى حد التساؤل عمّا إذا كان ينبغي الاستمرار باستخدام مصطلح “الغرب” أصلًا، باعتبار روسيا جزءًا منه، أما اليوم، فموسكو مستعدة للتضحية بجيل كامل من شبابها في حرب تُقدَّم داخليًا باعتبارها حربًا مع أميركا.
كما أن الهزائم العسكرية جزء آخر من هذه الصورة، فقد كان ينبغي للبنتاغون وقيادة حلف الناتو في بروكسل أن يطرحوا هذا السؤال منذ زمن بعيد: لماذا لم تنتصر التحالفات الغربية “الراغبة” في أي حرب منذ كوسوفو عام 1998؟
أفغانستان، العراق، اليمن، ليبيا، سوريا… جميعها انتهت بهزائم، سواء أُعلنت التدخلات أم أُخفيت، وسواء قادها الغرب مباشرة أم من خلف الستار، المتعة السريعة لإسقاط الأنظمة تبعتها في كل مرة حقيقة قاسية: تمرّد، حرب أهلية، ثم انسحاب عسكري.
أعداء متخيَّلون
لقد لعبت الأيديولوجيا دورًا حاسمًا في هذا المسار، لكن ليس المقصود هنا ما يُسمّى بـ”أيديولوجيا الإسلام الراديكالي”، بل الأيديولوجيا التي جعلت الولايات المتحدة وحلفاءها قوة عالمية عدوانية على هذا النحو، وهي أيديولوجيا تتجاوز، في طموحها وحدّتها، إمبريالية القرن التاسع عشر التي تبدو، بالمقارنة، محدودة الأفق.
إنها الفكرة القائلة إن الديمقراطية الليبرالية الغربية تواجه، في كل مرحلة تاريخية، عدوًا كونيًا وجوديًا لا يقبل التسوية، فخلال الحرب الباردة كان هذا العدو هو الشيوعية، وبعدها أصبحت القاعدة الخطر العالمي الأول، ثم جاء تنظيم الدولة (داعش)، واليوم، بات “الإخوان المسلمون” هم العدو الجديد، وغدًا سيكون الإسلام ذاته.
ورغم أن هؤلاء “الأعداء” لا يجمع بينهم أي قاسم فكري أو تنظيمي مشترك، فإنهم يمنحون الخصائص نفسها، تُختزل في صورة تهديد كاسح يبرّر كل أشكال العنف والتدخل.
خلال حرب فيتنام، تجسدت هذه الذهنية في “نظرية الدومينو”، التي زعمت أن سقوط جنوب شرق آسيا في يد الشيوعية سيجعل أستراليا الهدف التالي، وفي حقبة القاعدة، استُبدلت هذه النظرية بـ”هلال الأزمات” الممتد من العراق إلى الصومال.
هذه الأيديولوجيا سبقت أحداثًا كبرى مثل هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، وساعدت في تحويل ما كان ينبغي أن يكون عملية أمنية محدودة إلى “حرب على الإرهاب” شاملة ومفتوحة، وكان من الضروري، لإنجاح هذا المشروع، ألا يُعرَّف العدو تعريفًا دقيقًا.
بهذا المنطق، جرى دمج الحرب الدموية التي شنّها فلاديمير بوتين على الشيشان، في أولى سنواته رئيسًا للوزراء ثم رئيسًا لروسيا، داخل إطار “الحرب على الإرهاب” التي أعلنها جورج بوش الابن، بل أُرسل رئيس الوزراء البريطاني آنذاك، توني بلير، بدعوة من واشنطن، لدعوة بوتين إلى لقاء الملكة إليزابيث الثانية، بينما كانت أساليب القمع الروسية تُختبر على الشيشانيين، قبل أن تُستخدم لاحقًا ضد الأوكرانيين بعد أكثر من عقدين.
لم يكن ذلك يهم أجهزة الاستخبارات الغربية، فهؤلاء كانوا “مجرد مسلمين”، وبعد خمسةٍ وعشرين عامًا، تبدو الولايات المتحدة عاجزة بنيويًا عن التعلّم من أخطائها.
انحدار نهائي
عندما توفي ديك تشيني، نائب الرئيس الأميركي الأسبق وأحد مهندسي “الحرب على الإرهاب”، انهالت عبارات الثناء، فقد امتدحه بيل كلينتون على “إحساسه الثابت بالواجب”، فيما وصفته كامالا هاريس بـ”الخادم العام المتفاني”، أما شبكة سي إن إن فقد احتفت بدوره في دعم ابنته ضد ترامب.
هكذا مُجّد رجل بنى ذريعة غزو العراق على كذبتين مركّبتين هما امتلاك صدام حسين أسلحة دمار شامل، ووجود صلات بين نظامه وتنظيم القاعدة، وفي عام 2004، قال تشيني: “ما زلت أعتقد أن هناك أدلة ساحقة على وجود صلة بين القاعدة والحكومة العراقية”.
لقد كانت محاولات تقدير الكلفة البشرية لحرب العراق كثيرة، لكن أحدثها أجريت في عام 2023 من قبل باحثين في جامعة براون استنادًا إلى بيانات الأمم المتحدة، وخلصت إلى أن غزو العراق وحملات “الحرب على الإرهاب” المرتبطة به أسفرت عن مقتل أكثر من 4.5 ملايين إنسان، بينهم نحو مليون قتيل مباشر و3.5 ملايين وفاة غير مباشرة، إضافة إلى مقتل 7 آلاف جندي أميركي و8 آلاف متعاقد.
هناك شيء في نفسية القوة الإمبراطورية المتداعية يحجب عنها الحقيقة الواضحة: الحروب التي شُنّت باسم الدفاع عن الديمقراطية دمّرت الإيمان بها داخل المجتمعات الغربية نفسها.
وقبل صعود جيل جديد من الايديولوجيين في واشنطن، كان النظام الليبرالي القديم – ممثلًا بشخصيات مثل جو بايدن – قد سلّح وغطّى دولة الاحتلال في تنفيذ معظم عمليات القتل في غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان وسوريا.
ظهر فراغ السياسة الخارجية الأميركية جليًا في نسخة “ماغا” من منتدى الدوحة هذا الشهر، حين قال دونالد ترامب الابن إن الولايات المتحدة لا يمكنها الاستمرار في لعب دور “الأحمق الثري” الذي يُتوقع منه حل مشكلات العالم.
وفي السياق ذاته، دافعت هيلاري كلينتون عن تصريحات سابقة زعمت فيها أن الناس يتعرّضون لـ”دعاية محضة” و”مقاطع مفبركة” بشأن الحرب على غزة عبر “تيك توك”، مدّعية أن الشباب لا يفهمون السياق التاريخي للصراع.
أي سياق تقصده كلينتون؟ حصار غزة المستمر منذ 18 عامًا، والذي دعمته شخصيًا لأربع سنوات عندما كانت وزيرة للخارجية؟ أم ارتقاء 277 فلسطينيًا برصاص جيش الاحتلال خلال مسيرات سلمية؟ أم الاغتصاب المنهجي للمعتقلين الفلسطينيين في مراكز الاحتجاز؟
هكذا، فإن انهيار الهيمنة الأميركية في الشرق الأوسط هو إنجاز مشترك للحزبين، وقد جاء عام 2025 ليضع الختم الأخير على ربع قرن من الفشل.
قيادة جديدة… ولكن بثمن
ماذا بعد؟ للأسف، لم يحن وقت الوداع، فكل الملفات المفتوحة في الشرق الأوسط وأوكرانيا ستواصل مطاردة الغرب المنسحب، الحكومات الغربية لا تزال تروّج لـ”حل الدولتين” عبر تجاهل الواقع اليومي لما تفعله دولة الاحتلال في الضفة الغربية.
حتى لو تغيّر رئيس الوزراء وتباطأ الاستيطان، بات واضحًا منذ زمن أن الدولة الفلسطينية – المعترف بها من 157 دولة عضوًا في الأمم المتحدة – باتت غير قابلة للتحقق، وأصبح التلويح بوهم دولة فلسطينية تعيش إلى جانب دولة مصمَّمة لليهود فقط خداعًا أكبر مما كان عليه زمن اتفاقيات أوسلو.
في عام 2026، يجب أن تتجه الأنظار إلى الضفة الغربية، لا غزة فقط.
إن الفشل الأميركي بات يغذّي صعود اليمين المتطرف في الغرب، وربما الفاشية، ولا ينقصنا سوى انهيار مالي حقيقي لإعادة إنتاج ظروف ثلاثينيات القرن الماضي.
أما مشروع ضم الضفة الغربية الذي تنفذه دولة الاحتلال بات واضحًا للمسيحيين بقدر ما هو واضح للمسلمين، كما توثّق تقارير عن التهديد الوجودي الذي يواجهه مسيحيو بيت لحم.
سيزداد ضغط الشعوب على حكوماتها، وستحاول هذه الحكومات تجريم المطالب بالعدالة للفلسطينيين، لكن كلما ازداد القمع، تحوّلت فلسطين أكثر فأكثر إلى قضية حقوق مدنية داخلية في الغرب.
الخطيئة الحقيقية لحكومة كير ستارمر في بريطانيا ليست فقط الارتهان لواشنطن في ملف دولة الاحتلال، بل تأسيس بنية سلطوية سوف يستخدمها من يأتي بعده، مثل نايجل فاراج، بشكل أكثر شراسة.
وما فعلته مارغريت تاتشر عام 1981 حين رفضت منح المضربين الإيرلنديين صفة سياسية، وهو ما أدى إلى وفاة عشرة منهم، يُعاد إنتاجه اليوم في التعامل مع شبان مضربين عن الطعام بسبب دعمهم لفلسطين، وسيظهر في عام 2026 إلى أي مدى يمكن لهذا “النظام” أن يصمد إذا توفي أحد هؤلاء المضربين.
إذا كان عام 2025 هو العام الذي سقطت فيه ورقة التوت عن الطابع الإبادي الحقيقي لدولة الاحتلال، فإن السنوات الأولى من الربع القادم من هذا القرن ستشهد تصاعدًا في أعداد اليهود الأميركيين المطالبين بقيادة سياسية مختلفة كليًا.
إن أصحاب أيديولوجيا “إسرائيل أولًا” يخوضون معركة خاسرة، وهم يدركون ذلك.
لقد كان من المفترض أن يكون هذا قرن أميركا، لكن إن كان أول خمسةٍ وعشرين عامًا منه قد أثبتت شيئًا واحداً، فهو أن الولايات المتحدة كانت عاجزةً عاطفيًا وأخلاقيًا وفكريًا عن قيادة العالم.
ربما يكون الثمن فادحًا، لكن إن كان هذا الانهيار سيمهّد الطريق لقيادة جديدة أكثر تواضعًا وأخلاقية ومسؤولية، فقد يكون درسًا يستحق الانتظار… ولو بثمن باهظ.
للاطلاع على المقال الأصلي من (هنا)