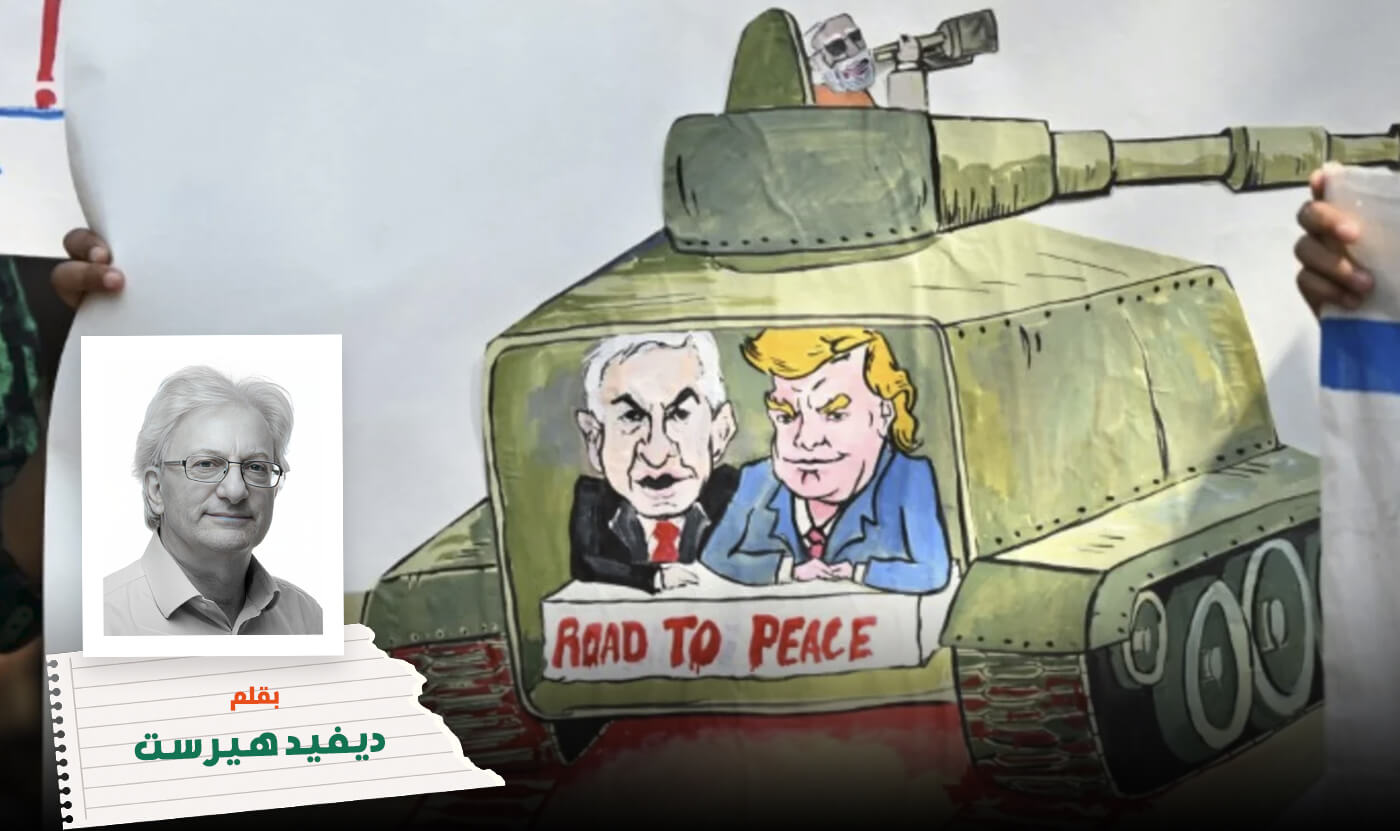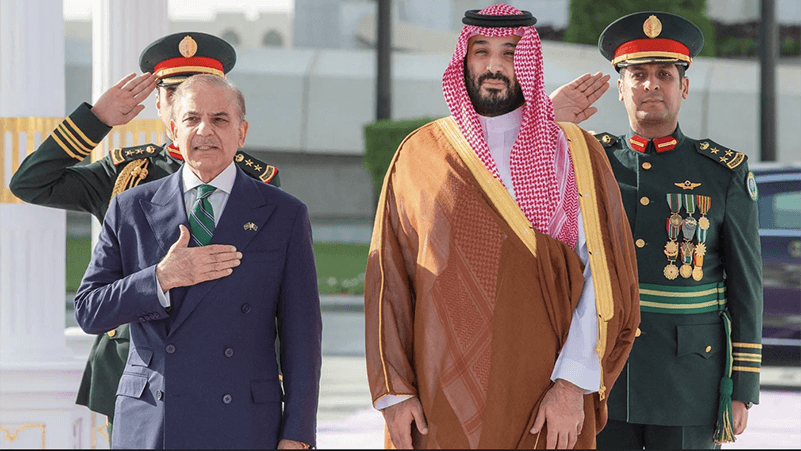بقلم تييري بريسيلون
ترجمة وتحرير نجاح خاطر
أثار مشروع القانون الذي قدمه أوغو بيرناليسيس، عضو حزب فرنسا الأبية اليساري (LFI) ، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، لإلغاء جريمة “تمجيد الإرهاب” من بنود قانون العقوبات، جدلاً واسعاً في البلاد التي تم فيها استخدام هذا البند على نطاق واسع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لتجريم التصريحات الداعمة للفلسطينيين.
فبشكل فوري، أثار موقف الحزب اليساري غضب منتقدي المشروع، وصرح وزير العدل ديدييه ميجود قائلاً: “يجب محاربته بأكبر قدر من القوة”، وغضب وزير الداخلية برونو ريتيلو قائلاً: “من الصعب القيام بأي شيء أكثر دناءة من ذلك”.
وحتى داخل صفوف الحزب الاشتراكي الحليف لحزب فرنسا الأبية، نددت المسؤولة الإقليمية المنتخبة كارول ديلجا بـ “الفشل الأخلاقي في مواجهة ضحايا الإرهاب وأسر الضحايا”، أما المعلقون الذين كانت مواقفهم أقل حدة، فاعتبروا مشروع القانون مبادرة مبررة، ولكنها منعزلة ومصممة بطريقة رديئة، وفي كل الأحوال لم يعتبر أي زعيم سياسي ولا حتى مقدمو المناظرات التلفزيونية أن من الضروري نقاش جوهر المشروع ومضامينه.
وعلق النائب مانويل بومبارد من حزب العمال الفرنسي قائلاً إنه “ذهل من تحول النقاش إلى ترامب” وإلى تناول “الجمود الفكري لطبقة الإعلام”.
على كل حال، لم يكن القصد من مشروع القانون إلغاء الجريمة الجنائية المتمثلة في الدفاع عن الإرهاب فحسب، بل إعادتها إلى قانون الصحافة، الذي استُمدت منه وأُدمجت بعد ذلك في قانون العقوبات بموجب التشريع الذي تم تبنيه في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2014.
كانت الحاجة الملحة في ذلك الوقت هي مواجهة الدعاية التي تروج لها المنظمات التي تدعي أنها جزء مما يسمى “الجهاد الدولي” في سياق إعلان الخلافة من قبل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سوريا والعراق في يونيو/حزيران 2014.
في ذلك الحين، كانت الدعاية التي تروج لها داعش تهدف إلى إغواء الشباب الأوروبيين من خلال تمجيد مقاتليها، بهدف تجنيدهم أو حشدهم لارتكاب هجمات في أوروبا، فأصبح قانون الصحافة غير مناسب على الإطلاق لمواجهة هذه الظاهرة.
أي أن الهدف من التغيير القانوني لعام 2014 تمثل في رفع القيود التي أبطأت التحقيقات، والسماح بالاحتجاز قبل المحاكمة والمثول الفوري أمام المحكمة، والسماح بمصادرة الأدلة، وتعبئة موارد مراقبة الإرهاب ومكافحته.
وفي ظل الأجواء المؤلمة، إن لم تكن الهستيرية، التي نتجت في فرنسا عن هجمات يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني 2015، وبتشجيع من الحكومة ازداد عدد التقارير عن التعليقات التي أُدلي بها على وسائل الإعلام الاجتماعية، أو في أماكن العمل أو حتى في المدارس والمعاهد من 1500 إلى 35 ألف تقرير في عام واحد.
تجريم التعليقات البسيطة
ولكن منذ الهجوم الذي قادته حماس على دولة الاحتلال في السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، شهد استخدام توصيف “تمجيد الإرهاب” زيادة جديدة.
ففي وقت مبكر من العاشر من أكتوبر/تشرين الأول، أصدر وزير العدل آنذاك إريك دوبون موريتي تعليماته للمدعين العامين بملاحقة “التصريحات العامة التي تشيد بهذه الهجمات، وتعتبرها مقاومة مشروعة للاحتلال، أو نشر رسائل عامة تحرض على تأييد حماس أو الجهاد الإسلامي بسبب هجماتهم.
وقد تم إطلاق مئات التحقيقات حول الأمر، فبحلول نهاية يناير/كانون الثاني 2024، أحصت صحيفة لوموند 626 تحقيقا من هذا القبيل تستهدف المواطنين العاديين، والمؤثرين، والطلاب، وأعضاء منظمات المجتمع المدني، ونشطاء النقابات، والصحفيين، والأكاديميين مثل فرانسوا بورغات، والقادة السياسيين، والمسؤولين المنتخبين المحليين، وحتى عضوين بارزين في حزب اليسار الفرنسي هما النائبة ماتيلد بانو وعضو البرلمان الأوروبي المستقبلية ريما حسن.
تم الحكم على أحد النشطاء بدفع مبلغ 3000 يورو (3120 دولاراً أميركياً) تعويضاً للمنظمات اليهودية التي رفعت دعوى مدنية ضده، وذلك لمقارنته بين عمل حماس “البطولي” وعمل “مقاومة”، كما أضيف اسمه إلى السجل الوطني لمرتكبي الجرائم الإرهابية، FIJAIT، لمدة 10 سنوات، وهو ما يتطلب منه الإبلاغ عن عنوان منزله كل ثلاثة أشهر وإخطار السلطات بأي سفر دولي قبل أسبوعين على الأقل.
ومن بين الحالات الأكثر رمزية قضية القائد النقابي جان بول ديليسكوت الذي حُكِم عليه في أبريل/نيسان بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ بسبب نشرة وزعتها منظمته وورد فيها أن “أهوال الاحتلال غير القانوني تراكمت”، حيث بات مجرد التذكير بالسياق التاريخي مبرراً للعقوبة، لأنه فشل في التعبير عن استنكار أخلاقي كافٍ، وفقاً لشروط الحكم.
أما من يحملون أسماء ذات صبغة عربية فأصبحوا يثيرون الشكوك بشكل خاص، وأولت الشرطة الكثير من الاهتمام لعلامات الممارسة الدينية، كما لو كانت مثل هذه الممارسات تشير إلى استعداد للإرهاب، مما أدى إلى تقزيم الاختلاف إلى صراع طائفي خالٍ من أي عقلانية سياسية.
تجاهل التحذيرات
لقد تجاهل منتقدو التشريع الذي اقترحته فرنسا الأبية عمدًا سنوات من التحذيرات الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان المختلفة بشأن قانون اعتذار فرنسا عن الإرهاب.
ففي عام 2017، أعرب أمين المظالم جاك توبون عن قلقه العميق إزاء “الغموض الذي يتعارض مع حرية التعبير والمعلومات” وحذر من “استهداف قطاع بعينه من السكان” أي المسلمين.
وفي تقرير صدر في مايو/أيار 2019، سلط المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية أثناء مكافحة الإرهاب الضوء على “الآثار الجسيمة لجريمة تمجيد الإرهاب على الحق في حرية التعبير”.
وورد في التقرير: “إن القانون صيغ بعمومية واسعة، مما يثير حالة من عدم اليقين القانوني الكبير، ويسمح بتجاوز السلطة التقديرية ويؤثر على حماية حرية التعبير والتبادل المفتوح للأفكار في ظل ديمقراطية قوية”.
وفي شهر إبريل/نيسان الماضي، أوضحت اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان لوزير العدل أن منشورها “ربما أحدث ارتباكاً بين الموافقة على جريمة أو مجرمين، والثناء عليهم، والمواقف المتعلقة بالسياق الذي ارتكبوا فيه أعمالهم، والمواقف الأخيرة تشكل جزءاً من مناقشة الأفكار، وبالتالي ينبغي أن تتمتع بحرية التعبير”.
وحتى القاضي السابق لمكافحة الإرهاب، مارك تريفيديك، الذي أوصى بإدراج الاعتذار عن جريمة الإرهاب في قانون العقوبات في ذلك الوقت، ندد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي “بالاستخدام المنحرف تماماً للقانون”، وكتب قائلاً: “إن مجرد وضع علامة دعم لفلسطين يجعلك تخاطر بالسجن”، داعياً إلى “التراجع”.
القضاة كحراس للعقيدة
وفي مثل هذه الأجواء، فإن فرصة إدراج مشروع قانون حرية الفكر على جدول أعمال البرلمان تصبح ضئيلة، ومن ناحية أخرى، فإن الغضب غير العقلاني الذي أثارته هذه القضية يقول الكثير عن تطور النقاش العام في فرنسا.
لقد ابتعدنا اليوم كثيراً عن الوقت الذي كان فيه جان بول سارتر قادراً على القول، في اليوم التالي لاختطاف الرياضيين الإسرائيليين في دورة الألعاب الأوليمبية في ميونيخ عام 1972 على يد منظمة أيلول الأسود، إن “الفلسطينيين ليس لديهم خيار آخر بسبب افتقارهم إلى الأسلحة والمدافعين سوى اللجوء إلى الإرهاب”.
وعلى الرغم من أن تصريح الفيلسوف سارتر لم يكن توافقياً، إلا أن صداه يتردد في الذاكرة التاريخية الحية لنضالات التحرير الوطني.
وقد يتصور المرء أنه لو كان رئيسان سابقان، شارل ديغول وجورج بومبيدو، على قيد الحياة في عصرنا، لكان من الممكن أن يكونا هدفاً للإدانة بسبب تمجيدهما للإرهاب، ففي نوفمبر/تشرين الثاني 1967، أعلن شارل ديغول: “إن إسرائيل تقيم في الأراضي التي احتلتها احتلالاً من شأنه أن ينطوي حتماً على القمع والقهر والطرد، وتتشكل مقاومة لهذا الاحتلال، وهو ما تصنفه إسرائيل بدورها على أنه إرهاب”، وبعد أحداث ميونيخ، قال بومبيدو: “لن نقضي على الإرهاب الفلسطيني إذا لم يكن لدينا نوع من الحل للمشكلة الفلسطينية”.
ومنذ الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001، عملت خطابات “الحرب على الإرهاب” الأميركية على عولمة تعريف الإرهاب باعتباره الشر المطلق، المجرد من أي سياق تاريخي، والذي يتحمل المسؤولية عنه مرتكبه فقط.
لقد سمحت الهجمات التي شنها تنظيم الدولة الإسلامية على الأراضي الأوروبية لقادة الاحتلال بترويج روايتهم للإرهاب باعتباره تهديداً عالمياً ضد الغرب وأيديولوجية يحملها الإسلام السياسي أو حتى المسلمون ككل، لذلك، فإن أي محاولة لتفسير أسبابه بشكل عقلاني تعتبر وسيلة مستهجنة لتبريره، وفي مواجهة هذا الخطر الحيوي، يُنظَر إلى استخدام العنف اللامحدود فقط باعتباره استجابة مشروعة.
لقد دمجت الغالبية العظمى من النخب السياسية والإعلامية والفكرية الفرنسية الرواية الإسرائيلية في العقيدة الجمهورية، فأصبح أولئك الذين يحيدون عن هذا المبدأ يعاملون باعتبارهم زنادقة، إن لم يكونوا “أعداء داخليين”، ويطلق عليهم إما “إسلاميون معادون للسامية” أو “متعاونون”، وهو مصطلح يحمل أهمية تاريخية في فرنسا، حيث استُخدِم لوصف حلفاء النازية أثناء الاحتلال من عام 1940 إلى عام 1944
وعلى النقيض من وصفهم التقليدي “كحراس للحريات”، أصبح القضاة في النهاية حراساً لهذه العقيدة، وبعكس مقولة كلاوزفيتز، التي تقول إن الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل أخرى، فإن القانون، أو بالأحرى الاستخدام السياسي للقانون، أصبح في فرنسا إطالة للحرب في عالم الرأي العام.
إن ذات هذا الاتجاه فاعل في ألمانيا والولايات المتحدة، فالحرب التي تشنها دولة الاحتلال تعمل على تسريع الانجراف الاستبدادي وكراهية الأجانب في الدول التي تدعمها.
للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)