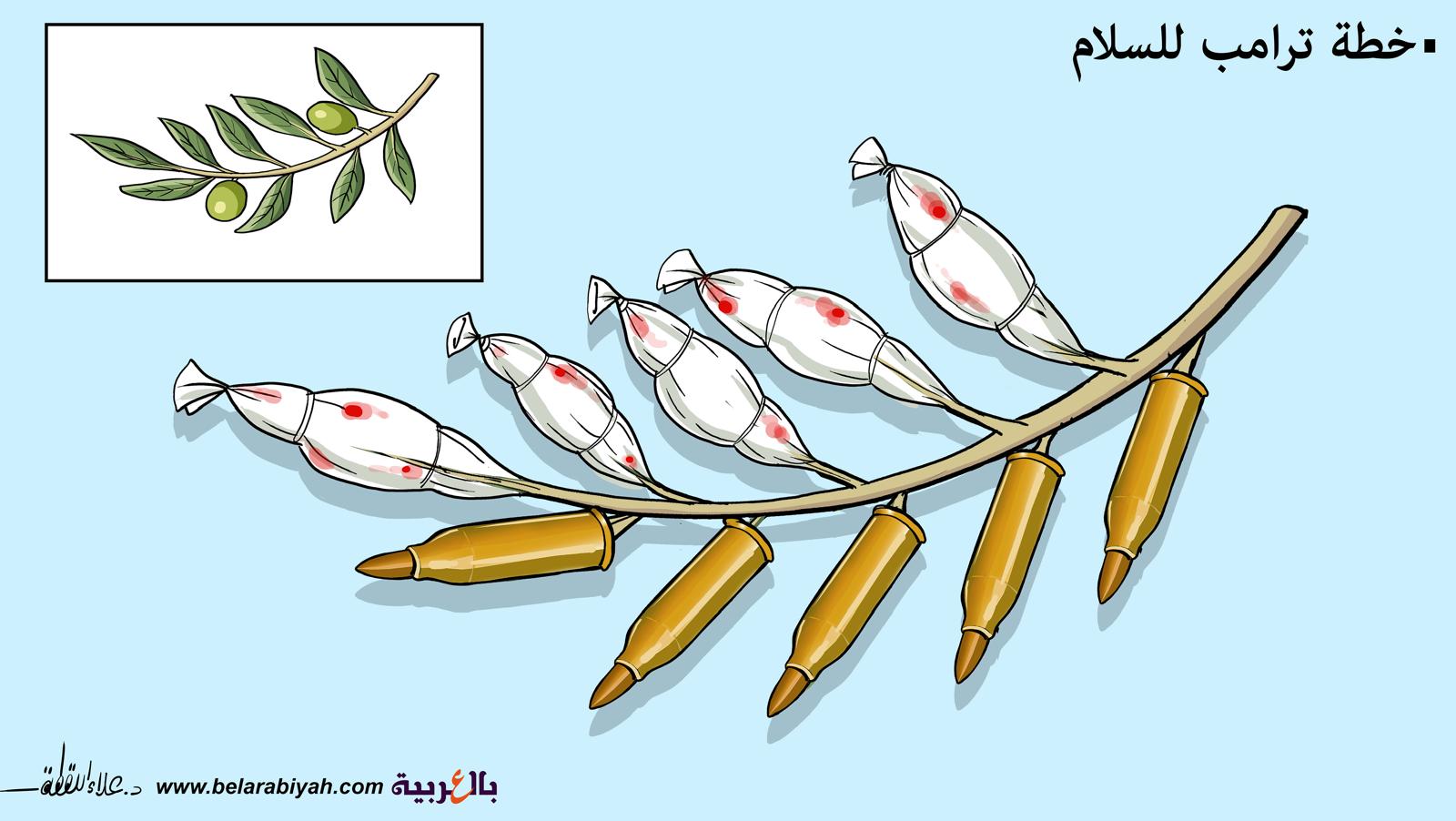بقلم ماركو كارنيلوس
ترجمة وتحرير نجاح خاطر
مع بزوغ العام الجديد، لفظ ما يُسمّى “النظام الدولي القائم على القواعد” أنفاسه الأخيرة.
فبعد ترديه لفترة طويلة، جاءت نهاية هذا النظام مع التدخل الأميركي في فنزويلا واختطاف الرئيس نيكولاس مادورو، ومع الصمت الأوروبي المريب من دول تُصنَّف على أنها “حليفة” لواشنطن.
فباستثناءات محدودة، سارع هؤلاء إلى البحث عن تبريرات واهية لهذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي، دون أن يفلحوا في إخفاء حقيقته.
ظل مفهوم “النظام القائم على القواعد” تعبيرًا مريحًا صاغته دوائر سياسية غربية ليحلّ محلّ مفهوم أكثر إلزامًا وصرامة هو “احترام القانون الدولي”، فـ “لقاعدة”!بطبيعتها أضعف من “القانون” وأكثر قابلية للتأويل والتجاوز.
وتكمن السمة الأساسية لهذا المفهوم في أن قواعده وهي في الأصل فضفاضة وغير محددة بدقة تُفرض على جميع دول العالم، باستثناء الديمقراطيات الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.
وقد قدّم العقد الأخير من القرن العشرين، والعقدان الأولان من القرن الحادي والعشرين، أدلة دامغة على هذه الازدواجية الصارخة في المعايير.
تتمثل أوضح تجليات هذه الازدواجية في الطريقة التي جرى بها التعامل مع روسيا من جهة، ودولة الاحتلال من جهة أخرى خلال السنوات الأخيرة.
وفي الحالة الفنزويلية، يمكن الجزم بأننا لن نسمع من الساسة ووسائل الإعلام الغربية الكليشة المألوفة حول “التمييز بين المعتدي والمعتدى عليه”، كما يحدث في حالة أوكرانيا.
لقد تجاوز القرن الحادي والعشرون ربعه الأول، وهو مثقل باضطراب عالمي متصاعد وشامل، وبات النظام الدولي يبدو وكأنه يعود القهقرى إلى نمط القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين.
في ذلك الوقت، كانت السياسة الخارجية إمبريالية في جوهرها، استعمارية في أدواتها، ومتمحورة حول سباق القوى الأوروبية للسيطرة على الموارد الطبيعية في أفريقيا وآسيا.
واليوم، تضع الولايات المتحدة أعينها على الموارد الطبيعية الفنزويلية، وغدًا قد تتجه إلى موارد كندا والمكسيك والدنمارك، والأخيرة عبر بوابة غرينلاند.
عقيدة “دونرو”
يصف المؤرخون القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين بعصر “دبلوماسية الزوارق الحربية”، حيث كانت القوة العسكرية الأداة المفضلة لحسم النزاعات الدولية، وكانت كل قوة كبرى تعمل على بناء مجال نفوذها الخاص.
وبعبارة أخرى، فإن العلاقات الدولية اليوم تتراجع قرنين إلى الوراء.
وقد قنّنت الولايات المتحدة هذا “الطبيعي الجديد” في سياستها الخارجية عبر أحدث نسخة من استراتيجيتها للأمن القومي، التي تؤكد من جديد هيمنتها الحصرية على نصف الكرة الغربي.
وما كان يُعرف بعقيدة مونرو، التي أُعلنت عام 1823 في عهد الرئيس الأميركي الخامس، بات يُعاد تسميتها اليوم باسم “عقيدة دونرو” في إشارة مباشرة إلى الرئيس الحالي دونالد ترامب.
وهكذا يشهد القرن الحادي والعشرون واحدة من أكثر اللحظات تحوّلًا في النظام الدولي منذ نحو مئة عام.
ووفقًا لهذه العقيدة، لم تتعرض فنزويلا لهجوم واختُطف رئيسها فحسب، بل باتت إدارة ترامب تعلن صراحة أن السلطات الانتقالية في البلاد مطالبة باتباع التعليمات الأميركية، بما يسمح بالسيطرة الحصرية للشركات الأميركية على الاحتياطات النفطية الهائلة الكامنة تحت الأرض الفنزويلية.
وبالنظر إلى الذريعة الرسمية التي استُخدمت لتبرير الهجوم على فنزويلا، والمقصود تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة بوصفه “تهديدًا وجوديًا”، فإن المنطق يقتضي أن تكون كولومبيا والمكسيك في صدارة الدول المستهدفة لاحقًا.
إذ تأتي من هاتين الدولتين كميات من المخدرات أكبر بكثير مما يأتي من فنزويلا، فضلًا عن أن المكسيك تُعد مصدرًا رئيسيًا لتدفقات الهجرة.
لكن، وكما هو متوقع، لم تُبدِ هذه الإدارة ولا سابقاتها أي اهتمام بالسؤال الوجودي الحقيقي وهو لماذا تحوّل ملايين الأميركيين إلى تعاطي المخدرات أصلًا؟
أما كوبا فلا تزال بدورها على “قائمة التهديدات” وستظل الولايات المتحدة تجد المبررات لسحق هذا البلد الصغير.
وعلى المدى المتوسط إلى الطويل، قد تُضاف البرازيل إلى القائمة أيضًا، ما دامت تُحكم من قبل الرئيس لولا دا سيلفا أو قوى يسارية مناهضة للإمبريالية.
أما الأرجنتين، فقد جرى “تطبيعها” ووُضعت على صراط مالي أميركي محكم، بمباركة رئيسها خافيير ميلي.
“الناتو” تحت التهديد
وفي الشمال، تبدو الصورة أكثر تعقيدًا، مع تداعيات محتملة أشد خطورة.
فشهية إدارة ترامب التوسعية تمتد إلى كندا وغرينلاند، الأخيرة الواقعة تحت سيادة حليف آخر في حلف الناتو هو الدنمارك.
وبخصوص كندا فإنها تُعد المورّد الأكبر للنفط الثقيل إلى الولايات المتحدة، بينما تحولت غرينلاند فجأة إلى مصلحة أمنية “حاسمة”، مع ادعاءات لا تستند إلى دليل من الرئيس دونالد ترامب بأن الجزيرة محاطة بسفن صينية وروسية.
وبالاستناد إلى منطق مشابه لادعاءات تهريب المخدرات الفنزويلية، قد يصرّ قريبًا على أن المادة البيضاء التي تغطي غرينلاند ليست ثلجًا، بل كوكايين.
إن أي تحرك أميركي ضد حلفاء مثل كندا والدنمارك مهما بدا ذلك عبثيًا سيعني عمليًا نهاية حلف شمال الأطلسي.
ومع أن الولايات المتحدة ترى لنفسها حقًا حصريًا في فرض مجال نفوذها في نصف الكرة الغربي، إلا أنها ترفض الاعتراف بالحق ذاته لقوى كبرى أخرى، مثل الصين في شرق آسيا أو روسيا في أوروبا الشرقية، وهذا بحد ذاته ازدواجية معايير بأقصى درجاتها.
وعموماً فإن الأسابيع والأشهر المقبلة قد تكشف ما إذا كانت روسيا ستحصل على اعتراف فعلي بمجال نفوذها في أوروبا الشرقية، وتحديدًا في أوكرانيا، عبر مفاوضات تجريها واشنطن مع موسكو وكييف، بينما تُترك الدول الأوروبية الأخرى على الهامش.
أما ما إذا كانت الصين ستحظى بترتيب مماثل فيما يتعلق بتايوان، فلا يزال أمرًا غير محسوم.
في الوقت الراهن، خففت إدارة ترامب من لهجتها العدائية تجاه بكين، بل أقرت في استراتيجيتها للأمن القومي بأن الصين باتت “ندًا شبه مكافئ” اقتصاديًا لها.
أجراس إنذار
في مناطق أخرى، تتشكل مجالات نفوذ أصغر حجمًا، لكنها لا تقل أهمية.
وتبرز دولة الاحتلال بوصفها المثال الأوضح، إذ تستخدم القوة ضد سوريا ولبنان، وتوظف علاقاتها في الخليج والبحر الأحمر تحت لافتة توسيع “اتفاقيات أبراهام”.
كما دخلت تل أبيب في شراكة مصلحية متنامية مع الإمارات، ووسّعت انفتاحها على أذربيجان، لمراقبة إيران عن كثب بشكل أساسي.
في المقابل، قد تتحول تركيا قريبًا إلى المنافس الأبرز لدولة الاحتلال، عبر تنسيق وثيق مع قطر ودعم مالي قطري.
وبالفعل فإن أنقرة نشطة في ليبيا وسوريا والعراق، ولا تُخفي طموحها للعب دور في غزة ولبنان، وهو طموح يبدو منطقيًا في ضوء نفوذها القوي في سوريا.
كل ذلك قد يدق أجراس الإنذار في القصر الملكي السعودي، الذي استعرض مؤخرًا عضلاته عبر تحرك حاسم في اليمن ضد منافسه الخليجي، الإمارات.
كما أعلنت الرياض عن تنسيق متزايد مع القوة النووية الثالثة في غرب آسيا، إلى جانب الهند ودولة الاحتلال ألا وهي باكستان.
أما إيران، التي تواجه من جديد اضطرابات داخلية، فسيكون من حسن حظها إن استطاعت الحفاظ على ما تبقى من ركائز “محور المقاومة” الذي كان يمتد عبر العراق واليمن وحزب الله المنهك، في حين خرجت سوريا مؤقتًا من الحسابات.
ومرة أخرى، يجد الأوروبيون أنفسهم مُهمَّشين في “اللعبة الكبرى” العالمية الجديدة المتمحورة حول الموارد الطبيعية.
ففرنسا تخسر نفوذها تباعًا في أفريقيا، بينما أثبت مشروع “بريطانيا العالمية” بعد “بريكست” أنه فشل ذريع.
إن القرن الحادي والعشرين يشهد بالفعل أكثر لحظات النظام الدولي تحوّلًا منذ قرابة مئة عام.
فها نحن ندخل مياهًا بحراً حيث يُعاد إحياء مفهوم مجالات النفوذ، بوصفه إرثًا من الحرب الباردة، لكن بملامح معاصرة.
إنه سباق عالمي جديد على الموارد الطبيعية يتكشف، متخفّيًا وراء ستار مجالات نفوذ جديدة أو مُعاد تأكيدها، وهذا المناخ لا يبشّر بنظام دولي مستقر، بل ينذر بتوترات جديدة واضطراب عالمي واسع.
وإذا كان هذا هو “الوضع الطبيعي الجديد” فقد تصبح الحاجة ملحّة لعقد مؤتمر يالطا عالمي حديث.
والتحدي الحقيقي لن يكون في القضايا المطروحة، بل في تحديد من سيجلس إلى الطاولة ومن سيكون على القائمة.
وبالنظر إلى طبيعة القيادات الحالية في القارة العجوز، لا يساور الشك في أن أوروبا ستكون على الطاولة لا حولها.
للاطلاع على المقال الأصلي من (هنا)