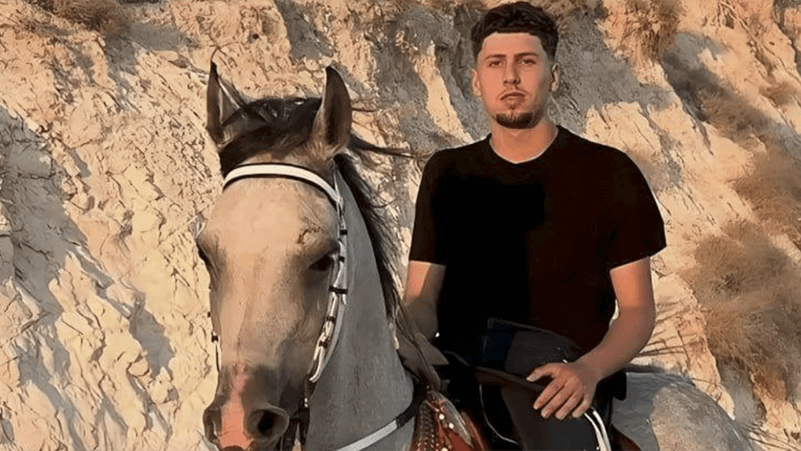بقلم إميل بادارين
ترجمة وتحرير مريم الحمد
يمكن وصف ما تبنته حكومات غربية في سبتمبر الماضي، العديد منها متواطئ مع الاحتلال الإسرائيلي أصلاً، ببادرة جوفاء للاعتراف بدولة فلسطينية مفترضة، بعد قرابة عامين من استمرار الإبادة الجماعية في غزة.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يعاني فيه الشعب الفلسطيني من التدمير الاستيطاني الممنهج وسرقة الأراضي يومياً والتهديد بالإبادة!
علاوة على ذلك، يتم تقديم الجهود المرحلية الرامية إلى “إحياء” حل الدولتين الزائف من أجل إنشاء “مسار” من خلال “خطوات عاجلة وملموسة لا رجعة فيها” نحو الاعتراف بالدولة الافتراضية، على أنها أكثر إلحاحاً من وقف جرائم الحرب والمجاعة والإبادة الجماعية!
يجرد هذا الشكل من الاعتراف الفلسطينيين من حقهم القانوني والأخلاقي في مقاومة القهر الأجنبي بما في ذلك من خلال الكفاح المسلح بموجب القانون الدولي، كما أنه يمنع قدرة الفلسطينيين على بناء قدرات الدفاع عن النفس وممارسة السيادة
الحقيقة أن أي اعتراف أو تحركات دبلوماسية دون حماية ملموسة للأساسين اللذين لا غنى عنهما لقيام الدولة، أي شعبها وأراضيها، ليست فقط عديمة الجدوى ولكنها خداع محسوب يوفر غطاءً للتدمير المستمر لـ 2.2 مليون شخص أمام أعيننا.
مع فشل الحكومات في وقف هذه الجرائم، يتم تنشيط إطار “السلام” وحل الدولتين مرة أخرى، مما يسمح للعالم بالنظر في الاتجاه الآخر بعيداً عن جرائم الإبادة الجماعية.
في العام الماضي، قادت أيرلندا والنرويج وإسبانيا الجهود الدبلوماسية، ووافقت بشكل مشترك على الاعتراف الرسمي بفلسطين في مايو عام 2024 وحثت الآخرين على أن يحذوا حذوها.
وبعد مرور عام، في يوليو عام 2025، ترأست السعودية وفرنسا أول مؤتمر دولي رفيع المستوى لهما في الأمم المتحدة، كجزء من نفس الجهد لإحياء “عملية السلام” التي توقفت منذ فترة طويلة، حيث أدى المؤتمر إلى اعتماد “إعلان نيويورك” حول حل الدولتين، والذي أقرته الجمعية العامة بأغلبية 142 صوتاً في 23 سبتمبر الماضي.
لقد جاء صياغة الإعلان مؤكدة على الاعتراف بالدولة والعضوية الكاملة في الأمم المتحدة باعتبارهما “ضروريين ولا غنى عنهما” لتحقيق حل الدولتين وإنهاء الصراع ودمج وتطبيع إسرائيل في المنطقة، ولكن لم يتم طرح أي سياسات ملموسة أو خطط قابلة للتنفيذ.
في الواقع، سرعان ما طغت على المشهد برمته ما سميت بـ “خطة السلام المكونة من 20 نقطة”، والتي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأشادت بها حتى الدول التي اعترفت للتو بفلسطين رغم أنها فعلياً أبطلت الاعتراف أو أي احتمال لقيام دولة فلسطينية!
قد تبدو سياسات الاعتراف جذابة، إلا أن أبعادها الخفية محفوفة بالمخاطر، وكما ذكرت في كتابي الأخير: “سياسة الاعتراف في الدول المستعمرة الاستيطانية”، فإن الاعتراف في ظل الظروف الاستعمارية هو وسيلة للإلغاء، بحيث يصبح غطاءً معيارياً يتم من خلاله استمالة الشعوب الأصلية وإضعافها ومحوها”.
إنكار وجود المقاومة
ويظل الهدف، سواء كان ذلك من خلال الاعتراف أو خطة ترامب أو مقترحات السلام الأوروبية والأمريكية السابقة، تقويض حق الفلسطينيين القانوني في المقاومة وحرمانهم من تقرير المصير الحقيقي.
ويتوقع الأطراف ضمن هذا الإطار أن يتخلى الفلسطينيون عن المقاومة والنضال من أجل التحرير والعدالة حتى قبل تحقيق تقرير المصير وإقامة الدولة.
وقد أوضحت الحكومة النرويجية ذلك في عام 2024، قبل فترة طويلة من خطة ترامب المكونة من 20 نقطة، معلنة بأن “تسريح” المقاومة الفلسطينية هو أمر أساسي لاعترافها بفلسطين وجزء من عملية لا رجعة فيها نحو إنشاء دولة فلسطينية”، وهذا لسان حال الدول الأخرى التي اعترفت مؤخراً بفلسطين.
في هذا السياق، يجب على الفلسطينيين أن يظلوا مسلوبي القدرة على المقاومة بنزع السلاح وأن يحافظوا على روابط أمنية واقتصادية خاضعة مع إسرائيل لدعم التفوق اليهودي!
وعليه، يجرد هذا الشكل من الاعتراف الفلسطينيين من حقهم القانوني والأخلاقي في مقاومة القهر الأجنبي بما في ذلك من خلال الكفاح المسلح بموجب القانون الدولي، كما أنه يمنع قدرة الفلسطينيين على بناء قدرات الدفاع عن النفس وممارسة السيادة.
ويؤكد إعلان الأمم المتحدة حول منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة أن تقرير المصير يضمن حق الشعوب في “أن تحدد بحرية وضعها السياسي وأن تسعى بحرية إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”، ولكن في ظل إطار الاعتراف الحالي، فقد تحول حق تقرير المصير فعلياً إلى اعترافات رمزية.
ديمقراطية جوفاء
رغم إعلان الدول الغربية دعمها لحق تقرير المصير للفلسطينيين، إلا أنها في الوقت نفسه تنصب نفسها حكماً في كيفية حكم الفلسطينيين ومن الذي يجب أن يحكمهم، حيث يتم تصوير الاعتراف على أنه خطوة حاسمة نحو إقامة دولة فلسطينية “ديمقراطية”، ولكن الحقيقة هي أن الأنظمة السياسية والاجتماعية والتعليمية والاقتصادية مقيدة بإحكام بشروط مفروضة من الخارج، وتخضع للمساءلة أمام القوى الأجنبية وأصحاب المصلحة.
إن هذه الديمقراطية المفترضة، التي يتولى تنسيقها زعماء عرب وأوروبيون مستبدون، مبنية على نحو يحدد سلفاً نتائج الانتخابات الفلسطينية “الديمقراطية والشفافة” المفترضة، ومن شأن هذا النظام المؤسسي أن يرسخ الإقصاء وحرمان شرائح كبيرة من الشعب الفلسطيني الذين يعارضون الهيمنة الاستعمارية ويزيد من إضعاف مجتمعهم وتفتيته.
هناك عملية قياس مستمرة للعبارات والألفاظ والسياقات للسماح باستمرار الإبادة الجماعية مع التهرب من المسؤولية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، ولذلك فإن الاعتراف الدبلوماسي ومؤتمرات السلام والاحتجاج بحل الدولتين هي إشارات جوفاء لا تؤدي إلا إلى تشتيت الانتباه
لقد واجه التعليم أيضاً تدخلات خارجية مدمرة بحجة “تحديث المناهج الدراسية” أو “مكافحة التطرف والتحريض والتجريد من الإنسانية والتطرف العنيف والتمييز وخطاب الكراهية”.
وتذهب هذه الجهود إلى ما هو أبعد من الكتب المدرسية، حيث تعمل كأدوات لقمع الرواية الفلسطينية ومحو الحقائق التاريخية حول تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم على أيدي الحركة الصهيونية من ذاكرة الأجيال القادمة.
على الصعيد الاقتصادي، سوف تظل الدولة الفلسطينية المفترضة معتمدة هيكلياً على إسرائيل من خلال الأشكال “المنقحة” لنفس أطر الاستعمار الاستيطاني، ولا سيما بروتوكول باريس لعام 1994 حول العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
سياسات المحو
بعيداً عن الاعتراف بدولة افتراضية يتعرض شعبها للتدمير ويواجه استمرار سرقة الأراضي وضمها، فإن الفلسطينيين وقياداتهم “الرسمية” لم يكتسبوا أي شيء لحماية سكانهم أو أراضيهم حتى بعد استسلام السلطة الفلسطينية الكامل للإطار الغربي للاعتراف بها.
ورغم إحاطة الاعتراف بلغة تقدمية متمثلة في تقرير المصير والسيادة والديمقراطية، إلا أن هذه المُثُل فارغة من الجوهر، فالسيادة الحقيقية تتطلب الحق والقدرة على الدفاع عن النفس، في حين أن تقرير المصير الحقيقي يتطلب حرية الفرد في تشكيل الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
إن إنكار حق الفلسطينيين في تقرير المصير جزء لا يتجزأ من جميع مبادرات السلام الغربية، والذي يتجلى في محاولات إخضاع الشعب الفلسطيني إما للوصاية الأجنبية المباشرة من خلال ما يسمى “مجلس السلام” برئاسة ترامب ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، أو بشكل غير مباشر من خلال الشروط التي تفرضها الدول الغربية مقابل الاعتراف بها.
وبهذا المعنى، يشكل الاعتراف قيداً معيقاً، فبدلاً من تحميل إسرائيل مسؤولية الإبادة الجماعية، يتم مكافأتها بالتطبيع الإقليمي بينما يحرم الفلسطينيين من حقهم في مقاومة النظام الاستعماري الاستيطاني والسعي إلى الحرية!
لقد اعترفت 157 دولة بفلسطين حتى اليوم، ولكن ذلك الاعتراف الخارجي الإضافي لا يمكن أن يؤدي إلى إنشاء دولة، وهنا أستحضر قول وزير خارجية السويد السابق توبياس بيلستروم حين وصف اعتراف بلاده في عام 2014 بأنه “رمزي” ولا يحدث “أي فرق” على الإطلاق، مضيفاً أنه كان ليسحبه لو لم يخدم الحفاظ على سلامة السياسة الخارجية السويدية.
إن سياسة الاعتراف هذه منفصلة عن الواقع، وهي الحقيقة التي تتجلى بوضوح في رفضها الاعتراف بالإبادة الجماعية في غزة على حقيقتها، وبدلاً من ذلك تعيد تأطيرها باعتبارها مجرد “حرب” أو “صراع” أو “وضع مروع”، كما وصفه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.
هناك عملية قياس مستمرة للعبارات والألفاظ والسياقات للسماح باستمرار الإبادة الجماعية مع التهرب من المسؤولية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، ولذلك فإن الاعتراف الدبلوماسي ومؤتمرات السلام والاحتجاج بحل الدولتين هي إشارات جوفاء لا تؤدي إلا إلى تشتيت الانتباه.
إن المهمة الملحة ليست الاعتراف الرمزي، بل محاسبة إسرائيل وإنهاء مشروعها الاستعماري الاستيطاني وتأمين العدالة والتعويضات للضحايا.
للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)