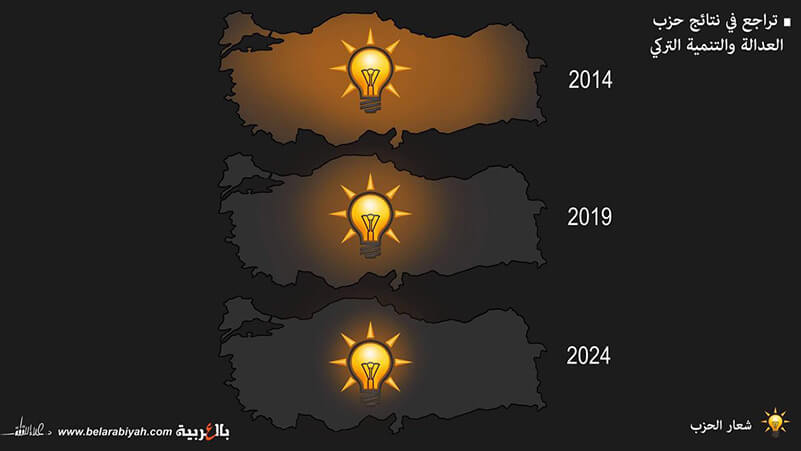بقلم أسامة أبو زيد
ترجمة وتحرير نجاح خاطر
تشهد العواصمُ الغربية تحرّكات مكثفة حيال السودان، شملت اجتماع دبلوماسيين في واشنطن لحشد تمويل إنساني عاجل، وإعلان لندن في التوقيت ذاته حزمة عقوبات جديدة تقول إنها تستهدف تفكيك “آلة الحرب”.
غير أن هذا النشاط السياسي المتسارع يكشف مفارقة صارخة تتمثل في تنامي الزخم الدبلوماسي في البيانات والمؤتمرات، بينما تظل حماية المدنيين وإعادة إعمار ما دمرته الحرب غائبتين فعلياً على الأرض.
إذ يعود ملايين السودانيين اليوم إلى مدن مدمّرة، بلا كهرباء، ولا مستشفيات، ولا خدمات عامة فاعلة، في وقت يبدو فيه العالم أكثر براعة في معاقبة المتحاربين، لكنه لا يزال عاجزاً عن حماية الناجين وصون الحد الأدنى من شروط الحياة.
وبعدَ ما يقارب ثلاثة أعوام على اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، تتجه السياسات الدولية نحو خلط الإشارات الأخلاقية مع الاستراتيجية التشغيلية، فتعكس العقوبات الجديدة وتعهدات المانحين انخراطاً سياسياً واضحاً، غير أن الكارثة الإنسانية تتفاقم، كاشفة فجوة آخذة في الاتساع بين النشاط الدبلوماسي وواقع المدنيين.
وتستهدفُ العقوبات التي أعلنتها المملكة المتحدة أفراداً يُتهمون بتغذية اقتصاد الحرب وتمكين العمليات العسكرية، ويقدّمها المسؤولون البريطانيون باعتبارها محاولة لإضعاف البنى المالية التي تستند إليها دوائر العنف والإفلات من العقاب.
وفي السياق ذاته، أطلقت الولايات المتحدة فعالية “الدعوة إلى التحرك لصندوق السودان الإنساني” في واشنطن، ساعيةً إلى تعبئة تعهدات المانحين، وتنسيق جهود الوكالات الدولية، وتعزيز آليات الاستجابة الإنسانية للأزمة المتصاعدة.
وهكذا، تجسّد هاتان الخطوتان المسارين اللذين يسما الاستجابة الدولية وهما توسيع دائرة العقاب من جهة، وزيادة التعهدات الإنسانية من جهة أخرى، غير أن أياً منهما، بصيغته الحالية، لا يسدّ الفراغ الجوهري المتمثل في غياب إطار متماسك وقابل للتنفيذ لحماية المدنيين، وضمان عودتهم الآمنة، وإعادة تأهيل البنية التحتية.
وتكشفُ بياناتُ المنظمة الدولية للهجرة أن السودان يعيش أكبر أزمة نزوح في العالم، بعدما اضطر ملايين الأشخاص إلى الفرار منذ اندلاع الحرب، ومع ذلك، تشير بيانات التتبع إلى عودة أكثر من ثلاثة ملايين سوداني إلى ولايات منها الخرطوم والجزيرة وأجزاء من دارفور، ليس لأن الأمن تحسن، بل لأن النزوح بات غير قابل للاستدامة اقتصادياً واجتماعياً.
وعندما يدخلُ العائدون إلى أحيائهم، فإنهم يجدون أنفسهم أمام منظومات منهارة بالكامل، إذ تقدّر اليونيسف أن أكثر من 70% من المرافق الصحية خارج الخدمة، فيما يبقى ملايين الأطفال خارج المدارس، وقد دُمّرت أو نُهبت بنى المياه الحيوية.
وفي الخرطوم، التي كانت يوماً المركز الإداري والاقتصادي للبلاد، تضررت شبكات الكهرباء والجامعات والمستشفيات وأنظمة المياه بشدة، فيما تعمل الأسواق بشكل متقطع، وتعاني الإدارة العامة من التشتت، ويبقى الأمن المحلي هشاً ومتقلباً.
وعليه فإن العودة من دون إعادة إعمار لا تمثل تعافياً حقيقياً، بل تُعيد إنتاج دورة نزوح متكررة، تغادر العائلات ثم تعود بدافع اليأس، قبل أن تضطر إلى النزوح مجدداً حين تتكشف استحالة العيش.
وفي هذا الإطار، تعزز العقوبات البريطانية الجديدة نمطاً مألوفاً يتمثل في توسيع آليات المساءلة عبر تصنيفات أوروبية وبريطانية وأميركية تطال قادة وشبكات مالية ومتهمين بارتكاب فظائع.
ومع أن تسمية الجناة وتقييد حركتهم المالية خطوة مهمة، إلا أن العقوبات وحدها لا تعيد بناء شبكات المياه، ولا تفتح المستشفيات، ولا تؤمّن الأحياء.
كما يعملُ الفاعلون المسلحون في السودان عبر شبكات رعاية إقليمية، ومسارات تجارة غير مشروعة، وأسواق ذهب، وقنوات مالية بديلة، ما يحدّ من فاعلية الضغط المرتبط بالنظام المصرفي الغربي.
وبينما قد تسهم العقوبات على المدى البعيد في العزل والمساءلة، تبقى قدرتها على المدى القصير على تغيير سلوك المعارك أو حماية المدنيين محدودة.
وعليه، ما لم تُربط العقوبات بآليات تنفيذ واضحة تشمل الالتزام بوقف إطلاق النار، وضمانات الوصول الإنساني، وأنظمة مراقبة مدنية، فإنها تخاطر بالتحول إلى أدوات رمزية، تعلن الإدانة لكنها لا تغيّر البيئة التي يُجبر المدنيون على العيش فيها.
وفي المقابل، تعكس المبادرة الإنسانية في واشنطن إدراكاً بأن التمويل الإغاثي يجب أن يتوسع بصورة عاجلة، ويمكن للتنسيق الفعّال بين المانحين أن يدعم استعادة الخدمات الأساسية، وإعادة تأهيل البنى الحيوية، وتعزيز آليات الحماية للعائدين.
غير أن تاريخ السودان يُظهر أن مؤتمرات كثيرة أفرزت تعهدات سخية دون أن تُحدث تغييراً هيكلياً مستداماً.
ومن هنا، يتوقف الاختبار الحقيقي لمبادرة واشنطن على قدرتها على دمج التمويل الإنساني ضمن هندسة سلام أوسع تربط الإغاثة من خلالها بآليات مراقبة وقف إطلاق النار، وممرات حماية مدنية، واستعادة الحكم المحلي، وبدون هذا التكامل، يُعاد إنتاج مشهد دبلوماسي قوي بأثر ميداني ضعيف.
وتفتقرُ العملية السياسية حتى الآن إلى بنية سلام شاملة وإدماج فعلي للمدنيين، إذ تتجزأ مسارات التفاوض، وتتعدد الوساطات، ويتنافس الفاعلون الخارجيون على النفوذ، فيما تبقى قوى المجتمع المدني السوداني، من لجان المقاومة والاتحادات المهنية والمجموعات النسوية وشبكات الإغاثة، على هامش الهياكل الرسمية.
وتؤكدُ دراسات عمليات السلام أن الاتفاقات التي تشارك فيها قوى المجتمع المدني أكثر صموداً والتزاماً، غير أن السودان يكرر نموذج الفشل المعروف القائم على مفاوضات نخبوية بلا شرعية اجتماعية.
وبذلك، لا يمكن للعقوبات ومؤتمرات المانحين أن تكون بديلاً عن إطار سلام قابل للتنفيذ يستند إلى شرعية محلية وحماية فعلية للمدنيين، مهما أسهمت في تشكيل المناخ المحيط بالمفاوضات.
وتكمنُ الحقيقة المقلقة في أن العقوبات والمؤتمرات أسهل سياسياً من فرض السلام وإعادة بناء البنية التحتية، فتجميد الأصول أقل كلفة من نشر آليات مراقبة، وإعلان التعهدات أبسط من تمويل إعادة الكهرباء أو تأمين الأحياء.
وعلى المدى الطويل، تظل العدالة والمساءلة عنصرين أساسيين في تعافي السودان، وينبغي أن تبقى العقوبات جزءاً من منظومة أوسع للمحاسبة، خصوصاً في ما يتعلق بالمسارات القانونية بعد الحرب وتتبع الأصول، غير أنه لا يصح أن تتصدر هرم السياسات بينما يعود المدنيون إلى مدن بلا ماء أو كهرباء أو مدارس أو حماية.
ولكي تستعيد الاستراتيجية الدولية مصداقيتها، ينبغي أن تعكس أولويات اليوم المقلوبة، كأن تفرض وتراقب وقف إطلاق النار عبر آليات منسقة، وتنشئ ممرات مدنية محمية وأطر عودة آمنة، وتعيد تأهيل البنى الأساسية من المياه والكهرباء إلى الرعاية الصحية والتعليم.
وقبل كل ذلك، يجب أن تُدمج قوى المجتمع المدني السوداني مباشرة في مسارات التفاوض، وأن تُعامل العقوبات كأدوات مساءلة مكمّلة لا كاستراتيجية رئيسية.
وفي الخلاصة، لا يفتقر السودان إلى بيانات الإدانة، ولا إلى حزم العقوبات، ولا إلى مؤتمرات المانحين، بل يفتقر إلى اتساق الأولويات التشغيلية مع هرم البقاء الذي يعيشه المدنيون: أمانٌ يسبق الرمزية، وبنية تحتية تسبق الاستعراض، وسلامٌ يسبق تسجيل المواقف.
وبالنسبة للعائلات العائدة إلى أحيائها المدمّرة، لا تُرى العقوبات ولا تُلمس بيانات الشجب، إنما يُقاس كل شيء بعودة الكهرباء، وفتح العيادات، وتدفق الماء النظيف، وانسحاب المجموعات المسلحة.
وعليه، ينبغي أن يُقاس الأداء الدولي بالمعيار ذاته لا بما يُعلن في المؤتمرات، بل بما يستطيع المدنيون أن يعيشوا به فعلاً.
للاطلاع على المقال الأصلي من (هنا)