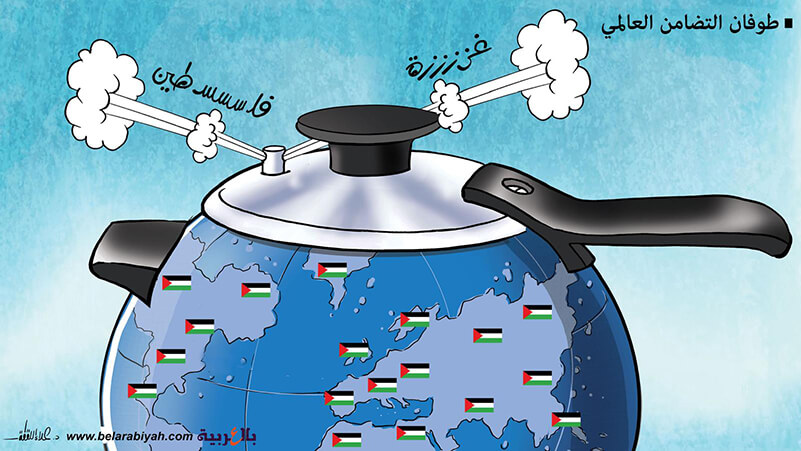بقلم غادة الكرمي
ترجمة وتحرير نجاح خاطر
مع وصول الدولة العبرية إلى العام السابع والسبعين من عمرها، يبدو أن نهاية العالم بالنسبة للفلسطينيين قد صارت أقرب من أي وقت مضى.
نعم يبدو وكأن الأمر لا يُصدق، إلا أن دولة الاحتلال تتجه بخطى ثابتة نحو تفريغ غزة والضفة الغربية من سكانهما الأصليين، أي تطهير الأرض من الفلسطينيين تحقيقاً للهدف الذي سعت إليه حتى منذ ما قبل تأسيسها.
هذا الاحتمال المروع، الذي يشاهده العالم دون أن يحرك ساكنًا، يُعيد إلى ذهني ذكريات حية لنكبة عام 1048، عندما نفذت دولة الاحتلال أول تطهير عرقي جماعي للفلسطينيين، دون أن يتدخل أحد تماماً كما هو الحال الآن.
في ذلك الوقت، كنت طفلًة، لكنني أتذكر أنني ظننت أن نهاية العالم قد حانت، فقد قضيت أنا وإخواني الفلسطينيين بقية حياتنا نتعافى من تلك الصدمة الكارثية، ولم أتخيل قط أن يحدث بعد كل هذه العقود ما هو أسوأ بكثير.
التطهير العرقي النهائي
في حال حدث هذا التطهير العرقي النهائي للفلسطينيين من خلال القتل المباشر أو الطرد الجماعي فلن يكون نتيجةً للإمكانات العسكرية لدولة الاحتلال وحدها، بل سيكون نتيجةً للدعم غير المحدود وغير القابل للنقد من قِبَل داعميها الغربيين، وتواطؤهم غير الأخلاقي في هذه الإبادة الجماعية
هذا التساهل الغربي تجاه جرائم الاحتلال يثير حيرة الكثير من الفلسطينيين، لكن التساهل الذي حصلت عليه دولة الاحتلال تجاه إبادتها لغزة يعود إلى زمن بعيد.
ففي عام 1917، مهد وعد بلفور، الذي أدخل الصهيونية إلى فلسطين، الطريق لسياسة صهيونية هيمنت على الغرب منذ ذلك الحين، كان الفلسطينيون وقتها شعبًا مزارعاً يعيش بسلام في ركن صغير من الإمبراطورية العثمانية، قبل الغزو البريطاني عام 1918.
ولم يكن لديهم أي علم أو اهتمام بما يُسمى بالمشكلة اليهودية في أوروبا، بل كانت بلادهم مكانًا يفتقر شعبه إلى أي فهم ثقافي للصهيونية أو التاريخ اليهودي الأوروبي الذي ساهم في نشوئها.
كان جدي، المولود عام 1850، مزارعًا في مدينة طولكرم بالضفة الغربية ووجهًا من أعيانها، ولم يكن يعرف سوى اليهود الذين عاش معهم بودّ، وكان يُطلق عليهم “اليهود العرب”، وهم اليهود الفلسطينيون الأصليون الذين كانوا يُشكلون آنذاك 3٪ من سكان فلسطين.
كيف كان بإمكانه أن يفهم تعقيدات معاداة السامية الأوروبية، وكيف ستؤدي إلى قيام الدولة العبرية في وطنه لاحقاً؟
وعند وفاته عام 1935، وبينما كان لا يزال غير مستوعب لما يجري، كان المستعمرون البريطانيون يحكمون فلسطين، ويرسخون الصهيونية فيها.
ولا تزال بساطته في مواجهة هذه الأيديولوجية الغريبة قائمة إلى حد كبير بين الفلسطينيين حتى يومنا هذا، إذ لا تزال الأغلبية تفتقر إلى فهم كافٍ لدقائق التاريخ اليهودي الأوروبي، والمحرقة النازية، والشعور بالذنب الذي ولّدته لدى الغربيين.
غطاء غربي
نشأتُ وأنا أعلم أننا كفلسطينيين لا نحظى بأهمية تُذكر لدى الغرب في المشروع الأكبر المتمثل في إنشاء الدولة العبرية وتطويرها الذي فضّلوه.
لقد تطلّب الأمر هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 ليُظهر لنا مدى ضآلة ما كنا نعنيه، وعلى النقيض من ذلك، مدى قيمة دولة الاحتلال لدى مؤيديها الغربيين.
ففي أعقاب عملية حماس، انخرطت الولايات المتحدة وحلفاؤها في جهود حثيثة لتعبئة قواتهم العسكرية والسياسية والاقتصادية والدبلوماسية للدفاع عن الدولة العبرية وكأنهم هم أنفسهم من تعرضوا للهجوم.
ومنذ ذلك الحين، استمر تقديم المساعدات العسكرية الغربية لدولة الاحتلال، مما مكّنها من تدمير غزة والضفة الغربية، وقد حماها الدعم الدبلوماسي الأمريكي في الأمم المتحدة من اللوم.
وُصفت المنظمات الدولية، مثل محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، بالازدراء، وقُوِّض القانون الدولي لحماية دولة الاحتلال.
ويتعرض الفلسطينيون وكل من يدافع عنهم إلى اللوم بشكل متزايد ويواجهون خطر العقاب، كما لو أنهم كانوا متورطين في إبادة جماعية وليس الاحتلال.
واليوم، نشهد تجويعًا جماعيًا مُتعمدًا في غزة، بينما تُنهب الضفة الغربية لإنشاء غزة ثانية، في حين يتجاهل داعمو الاحتلال كل هذا، وهناك الكثير من السياسيين المستعدين للتعامل كالمعتاد مع دولة تخضع للتحقيق بتهمة الإبادة الجماعية.
“مشكلة” مرحلة
كان ينبغي أن تكون الرسالة من كل هذا واضحة للفلسطينيين دائمًا، فبالنسبة للغرب، لم يكن ما يُسمى بالصراع يدور قط حول فلسطين أو شعبها، بل كان دائمًا يدور حول علاقة أوروبا غير المحسومة مع مجتمعاتها اليهودية.
تاريخيًا، كان هذا الصراع غالبًا ما يتجلى في صورة معاداة للسامية، وأحيانًا في صورة حبّ للسامية، وفي الوقت الحاضر في صورة كليهما.
كانت “المسألة اليهودية”، كما عُرفت، محل نقاش حاد وصراع محتدم في أوروبا طوال القرنين التاسع عشر والعشرين، ومن هنا، وُجدنا نحن الفلسطينيين.
ففي محاولتنا حل مشكلتهم اليهودية، نقلها الغرب إلينا بكل بساطة، ورغم أنه لم يكن لنا دور في المسألة اليهودية في أوروبا، فقد أُنشئت دولة الاحتلال لحلها في زاويتنا من العالم العربي.
لقد أصبحنا مجرد عقبات يجب إزالتها من وجه ما أصبحوا يسمونه تاريخًا يهوديًا، والمفارقة أننا أصبحنا معروفين من خلال انشغال العالم الغربي بالمسألة اليهودية.
وعلى حد تعبير الشاعر الفلسطيني الشهير محمود درويش: “لو كانت حربنا مع باكستان، لما سمع بي أحد”، في الواقع، لو لم يكن خصومنا يهودًا، فمن كان سيسمع بنا؟
من كان ليعلم أو يهتم إذا جاء أناس من باكستان أو من أي مكان آخر في العالم الثالث إلى بلدنا عام 1948 وطردونا منه وحلوا محلنا؟ بالنسبة للإمبرياليين الغربيين، كان الأمر سيُعتبر مجرد مناوشة إقليمية بين سكان أصليين متخلفين يغزون بعضهم بعضًا.
لكن للأسف، كان “شعب باكستان” يهودًا أوروبيين ذوي تاريخ مضطرب، يسعون للانتقام لمعاناتهم.
لو أنهم انتقموا من مضطهديهم الأوروبيين، لا منّا لبقينا حينها نعيش الغفلة في وطننا.
للاطلاع على المقال الأصلي من (هنا)