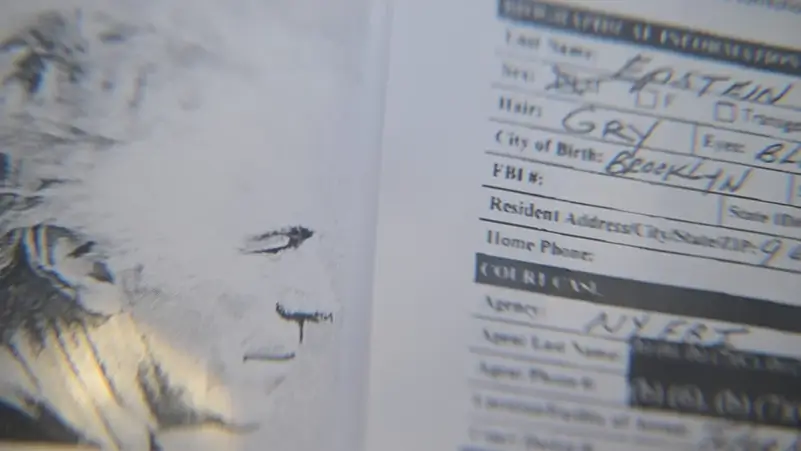بقلم سمية الغنوشي
ترجمة وتحرير نجاح خاطر
قد يبدو الاعتراف بدولة فلسطين، للوهلة الأولى، نقطة تحول أخلاقية وعلامة على وعي غربي تم تداركه وسط دمار غزة حين تصدرت فرنسا المشهد، مستضيفةً مؤتمرًا دوليًا مع السعودية تحت راية الأمم المتحدة.
وسرعان ما تبع باريس رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، معلنًا اعترافًا مشروطًا بهذه الدولة، أما وزير خارجيته، ديفيد لامي، فتحدث عن “عبء خاص من المسؤولية” على بريطانيا في إشارة إلى وعد بلفور الذي مهد لاستعمار الاحتلال الصهيوني لفلسطين تحت الحماية البريطانية.
لكن وراء هذه المظاهر، يتضح أن هذه الخطوة ليست إلا قناعًا دبلوماسيًا يخفي واقعًا مألوفًا، فما يُعرض ليس دولة حقيقية، بل كيان شبه دولة منزوعة السلاح وغير متصل جغرافيًا، بلا سيطرة على الحدود أو الأجواء أو الموارد أو حركة السكان.
أجل المعروض هو إدارة شبحية تحت سيطرة الاحتلال، مكلفة بإدارة شعب محطم وواقع محتل وسقف أقل من اتفاقيات أوسلو، وأكثر شبهاً ببلدية مزخرفة تدّعى تحريرًا، ومع ذلك، يعرض القادة الغربيون هذا كخطوة جريئة ورؤية مستقبلية، لماذا؟ لأن الأمر لا يتعلق بحقوق الفلسطينيين، بل بحجب سياسي.
تناقض سخيف
ترى فرنسا، تحت قيادة الرئيس إيمانويل ماكرون، أن القضية الفلسطينية جسر دبلوماسي للعودة إلى العالم العربي والإسلامي، بعد تراجع نفوذها في أفريقيا، الأمر الذي جعل ماكرون يتصرف كأنه شارل ديغول الجديد رغم سجل فرنسا في دعم طموحات الاحتلال النووية.
أما السعودية، فتستغل مبادرة الاعتراف لتبرير التطبيع مع الاحتلال، مقدمةً وهم التقدم، بينما تغرق الدول العربية والإسلامية أعمق في اتفاقيات إبراهيم.
وتبدو دوافع ستارمر أكثر مباشرة وسط تصاعد الغضب الشعبي على دعمه الثابت لعدوان الاحتلال وظهور تحدٍ يساري جديد بقيادة جيريمي كوربين وزهراء سلطانة، وبالتالي فإن ستارمر يستخدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية كوسيلة تمنحه بعض الرصيد.
إنه ليس التزامًا، بل تكتيك قدمه مشروطًا، كوسيلة ضغط لإعادة الاحتلال إلى “عملية السلام”، فإذا تعاون الاحتلال، يتم تعليق الاعتراف وتصبح دولة فلسطين ورقة مساومة تُلعب، لا حقًا يُعترف به.
إنه تناقض سخيف، فلو كان ستارمر مؤيدًا حقًا لحل الدولتين، لكان الاعتراف بالدولة الثانية الخطوة المنطقية الأولى، لكن في الغرب، حتى الرموز تجاه فلسطين تمر عبر تل أبيب.
غضب الاحتلال والغرب الصامت
بل إن هذه الخطوات الرمزية حتى أزعجت التحالف اليميني المتطرف للاحتلال الذي سخر وزير خارجيته إسرائيل كاتس من الفكرة بالدعوة إلى بناء دولة فلسطينية في باريس أو لندن، في حين هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب كندا بفرض عقوبات تجارية عليها لمجرد التفكير في الاعتراف.
لكن هذا الغضب لا يجب أن يشتتنا عن الحقيقة الأعمق، وهي أن هذه المبادرة مجرد وهم لتخدير الضمير الدولي، فغزة تُدمر وتمحى بالكامل والغرب يلتزم الصمت، أحياء بأكملها دُمرت، مستشفيات ومدارس ومنازل تحولت إلى رماد، ووزراء الاحتلال يعبرون عن نواياهم صراحة: “كل غزة ستصبح يهودية” و”علينا أن نجد طرقًا أكثر إيلامًا من الموت” لشعبها.
هؤلاء ليسوا متطرفين هامشيين، بل وزراء الدولة الذين يضعون السياسات الرسمية، والغرب يشاهد بصمت، مقدمًا “اعترافات” بدل العقوبات.
دبلوماسية خاوية
وفي الضفة الغربية المحتلة، يتصاعد عنف المستوطنين والغارات العسكرية، وقد نما عدد المستوطنين من 250 ألفًا في 1993 إلى أكثر من 700 ألف في 2023، رغم وعود أوسلو بتجميد التوسع.
وشبرًا بشبر، ومن نقطة تفتيش لأخرى، ومن تلة لأخرى، تُمحى أرض الدولة الفلسطينية القابلة للحياة، هذا ليس خطأ سياسياً، بل هو سياسة متعمدة.
السلام المزيف وأوسلو
بدأت هذه السياسة في مدريد عام 1991، وُرسخت في أوسلو عام 1993، واستبدل القانون الدولي في “عملية السلام” تلك بمفاوضات لا تنتهي، وأخضعت العدالة للتأجيل.
وتحت الضغط، اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية بالمحتل وتنازلت عن 78% من فلسطين التاريخية، وسط اتفاق على التفاوض حول الـ 22% المتبقية التي تتكون من الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية المحتلة.
في المقابل، وُعدوا بدولة، لكن القضايا الجوهرية كاللاجئين والقدس والمستوطنات والحدود أجلت إلى أجل غير مسمى باعتبارها “قضايا الوضع النهائي”، وخلال ذلك، عمق الاحتلال من سيطرته.
تضاعفت المستوطنات، وبُني جدار الفصل العنصري، وتقطعت الضفة إلى كانتونات معزولة، وحُوصرت غزة وتعرضت للقصف، وأصبحت السلطة الفلسطينية، التي ولدت من رحم أوسلو، متعاقدًا فرعيًا مع أمن الاحتلال، مكلفة بقمع المعارضين ومراقبة شعبها.
وبدلاً من التحرير، حُكم بالإغلاق، وبدلاً من السيادة، فرضت الرقابة، ولم تكن هذه “عملية سلام” بل كانت تهدئة، وكلما تصاعد النضال الفلسطيني كما حصل في الانتفاضة الأولى والثانية، أو الآن مع الغضب العالمي على غزة يعود نفس السيناريو: إحياء الحديث عن “حل الدولتين” لا بهدف تحقيق هذا الحل، بل لدفن الحراك في جولة جديدة من الدبلوماسية الخاوية، إنها استراتيجية احتواء متنكرة في شكل اهتمام.
دولة افتراضية وواقع مأساوي
تواجه غزة مجاعة متعمدة، لكن بدلًا من وقف الحصار أو معاقبة الحاصرين، ينسحب الغرب إلى وهم “الدولة الافتراضية” حيث تحل الكلمات محل الضغط، والإيماءات محل العدالة، فيما تواصل فرنسا وبريطانيا وألمانيا تزويد الاحتلال بالأسلحة وتقديم الدعم السياسي صلب، تحت شعار “حق الاحتلال في الوجود”، فيما يُسلب حق الفلسطينيين في الحياة.
ومن هنا فإن الاعتراف بلا أفعال هو مجرد تواطؤ، إذ لم يتغير شيء جوهريًا، فقط تغير الخطاب فيما استمرت تدفقات الأسلحة ومدد الأموال وفيض الأكاذيب.
لو كان الغرب يؤمن فعلاً بدولة فلسطين، لبدأ بقطع الدعم العسكري والمالي والدبلوماسي الذي يغذي نظام الفصل العنصري والاحتلال، لكن الاعتراف بلا عواقب ليس خطوة إلى الأمام إنه التفاف حول الحقيقة ولعبة مألوفة ودمار مستمر.
لقد رأينا هذه اللعبة من قبل، “عملية” لا نهاية لها تؤدي بشكل مقصود إلى اللامكان، وحتى الآن، في غزة، المفاوضات مجرد غطاء، فقد كان وقف إطلاق النار ممكنًا في يناير/كانون ثاني الماضي، لكن الاحتلال نقضه في مارس/آذار، دون أن يخضع لأي عقوبات، فقط عودة إلى “المحادثات” بينما يستمر التطهير العرقي ويتحدث المسؤولون عن “غزة يهودية”.
ماكرون وستارمر يتحدثان عن دولة فلسطينية وهما يمولان محوها، ويقدمان “اعترافًا” لا يعني شيئًا سوى التأجيل، ما يقترحانه ليس سيادة، بل رمزًا، وهمًا مريحًا لتهدئة الغضب الشعبي بينما يرسخ الاحتلال.
ويبقى السؤال البسيط: أين ستكون هذه الدولة؟ دولة موجودة على الورق فقط، ودولة يجب أن يوافق عليها المحتل، ليست بدولة بل هي كذبة، والاعتراف بلا فعل ليس بدبلوماسية بل تواطؤ
وإذا لم يوقف الغرب الإبادة وتدفق الأسلحة والتمويل، أو يفرض ثمنًا واحدًا على جرائم الاحتلال فستبقى تصريحاته أسوأ من مجرد أنها عديمة المعنى، بل إنها جزء من آلة القتل.
لذا، دعونا نسأل الساعين وراء هذا الوهم سؤالًا بسيطًا: أين بالضبط ستسيطر هذه الدولة الفلسطينية؟ هل في غزة، التي تحولت إلى رماد؟ في الضفة الغربية، التي مزقتها الجدران والمستوطنات؟ في القدس، التي ضمها الاحتلال ونفذ تطهيرًا عرقيًا فيها؟ في الأردن؟ في سيناء؟ في السعودية، كما اقترح نتنياهو بسخرية؟ أم هل على المريخ؟
إذا كان من المفترض أن تكون على الأرض المحتلة في 1967، فعلى الغرب أن يعاقب المحتل، وإن كان من المفترض أن تُبنى في أي مكان آخر، فليسمّوها كما هي: تهويد، وتطهير عرقي، وإرهاب دولة.
للاطلاع على المقال الأصلي من (هنا)