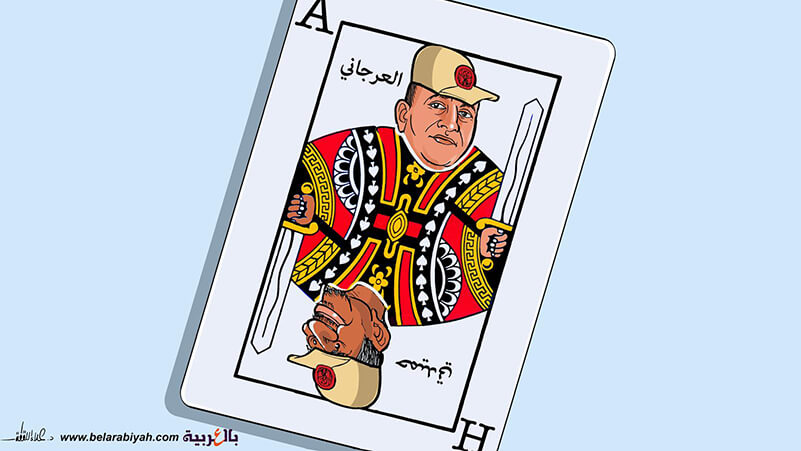بقلم سماح جبر
ترجمة وتحرير مريم الحمد
عندما أكتب عن آخر التطورات في آلية السيطرة التي تخنق حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية، ينتابني حزن عميق، فقد تكاثرت الهياكل الحديدية الصفراء التي تربط بين كتلتين ضخمتين من الأسمنت، والتي تسمى خطأً باسم “البوابات”، في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة.
برأيكم، ما هو شعور المريض الذي يعاني من نوبات الهلع وهو محاصر في مثل هذا الهيكل وقد تأخر عن العلاج؟ ماذا يعني هذا بالنسبة لشخص مصاب بالاكتئاب ليجد حتى أن رحلته للعلاج معطلة تتحكم بها نزوة جندي؟!
أنا أسميها المشؤومة، وذلك لأنها تثير ترقباً عميقاً ومروعاً، خاصة مع التهديدات المستمرة بمزيد من التطهير العرقي وسرقة الأراضي في الضفة الغربية!
هي ليست بوابات إذن، هي فتحة في جدار الهدف منها الدخول والعبور والاحتمال والخروج والطريق إلى الأمام، وهي هياكل سرطانية تحول أحيائنا الصغيرة إلى أقفاص في كل من الضفة الغربية المحتلة والقدس، فقد تم تصميمها عمداً للعزل والعرقلة والتعطيل والخنق.
في الأسبوع الماضي فقط، اتصلت أم قادمة من القدس بعيادتي وهي تبكي، فقد كانت قد أعدت ابنها البالغ من العمر 12 عاماً لجلسة علاجية طال انتظارها، لكن الجنود الإسرائيليين أبقوها تنتظر عند إحدى هذه الجدر الحديدية لمدة 3 ساعات.
عندما وصلت، كنت قد خرجت من العيادة، وكان ابنها، الذي يعاني بالفعل من القلق، يبكي بلا حسيب ولا رقيب في المقعد الخلفي للسيارة لأنه لا يريد أن يحاول القدوم مرة أخرى أبداً.
وهذه قصة صغيرة من مئات القصص في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة كل يوم!
تفتيت حياة الفلسطينيين
إذا توقفنا عند الأرقام، فهي صادمة، فمنذ أكتوبر عام 2023، تم إنشاء المئات من هياكل السجن الجديدة في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، ليصل إجمالي عدد معوقات الحركة إلى ما يقرب من 1000، وفي القدس الشرقية وحدها، تشكل أكثر من 80 نقطة تفتيش ومبنى توقيف شبكة من الفولاذ تهدف إلى تجزئة الحياة الفلسطينية إلى جيوب منفصلة.
وتؤدي تلك المعيقات إلى عواقب مدمرة، حيث أدت عمليات الإغلاق إلى زيادة الفقر، فقبل أسبوعين، عندما تسلق العامل سند الحنتولي، البالغ من العمر 22 عاماً من جنين، الجدار العازل في محاولة للوصول إلى القدس حاملاً فقط كيساً من الملابس، حيث كان يأمل في العثور على عمل لإطعام أسرته، أطلق الجنود الإسرائيليون النار عليه فاستشهد.
وفي بعض القرى، حصل أن تأخرت سيارات إسعاف لفترة طويلة بسبب هذه الهياكل، مما أدى إلى وفاة المرضى قبل الوصول إلى الرعاية الطبية، وهذه ليست حوادث بل هي النتائج المتوقعة للسياسات التي تفرض العزلة والجمود.
ومع ذلك، فهذه الهياكل ليست اختراعات جديدة، بل هي استمرار لعقود من البنية الاستعمارية بهدف السيطرة، فمنذ اتفاقيات أوسلو، تعرضت الحركة في الضفة الغربية المحتلة للخنق بسبب عمليات الإغلاق والتصاريح والجدران والمبررات “الأمنية”.
ما نشهده الآن ما هو إلا تكثيف للمنطق نفسه، وذلك بهدف تفتيت الأرض وتمزيق نسيجها الاجتماعي وجعل الحياة اليومية لا تطاق، حتى يشعر الناس بالغربة وفي النهاية يستسلمون أو يرحلون.
لقد وصلت أداة الخنق هذه الآن إلى حي الرام شمال القدس، حيث توجد عيادتي للطب النفسي، فعيادتي، التي تخدم عدداً كبيراً من السكان في الضفة الغربية المحتلة والقدس، موجودة لمساعدة الناس على التعافي ولدعمهم في استعادة الهدف والمعنى في حياتهم.
لقد تسببت الهياكل السرطانية التي أقيمت حول الرام بتعطيل الوصول للعيادة، فأنا أعمل مع المرضى لاستعادة قدرتهم على التعافي من الضيق والصدمات، ولكن هذه الهياكل باتت تعطل عمداً الإيقاع الأساسي لحياة الناس، مما أدى إلى خلل هندسي داخل المجتمعات الفلسطينية!
لاشك بأن المفارقة مؤلمة، فأنا أسعى داخل العيادة إلى تخفيف نوبات الهلع وإزالة الاكتئاب وإعطاء الأمل لمن يعانون، فيما تعمل الهياكل السرطانية في الخارج على تضخيم القلق وعرقلة الأمل وفرض طبقات جديدة من الضيق.
برأيكم، ما هو شعور المريض الذي يعاني من نوبات الهلع وهو محاصر في مثل هذا الهيكل وقد تأخر عن العلاج؟ ماذا يعني هذا بالنسبة لشخص مصاب بالاكتئاب ليجد حتى أن رحلته للعلاج معطلة تتحكم بها نزوة جندي؟!
قلق مزمن
من الناحية النفسية، تخلق هذه الهياكل حالة من القلق المزمن والتعسفية، حيث يصف المرضى خوفهم عند الاقتراب من “البوابة”، دون أن يعرفوا ما إذا كانت ستفتح أم ستبقى مغلقة لساعات، وهكذا يتعلم الأطفال مبكراً بأن حياتهم مرهونة بكبسة زر في يد الجندي.
في الوقت الحالي، لا تزال هناك قدرة على الصمود، ولا يزال المرضى يأتون ويسيرون أحياناً لأميال، ولا تزال العائلات تتجمع حتى لو تأخروا، ولا يزال الأطفال يحلمون بمستقبل خارج الجدران، فهذه المرونة وليدة الضرورة وليس الاختيار ولكنها حقيقية
بمرور الوقت، يؤدي هذا القلق إلى تآكل إحساس الشخص بالقدرة على التصرف، فالعلاج يتطلب الروتين والقدرة على التنبؤ، لكن الاحتلال يفرض الفوضى التي قد تمنعهم حتى من مغادرة منازلهم للقدوم للعلاج.
يدعي الاحتلال أن هذه الهياكل هي “إجراءات أمنية”، لكن لمن؟ ما هو الأمن الذي يتحقق عندما يتغيب طفل عن المدرسة أو يتغيب مريض عن العلاج أو عندما تكون مدينة بأكملها محبوسة؟!
الحقيقة هي أن هذه الهياكل لا تتعلق بالسلامة بل بالهيمنة، فهي بمثابة حبل المشنقة حول رقابنا!
ولا يقتصر الضرر على الأفراد، بل يتم فصل العائلات، فالجدة قد لا تتمكن من حضور حفل زفاف حفيدها لأن البوابة مغلقة، والطلاب قد يتغيبون عن امتحاناتهم الجامعية، والمزارعون قد يشاهدون محاصيلهم تتعفن لأن الشاحنات لا تستطيع المرور في الوقت المناسب، كما يمكن إيقاف موكب الجنازة في منتصف الطريق، مما يؤدي إلى إذلال المشيعين الذين يضطرون إلى التوسل من أجل المرور.
تفكيك تلك الأقفاص
في كل مرة أجلس مع مريض، أرى مقدار القوة التي يتطلبها مجرد محاولة الحصول على العلاج تحت الاحتلال، فالهياكل السرطانية تبطل هذا الجهد وتحاصر الناس في حالة من الخوف والإحباط قبل أن يتمكنوا حتى من الوصول إلى باب العيادة.
في فلسطين اليوم، لم تعد وصمة العار هي التي تمنع الناس من طلب العلاج النفسي، بل العوائق التي تستهدف صحتنا العقلية فهي باتت مادية وملموسة، فكل تأخي وكل إغلاق وكل منع تعسفي للمرور، هي أمور تعزز الشعور بالعجز واليأس، فيما يتطلب التعافي الاتساق والاتصال وإمكانية الوصول والسلامة، وهذا بالضبط ما صممت هذه الهياكل لتحطيمه.
رداً على حالة الاختناق هذه، فقد أنشأ الشباب مجموعات على تطبيق “تليغرام” تراقب وتعلن عن مواعيد فتح وإغلاق البوابات وتحذر الآخرين من الإغلاق المفاجئ أو الطوابير الطويلة.
من طرفي، فقد قمت بتوسيع خيارات العلاج عن بعد للتحايل على هذا الفخ، وذلك شكل متواضع من أشكال المرونة الجماعية وطريقة لاستعادة بعض القدرة في مواجهة الفوضى المتعمدة، فالمجتمعات الرقمية التي أنشأها الاحتلال لنا هي أنظمة مراقبة تهدف إلى الوصول لحالة التشرذم، يبحث الفلسطينيون عن طرق لدعم بعضهم البعض كمقاومة لها.
وتعد ملامسة هذا الواقع جزءاً من عملي والتحدث عنه واجب علي، فلكي يعيش الفلسطينيون بكرامة وتحظى العلاجات الصحية التدخلات الطبية النفسية بأي فرصة للنجاح، فإن تفكيك آلية العرقلة هذه هو شرط أساسي للبقاء والشفاء والحفاظ على إنسانيتنا.
في الوقت الحالي، لا تزال هناك قدرة على الصمود، ولا يزال المرضى يأتون ويسيرون أحياناً لأميال، ولا تزال العائلات تتجمع حتى لو تأخروا، ولا يزال الأطفال يحلمون بمستقبل خارج الجدران، فهذه المرونة وليدة الضرورة وليس الاختيار ولكنها حقيقية، فهي تؤكد لنا بأن الفلسطينيين سوف يستمرون في الإصرار على الحياة والشفاء والتواصل الإنساني، حتى عندما يعطل مهندسو الاحتلال ذلك من حولهم.
وفي الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي للصحة العقلية، أود أن أؤكد من جديد أنه لا يمكن فصل الصحة العقلية عن الحرية السياسية، فلن يزدهر الشفاء إلا عندما يتم تفكيك الأقفال والأقفاص وعندما يُسمح للفلسطينيين بالعيش بكرامة على أرضهم.
للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)