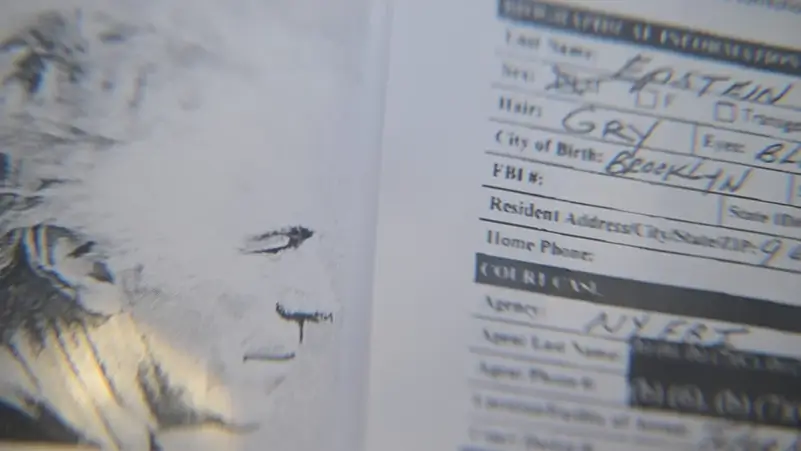بقلم حميد دباشي
ترجمة وتحرير نجاح خاطر
كان الليبراليون الإمبرياليون في الولايات المتحدة سيسعدون بفوز جو بايدن أو كامالا هاريس في انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة، لكنهم استشاطوا غضبًا وحزنًا من الإحراج العالمي الذي سببه لهم دونالد ترامب على صفحات صحيفة نيويورك تايمز وغيرها.
وترامب إمبريالي واضح جدًا وفظ جدًا ومبتذل جدًا، وأولى مواقفهم التلقائية تجاهه هي التبرؤ منه باعتباره حالة شاذة، حيث يبدو كديكتاتور من أمريكا اللاتينية، أو مستبد أفريقي، أو طاغية شرقي، أو قيصر روسي.
يُصوَّر ترامب على أنه النسخة الأمريكية من أردوغان وبوتين والسيسي وأي شيء، في أي مكان، طالما بدا بعيدًا عن الولايات المتحدة الأمريكية إلا أن يكون أمريكيًا، لكنه يمثل أكثر منهم جميعًا، إنه يمثل 77,284,118 أمريكيًا مثله تمامًا، سارعوا إلى التصويت له لإيصاله إلى السلطة.
هذا داء فكري غريب يتجلى بوضوح في الولايات المتحدة، حيث يرفض الليبراليون المهزومون والمحبطون الاعتراف بأن ترامب ظاهرة أمريكية 100%، إنه ديكتاتور محلي ذو ميول فاشية صريحة، بالكاد يستطيع كبح جماح رغباته، ومحاط بمتملقين أمريكيين 100% أسوأ من أي مهرج أو بهلوان بلاط استحضره خيالهم الاستشراقي.
إن لم تصدق ذلك، فاستجمع شجاعتك وانظر إلى حكومته، إنها تتكون من متملقين أغبياء يتنافسون في تملق مكشوف، وكل هذا أمريكي، “صنع في أمريكا”، وليس مستوردًا، إنهم يجعلون أمريكا عظيمة مجددًا!
ودون الاعتراف بترامب كمجرم محليّ متوجّ، لن تتاح لهذه البلاد فرصة ولو ضئيلة للتحرر من هذه الفوضى القاتلة.
من موسوليني إلى حركة “لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا”
إذا كان هناك أي سياق لترامب، فهو التاريخ الطويل والحديث للفاشية الأوروبية، من هتلر وموسوليني إلى فرانكو، والآن جميع من يُنظر إليهم على أنهم قد ورثوا دكتاتوريتهم إلى حد الغثيان مثل فيكتور أوربان وماتيو سالفيني ومارين لوبان وخيرت فيلدرز ونايجل فاراج وبوريس جونسون.
أمعن النظر في جذور ادعاء أمريكا بالديمقراطية، وسترى الفاشية تُحدق بك، إذ يُحب كُتّاب الأعمدة في صحيفة التايمز الآن مقارنة ترامب بزعيم مافيا، أو بشريرهم المُفضّل، بوتين “السوفييتي”، لكن المافيا شذوذ، وبوتين مجرد كبش فداء، فترامب أقرب إلى هتلر وموسوليني وفرانكو والأقرب منه إليهم الجذور الفاشية المُكشوفة لما يُسمى بالديمقراطية الأمريكية
وهذا ترامب يفعل بالضبط ما وعد به دائمًا، وما يفعله دائماً مدعوم بادعائه تمثيل إرادة الأغلبية الأمريكية.
لكن هنا يكمن جوهر المفارقة، فليس هذا مجرد حكم الأغلبية، بل استبداد الأغلبية، وهو مصطلحٌ بالغ الدلالة ثاقب البصر نحته ألكسيس دو توكفيل في كتابه “الديمقراطية في أمريكا” (1835-1840) الذي صوّر فيه في مجلدين خبث الديمقراطية الأمريكية ومشاكلها.
الاستبداد
يشعر ترامب بانتعاش خاص بابتذاله السافر وبتجاهله الصريح حتى لأبسط معايير الكرامة الإنسانية، وهو ليس استثناءً فكراهية الأجانب أمريكيةٌ كفطيرة التفاح.
ومع ذلك، فأنا أُفضّله كثيرًا على ازدواجية أوباما الأنيقة وصدقه الزائف، الذي قدّم من خلاله بعضًا من أبشع المخططات الإمبريالية التي يُمكن تخيّلها بما في ذلك العسكرة المفرطة لمستعمرة المستوطنين في دولة الاحتلال بفعاليةٍ أكبر بكثير مما استطاع ترامب فعله.
في الواقع، سلوك ترامب البلطجي مُتحرّرٌ للغاية، فكلما ازداد كره الأمريكيين الليبراليين له، زاد تقديري لكشفه الوجه الحقيقي لأمريكا دون تجميل، بأحمر الشفاه الديمقراطي الغليظ الذي صبغوا به خنازيرهم المستبدين، والذي أصبح الآن ملطخًا ومكشوفًا للجميع.
لكن لا ينبغي أن تنحدر هذه الأوصاف إلى مستوى القذف الشخصي بحيث يصبح الرؤساء وغيرهم من القادة رمزًا مجازيًا للدول التي تنتخبهم أو تتسامح معهم.
وكذلك الحال مع الرؤساء الأمريكيين، فماذا يمثلون؟ من منحهم السلطة ليفعلوا ما يفعلون؟ أغلبية الناخبين؟ بالتأكيد، وهذه الأغلبية هي النقطة الأساسية.
التشخيص
علينا أن نعود إلى ما يمكننا وصفه بأنه أكثر المفكرين الأجانب ذكاءً على الإطلاق ممن كتبوا عما يسمى “الديمقراطية” في أمريكا، إنه توكفيل، الذي زار الولايات المتحدة بين عامي 1831 و 1835 لدراسة نظام السجون فيها.
ففي عمله الكلاسيكي، يُقدّم توكفيل أفضل علاج لهذا الهوس المرضي بقصر النظر، مُعتبراً ترامب حالة شاذة، كما لو أنه سقط بطريقة ما من سماء “الاستبداد الاستشراقي”، إنه ليس حالة شاذة، بل هو أحد أعراض شيء أعمق وأكثر قتامة وأكثر ديمومة في التجربة الأمريكية.
يتجنب الأمريكيون مواجهة هذه الحقيقة على مسؤوليتهم الخاصة، وبذلك ينتظرون ما هو أسوأ من ترامب في مستقبلهم.
ولطالما فهم توكفيل أمريكا من خلال الإرث الأرستقراطي الذي خلّفته أوروبا أيديولوجيًا، ليكشف بذلك عما اعتبره القوة الأكثر شيطانية في قلب هذه الجمهورية الإمبراطورية.
لاحظ توكفيل أن “سلطة الملك مادية بحتة، إنها تتحكم في تصرفات الفرد دون إخضاع إرادته الخاصة، لكن الأغلبية تمتلك سلطة مادية وأخلاقية في آن واحد، فهي تؤثر على إرادة الأفراد كما تؤثر على تصرفاتهم، وتقمع ليس فقط كل خلاف، بل حتى كل جدل”.
هذه هي سلطة الأغلبية أو طغيان الأغلبية أو ما يُنظر إليه على أنه الأغلبية، لذا، لا يوجد استقلال حقيقي للعقل وحرية للنقاش في أمريكا.
لقد اكتشف توكفيل أخطر عيوب حكم الأغلبية في الديمقراطية الأمريكية وهو الميل إلى الاستبداد، الذي يتبدى الآن بوضوح في البيت الأبيض بقيادة ترامب.
“الروح مستعبدة”
قام توكفيل بتشخيص عمق الانحطاط الأخلاقي في الولايات المتحدة بشكل لم يسبقه إليه أحد، فكتب: “في أمريكا، تُقيم الأغلبية حواجز هائلة أمام حرية الرأي، وداخل هذه الحواجز، يحق للكاتب أن يكتب ما يشاء، لكنه سيندم إن تجاوزها، ليس لأنه مُعرّض لأهوال الاعتقال التعسفي، بل لأنه سيُعذب بإهانات واضطهادات التشهير اليومي”
يُطلق على هذا “التشهير اليومي” الآن اسم “التشهير” وهو عمل ترهيب وحشي أتقنه الصهاينة المُجرمون ضد كل من يجرؤ على تجاوز حدود الموافقة المُصطنعة التي تُصوّر دولة الاحتلال على أنها هبة الله للبشرية.
وبناء عليه بات بوسع دولة الاحتلال ارتكاب أعمال إبادة جماعية صريحة في وضح النهار أمام شهود عالميين، لكن إن تجرأت على التحدث ضدها علنًا، فستطوف بك الشاحنات في حيّك تحمل اسمك الكامل وعنوانك، متهمةً إياك بأبشع الجرائم، هذا هو “تشهيرك اليومي”.
وأضاف توكفيل: “كانت الأغلال والقتلة أدواتٍ فظة استخدمها الطغيان سابقًا، لكن حضارة عصرنا صقلت فنون الاستبداد التي بدت، مع ذلك، وكأنها قد أُتقنت بما فيه الكفاية من قبل”.
تقوم أجهزة الدعاية الإمبريالية الليبرالية من أكثر الأنواع تبذيرًا واختلالًا مثل نيويورك تايمز وفوكس نيوز وول ستريت جورنال بوضع حدود الخطاب المقبول، فقد لا توجد قيود ظاهرة، لكن القيود تعمل من خلال الضغط الأخلاقي والفكري، متحديةً أي معارض محتمل أن يتحداها ويتحدث علنًا.
وكما حذّر توكفيل: “لقد ابتكرت تجاوزات السلطة الملكية وسائل مادية متنوعة للقمع، لكن الجمهوريات الديمقراطية المعاصرة جعلتها شأنًا عقليًا بحتًا، تمامًا كما لو كانت الإرادة التي يُراد إكراهها”.
ومضى يقول: “تحت السيطرة المطلقة لمستبد فردي، يُهاجم الجسد لإخضاع الروح، فتنجو الروح من الضربات الموجهة إليها وتسمو فوق المحاولة، لكن هذا ليس النهج الذي يتبعه الاستبداد في الجمهوريات الديمقراطية، فهناك يُترك الجسد حرًا، وتُستعبد الروح”، لقد قرأ توكفيل روح الديمقراطية الأمريكية قبل أن يسقط قناعها.
أسطورة الأغلبية
تُختبر صلابة الإنسان بمقاومته للاستبداد، فسواءً في ظل حكم آية الله خامنئي الديني، أو سلطانية رجب طيب أردوغان المبهرجة، أو الابتذال السافر لعبد الفتاح السيسي، أو أوهام دونالد ترامب الخطيرة وكل رئيس أمريكي سبقه أو سيأتي بعده.
ما يُحدد المأزق الأمريكي هو: كيف يُصنع رأي الأغلبية وبالتالي قوتها الراسخة ويُحافظ عليه؟ وهناك ثلاث طرق لذلك: من خلال الانتخابات العامة، واستطلاعات الرأي الدورية، وقبل كل شيء، من خلال وسائل الإعلام المهيمنة.
تُصنع هذه المؤسسات وهم رأي الأغلبية من خلال شيطنة الفكر النقدي، وتطبيع الامتثال، والرضوخ، والقدرية المكبوتة في مواجهة مصير قاسٍ مُتجذر بعمق لدرجة يصعب معها حتى الاعتراف به، هذه هي الديمقراطية في أمريكا.
للاطلاع على المقال الأصلي من (هنا)