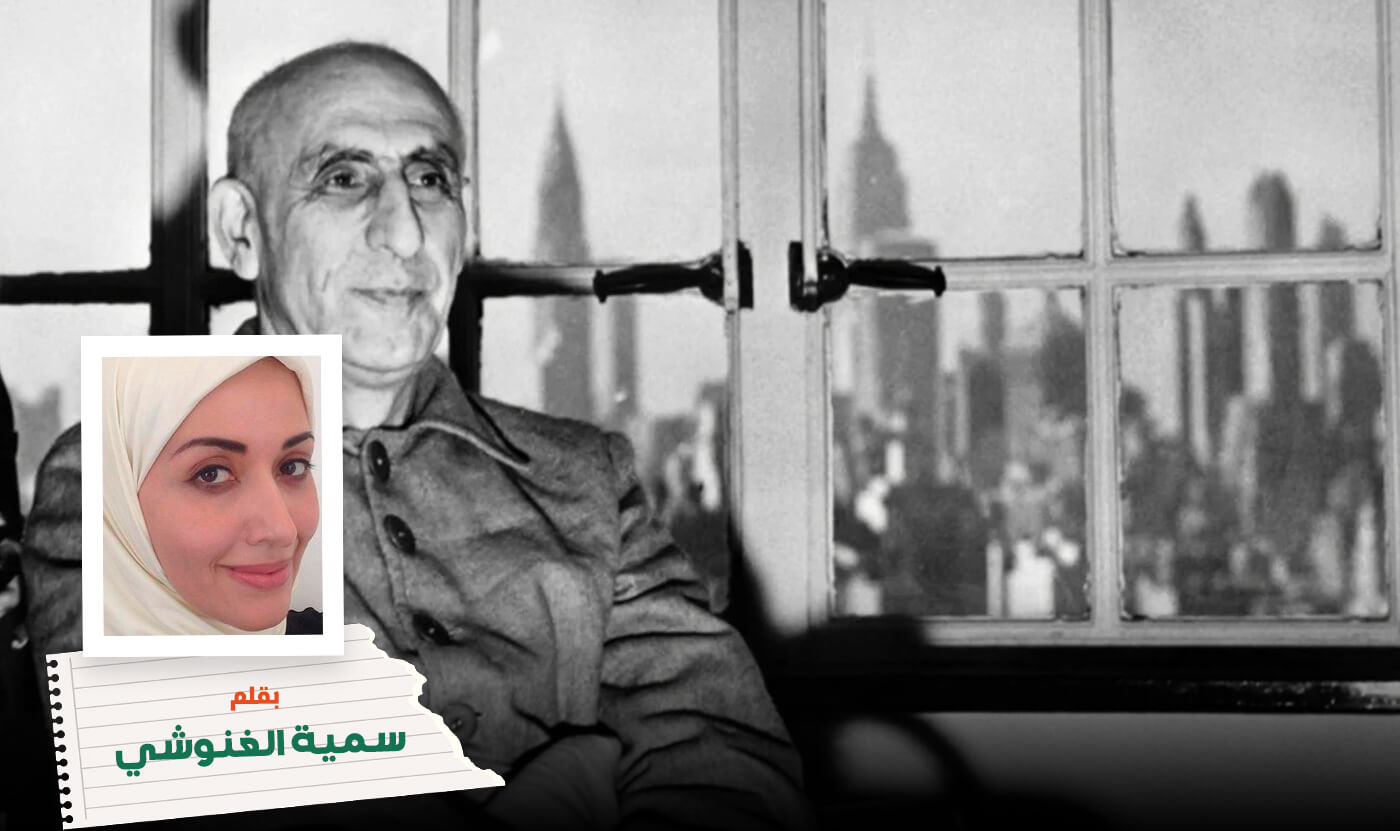بقلم جوناثان بورسيل
ترجمة وتحرير نجاح خاطر
خلال زيارة قمتُ بها إلى الأرض الفلسطينية المحتلة في وقت سابق من هذا العام، وقفتُ وجهًا لوجه أمام واقعٍ قمعيّ يعيش في ظله الفلسطينيون يوميًا، مسيحيين كانوا أم مسلمين، واقعٌ لا يمكن فصله عن منظومة الاضطهاد الديني والسياسي التي تفرضها دولة الاحتلال على شعبٍ بأكمله.
لملايين الفلسطينيين، من أتباع الديانتين المسيحية والإسلامية، لا يُعدّ الاضطهاد الديني استثناءً أو حادثًا عابرًا، بل ممارسة يومية متجذّرة، وهي حقيقة عملتُ على توثيقها والنضال ضدّها لسنوات طويلة، لا سيما منذ انخراطي في العمل بمجالي العلاقات العامة والاتصال في المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين، غير أن هذه الحقيقة، على قسوتها، لم تتجلَّ لي بكامل وضوحها إلا عندما وطئت قدماي الأرض الفلسطينية المحتلة.
هناك، تحت نظام فصلٍ عنصريٍّ متكامل الأركان، أدركت ما تعنيه الحياة اليومية للفلسطينيين، ثقل القمع كان خانقًا، إلى حدّ تعجز الكلمات عن وصفه، لكنه سيظل محفورًا في ذاكرتي ما حييت.
حتى تلك اللحظة، لم أكن قد تعرّضتُ شخصيًا لأي تعليق معادٍ للمسيحية، وهو امتياز يدفع الفلسطينيون ثمن غيابه يوميًا، إلا أن هذا الامتياز تبدّد سريعًا، وقبل أن أغادر حتى مقعدي في الطائرة المتجهة إلى مطار بن غوريون.
خلال الرحلة، بادرني رجل بريطاني-إسرائيلي كان يجلس إلى جانبي بسؤالٍ عن سبب زيارتي.، حرصتُ على تجنّب أي احتكاك غير ضروري، فأوضحتُ أنني مهتم بزيارة المواقع المقدسة المسيحية، وهو أمر صحيح، وإن كان ثانويًا مقارنة بمهمتي الأساسية، المتمثلة في مرافقة وفد من النواب البريطانيين للقاء فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
في محاولة لتهدئة الحوار، تطرقتُ إلى القواسم المشتركة بين التوراة والعهد القديم، لكن ردّه جاء فوريًا، لا بروح التشارك الإيماني، بل بالسخرية من العهد الجديد، واصفًا إياه بأنه “إضافة صغيرة”، اكتفيتُ بابتسامة مجاملة، وأنهيتُ الحديث عند هذا الحد.
كانت تلك الواقعة مجرد بداية، ففي القدس المحتلة، وبينما كنت أسير قرب باب العامود يوم سبت لعازر، عشية أحد الشعانين، وعلى مسار أوصى به زميل فلسطيني، بدأت ملامح القمع تتخذ طابعًا أكثر فجاجة.
مناخ القمع
بوصفي كاثوليكيًا رومانيًا، أرتدي في كثير من الأحيان صليبًا حول عنقي، لاحظتُ أثناء مروري، شخصين يجلسان على مقعدٍ يحدّقان بي، لم أولِ الأمر اهتمامًا في البداية، إلى أن شرعا بالصراخ، استدرتُ نحوهما، لأجد نفسي هدفًا لبصقٍ وشتائم، ودعواتٍ عدائية تطالبني بالاقتراب.
احتجتُ بضع ثوانٍ لأدرك أن الصليب الذي أرتديه، مقترنًا بقدسية اليوم الديني، كانا كفيلين بإطلاق هذا السيل من الكراهية.
تكتسب هذه الحادثة دلالتها الخطيرة من موقعها تحديدًا؛ فهي وقعت على بعد عشر دقائق سيرًا على الأقدام من كنيسة القيامة، التي يؤمن المسيحيون بأنها تحتضن قبر السيد المسيح.
كنا على أعتاب أسبوع الآلام، وكانت الكنائس محاصرة بإجراءات أمنية مشددة فرضها جيش الاحتلال، حيث خضع المصلّون للتفتيش قبل السماح لهم بالدخول، ولم يكن مقام المسيح استثناءً من هذه المعاملة المهينة.
سبق أن وثّقت تقارير عديدة اعتداءات لفظية وجسدية من قبل مستوطنين متطرفين على راهبات ورجال دين مسيحيين في القدس المحتلة، وسواء صدر التحرش عن المستوطنين أو عن عناصر جيش الاحتلال أنفسهم، فإنه يحدث دائمًا تحت أعين المؤسسة العسكرية، وفي مناخ قمعيٍّ يعيشه الفلسطينيون، مسيحيين ومسلمين، بلا انقطاع.
إن الدعم الضمني الذي تقدّمه حكومة دولة الاحتلال لعنف المستوطنين المتطرفين ليس تفصيلًا عابرًا، بل جزءٌ بنيوي من منظومة السيطرة، ولهذا، لا بد أن تطال العقوبات وزراء في حكومة دولة الاحتلال، لا المستوطنين الأفراد فحسب.
غير أن هذا المناخ القمعي بلغ ذروته في يوم الجمعة العظيمة، ففي هذا اليوم، يسير المسيحيون تقليديًا في “درب الآلام”، الطريق الذي سلكه السيد المسيح في طريقه إلى الصلب، وتشير “محطات الصليب” إلى المراحل الأربع عشرة لهذه الرحلة، وهي معالم راسخة في وجدان الكنائس الكاثوليكية، وموثّقة كذلك على جدران البلدة القديمة في القدس.
منذ طفولتي، اعتدتُ رؤية هذه المحطات تزيّن جدران الكنائس، لكن رؤيتها في موقعها الجغرافي الأصلي كانت تجربة مختلفة كليًا.
وصبيحة الجمعة العظيمة، انطلقتُ نحو البلدة القديمة بحماسٍ بالغ، قبل أن أُفاجأ بإبلاغي أن جيش الاحتلال يمنع دخول أعداد كبيرة من المصلّين المسيحيين، ولا سيما الفلسطينيين منهم.
وهنا، اتّضح لي أن ما يتعرّض له المسيحيون لا ينفصل عن سياسة أوسع من ترهيب المصلّين، سياسة تُطبَّق على الكنائس كما تُطبَّق على المساجد، بلا تمييز سوى في الأدوات.
حتى لو كُتب لي الدخول إلى البلدة القديمة في ذلك اليوم، فإن المخاطر لم تكن لتنتهي عند هذا الحد، فقد تحدث مسيحيون فلسطينيون بإسهاب عن تحوّل البلدة القديمة إلى ما يشبه “منطقة محرّمة”، بفعل اعتداءات المستوطنين المتطرفين، الذين لم يتورعوا عن استهداف الكنائس، والكهنة، والراهبات، بل وحتى المقابر المسيحية.
وفي أزقة البلدة القديمة، رأيت بأمّ عيني أعدادًا كبيرة من المستوطنين المسلحين، يحملون أسلحة نارية، بعضها بنادق هجومية نصف آلية، وغالبًا ما كانوا يستعرضون أو يلوّحون بها، فقد كان المشهد صادمًا، ليس فقط لزائر أجنبي، بل لأنه يعبّر عن واقعٍ أمنيٍّ مفروض بالقوة على سكانٍ أصليين في مدينتهم.
ولا يقتصر نهج دولة الاحتلال في قمع الحريات الدينية على المسيحيين وحدهم، فقد مُنع نائب بريطاني كان برفقتنا من المرور عبر إحدى بوابات البلدة القديمة، سُئل مباشرة عمّا إذا كان مسلمًا، وعندما أجاب بالإيجاب، رفض جيش الاحتلال السماح له بالدخول صراحةً على هذا الأساس، وفي المقابل، لم أُسأل عن ديانتي، وسُمح لي بالعبور، في مثال فاضح على التنميط الديني والعنصري.
رأيت الأساليب نفسها التي تُستخدم لترهيب المصلّين في الكنائس تُطبّق أيضًا في المساجد، ففي الحرم القدسي الشريف، كان مستوطنون متطرفون يجوبون المكان، مردّدين أهازيج تدعو إلى إقامة “الهيكل الثالث” مكان المسجد الأقصى، فيما كان جيش الاحتلال يفرض إجراءات تفتيش واستجواب ممنهجة على المصلّين المسلمين عند مداخل الحرم.
قد يكون من المخزي أن يتعرّض الزوار المسيحيون والمسلمون لهذا النوع من المعاملة المهينة، لكن ما لا يُغتفر حقًا هو أن يعيش الفلسطينيون هذا القمع يومًا بعد يوم، في أرضهم، وبلا أي أفق للإنصاف.
نضال مشترك
في بيت لحم، كانت الصورة أكثر كثافة من حيث الدلالة، فالجدار العنصري الذي بنته دولة الاحتلال يطوّق المدينة بالكامل، محوّلًا إياها إلى جيبٍ معزول، هذا الطابع العسكري الصارخ سيفاجئ بلا شك كثيرًا من المسيحيين الغربيين، الذين لا يرون في بيت لحم سوى صور المهد على بطاقات الميلاد، بعيدًا عن واقع الحواجز والأسلاك والخرسانة المسلحة.
ولعلّ هذا التناقض سيكون صادمًا على وجه الخصوص لأنصار “الصهيونية المسيحية”، الذين يختارون الاصطفاف إلى جانب دولة الاحتلال، بدل التضامن مع مسيحيي فلسطين الذين يتعرّضون للاضطهاد بسبب إيمانهم وهويتهم الوطنية.
ومع ذلك، وكما علّم الفلسطينيون العالم دائمًا، بقي هناك بصيص أمل حاضرًا، ففي بيت لحم، يقف مسجد عمر إلى جوار كنيسة المهد، المشيّدة فوق الموقع الذي يُعتقد أنه شهد مولد السيد المسيح.
لقد بُني المسجد على أرض أهدتها الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية في القدس، وسُمّي تيمنًا بالخليفة عمر بن الخطاب، تكريمًا للحريات الدينية التي منحها للمسيحيين واليهود في القدس وبيت لحم، وقبل ظهور الكهرباء، كان المسيحيون والمسلمون على حد سواء يقدّمون زيت الزيتون لإضاءة المسجد.
في هذه التفاصيل الصغيرة، تتجلّى قصة فلسطين الحقيقية: شعبٌ لم تفرّقه الأديان، بل جمعته معركة واحدة ضد محو الهوية الفلسطينية، إنها قصة تعكس التاريخ المشترك للأديان الإبراهيمية في هذه الأرض، تاريخًا من التعايش والتكامل.
على النقيض من ذلك، تقوم أيديولوجيا الصهيونية السياسية على إنكار هذا الإرث المشترك، وتمزيق القيم الإنسانية الجامعة التي تشكّل جوهر اليهودية والمسيحية والإسلام على حد سواء.
فالمشكلة لم تكن يومًا بين الأديان، ولن تكون، بل إن المشكلة تكمن في سياسة دولة الاحتلال المنهجية في اضطهاد الفلسطينيين، في مسعى مستمر لاقتلاعهم من أرضهم، ومحو وجودهم وهويتهم الوطنية من وطنهم التاريخي.
للاطلاع على المقال الأصلي من (هنا)