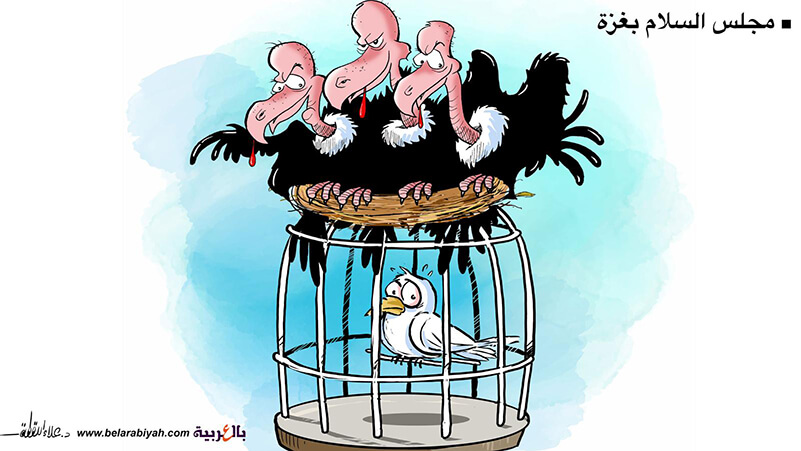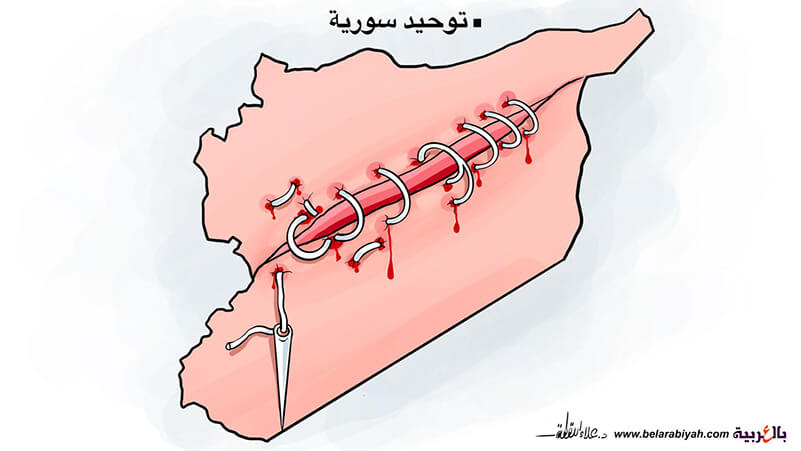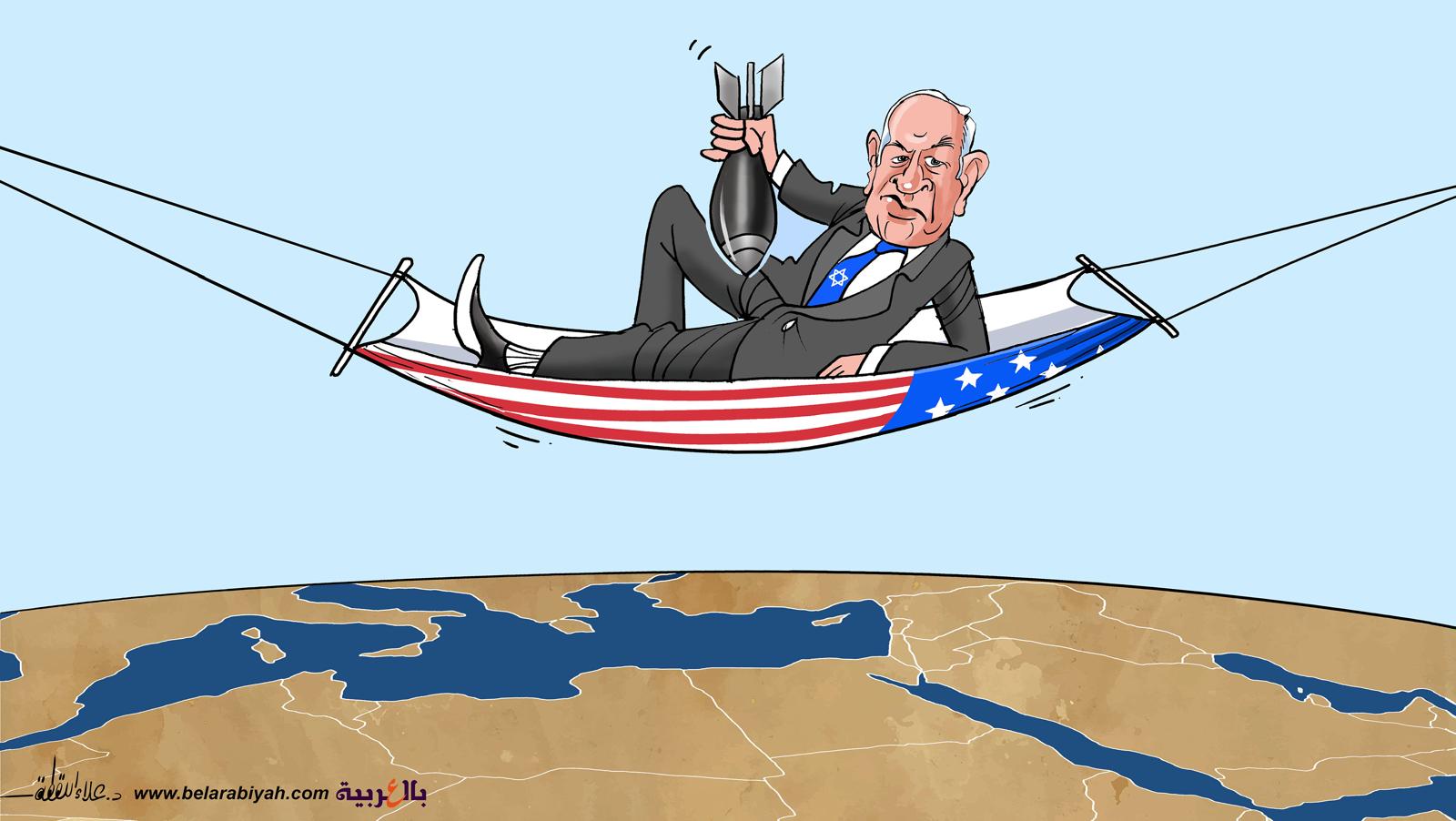بقلم لورينزو فزرولاني
ترجمة وتحرير مريم الحمد
لقد مرت 45 سنة منذ أن نشر المفكر الفلسطيني الراحل، إدوارد سعيد، كتابه “الاستشراق” عام 1978، فقد كان الكتاب بمثابة اختراق للمفهوم الغربي غير الواضح لـ “الشرق”، والذي يمتد جغرافياً ليشمل آسيا حتى شمال إفريقيا.
في الكتاب، يقدم سعيد إطاراً منهجياً يحلل من خلاله الأساطير والصور النمطية التي تم رسمها عن الشرق في الخطابات والإعلام وحتى بالعالم الأكاديمي في الغرب، والتي كانت مهيمنة لفترة زمنية طويلة.
بعد عقود من الزمن، لاشك أن وعياً أكبر بالضرر الذي تسببه تلك الصور النمطية، خاصة تلك التي تضع الإسلام في مواجهة مع الغرب، قد نما، وصار “يُنظر لها على أنها خطاب قوة نشأ في عصر الاستعمار” بحسب سعيد، غير أن ما حصل مرة أخرى بعد أحداث 11 سبتمبر، من نشر للخطابات العنصرية والمعادية للإسلام من أجل تبرير الحروب الإمبريالية، يثبت أن الكثير لم يتغير على الأرض!
ثنائية الشرق والغرب
الاستشراق كمفهوم هو بالأساس نقد التنميط الأوروبي الجوهري لـ “الشرق”، وهو تنميط يميل إلى الحكم على الثقافات الأخرى باعتبارها ثابتة متجانسة، بدلاً من كونها دائمة التغير، ولا أدل على ذلك من سيولتها في ظل العولمة، ويعد الاستشراق أيضاً بمثابة تحليل للعلاقة المتناقضة بين المعرفة والسلطة، أو التقاليد المؤسسية في الفكر الاستشراقي والإمبريالية، بشكل يتم فيه تطبيق الأول في خدمة الامبريالية.
يستشهد سعيد ، في سياق شرحه للكيفية التي يوفر فيها الاستشراق أساساً ايديولوجياً للهيمنة الغربية على الشرق، بتحليل خطاب ميشيل فوكو، فهو يرى أن دراسة تأثير الاستشراق كخطاب أمر بالغ الأهمية، يساهم في فهم السبب وراء تمكن الغرب من إدارة الشرق في فترة ما بعد التنوير في أوروبا.
ينقل سعيد تعريف فوكو لمصطلح ” الخطاب”، حيث يرى الأخير أنه “نظام فكري تاريخي ينتج المعرفة والمعنى”، ويتم إنتاج ذلك الخطاب من خلال تشكيل فهم جمعي لحقائق اجتماعية يتم تطويرها في فترة تاريخية معينة، وتتشكل من خلال أنظمة السلطة، فهي التي تخلق قواعد الحقيقة والمعرفة!
ومع تحول السلطة العالمية نحو الغرب في القرن 17، انتشر الخطاب الاستشراقي القائم على “الآخر” من الناحية الثقافية و”التمييز بين الشرق والغرب” كتصنيف يعكس مواقف الاستعمار الأوروبي، فيتم تحليل “الشرقي” دائماً من خلال عدسة الباحث “الغربي”، الذي لا يراه مكافئاً له.
يقول سعيد في هذا أن “جوهر الاستشراق هو التمييز الذي لا يمكن إزالته بين التفوق الغربي والدونية الشرقية”، حيث يعتمد الخطاب الاستشراقي على منطق ثنائي، تدعمه جغرافية مصطنعة يمكن التعبير عنها بالقول، “نحن وهم”، كتعريف ثابت للآخر يجعل من “الشرق” كل ما لا يمثله الغرب.
بناء الخطاب الاستشراقي
في الأعوام بين 1815 و1914، توسعت مساحة الأراضي الخاضعة للحكم الاستعماري الأوروبي بزيادة تقارب من 30% إلى 85% في جميع أنحاء العالم، كما تم نشر ما يقرب من 50 ألف كتاب عن الشرق الأدنى في نفس الفترة، وبعد غزو نابليون لمصر عام 1798، دخل الاستشراق المرحلة العالمية الحديثة، واتخذ طابعاً علمياً من خلال كتب مثل “وصف مصر” الذي نُشر عام 1809 حتى 1828 على شكل مجلدات متتابعة.
الفراغ الذي صحب نهاية الحرب الباردة تطلب وجود “عدو جديد”، مما تسبب في إحياء المفاهيم الاستشراقية القديمة حول التهديد الإسلامي للحضارة الغربية، نظرية برزت كإطار أيديولوجي واضح للحرب العالمية ضد الإرهاب بعد أحداث 11 سبتمبر
ويعد المؤرخ عبد الرحمن الجبرتي شاهداً على غزو نابليون، كان أول من وصفه بأنه “فتح معرفي وليس عسكري”، وعلى أرض الواقع، فقد كان يرافق القوة العسكرية الفرنسية أو ما يسمى “جيش الشرق” حوالي 160 مستشرقاً، بين مستكشفين وباحثين قاموا بتوثيق ملاحظاتهم “الموضوعية” أثناء الغزو، كما عمل هؤلاء العلماء على تسهيل تدجين المستعمرات المستقبلية بتحيز مؤكد ومعتقدات محددة عن “الشرق”.
في ذلك الزمن، لم يكن الإسلام مشكلة بذاته، ولكن كان يُرى على أنه يعارض المسيحية، حيث تعود تلك الفكرة النمطية إلى الحروب الصليبية وفترة العصور الوسطى عندما كان العالم الإسلامي هدفاً للهيمنة المسيحية الأوروبية، وما كان المستشرقون الذين رافقوا نابليون إلا نتاجاً لتلك العلاقة.
منذ الغزو النابليوني، بدأت تتشكل ملامح الخطاب حول التقاليد الاستشراقية وهو ما تطور لاحقاً على مدى 200 عام بعدها، من خلال جوهر ثقافي مبني على افتراضات ثابتة حول ثقافة متغيرة وقادرة على التكيف في الشرق، حيث عملت تلك الخطابات على وضع أساس لمقاربة من شقين، موقف أبوي من جهة بمنطق “الشرقيون بحاجة إلى مساعدتنا وإرشادنا”، وموقف يميني عنصري بمنطق “الشرقيون أكثر همجية”.
يظهر ذلك الخطاب جلياً في الفصل 34 من كتاب “مصر الحديثة”، المكون من مجلدين عن الاحتلال البريطاني لمصر، ويعتقد أن من نشره كان المندوب السامي إيفلين بارينج أو اللورد كرومر عام 1908، وجاء فيه:
“الأوروبي مفكر وتصريحاته عن الحقيقة خالية من الغموض، يطبق المنطق رغم أنه لم يدرسه، يحب التماثل في كل شيء، وهو بطبيعته متشكك يسعى للبحث عن إثبات قبل أن يتمكن من قبول شيء، أما عقل الشرقي، مثل شوارعه الخلابة، يفتقر إلى التناسق وجسن التفكير، وهو في كثير من الأحيان غير قادر على استخلاص الاستنتاجات حتى من أماكن بسيطة”.
ومن السخرية أن الإعلام الغربي والسياسيين دائماً ما يستحضرون استعارات استشراقية تصور الثقافات العربية والإسلامية على أنها متخلفة وغير قادرة على التغيير، في الوقت الذي يسارعون فيه للدعوة إلى “الاستقرار” و”احتواء المتعصبين”، إذا ما أدت المطالبات بالتغيير السياسي والاجتماعي إلى إثارة حركات جماهيرية في تلك البلدان الشرقية
وفقاً لتحليل سعيد، فقد كان مبرراً أن تقوم الشخصيات السياسية مثل اللورد كرومر بإنتاج تلك التعميمات العنصرية والثقافية، لأن التقليد الاستشراقي الراسخ كان مصدراً لكلام وصور عززت ذلك الخطاب.
لقد دعم الاستشراق فكرة الهيمنة الأوروبية على العالم، حيث تحول بالكامل من خطاب أكاديمي يهدف إلى الاستيلاء النظري إلى أداة إمبريالية تساهم في الاستيلاء الاستعماري.
حرب بين الثقافات
مع نهاية الحرب العالمية الثانية، دخل الفكر الاستشراقي في أزمة، وذلك مع تحول النظام العالمي بظهور الولايات المتحدة كواحدة من أهم القوى العسكرية والسياسية والاقتصادية الجديدة، كما ظهرت حركات التحرر الوطني في مرحلة ما بعد الاستعمار مدعومة بروايات السكان الأصليين التي بددت الأساطير المتأصلة حول “سلبية” الشعوب المقهورة في الشرق.
رغم هذا التحول، فقد واصل بعض المؤرخين الغربيين بممارسة تقليدهم الاستشراقي حول العداء للإسلام ومعاداة العرب والمسلمين، منهم المؤرخ البريطاني هار جيب، الذي نشر كتابه “الاتجاهات الحديثة في الإسلام” عام 1947، وجاء فيه:
“إن العقل العربي، سواء فيما يتعلق بالعالم الخارجي أو فيما يتعلق بعملية التفكير، لا يمكن له التخلص من شعور شديد بالانفصال وعدم الربط بين الأحداث الملموسة، وهذا يفسر، ما يصعب على الطالب الغربي فهمه، وهو بعد المسلمين من التفكير العقلاني”.
وصل هذا التنميط الثقافي الجوهري أوجه عام 1993، مع مقال كتبه صموئيل هنتنغتون تحت عنوان “صراع الحضارات”، مشيراً فيه إلى أن الفراغ الذي صحب نهاية الحرب الباردة تطلب وجود “عدو جديد”، مما تسبب في إحياء المفاهيم الاستشراقية القديمة حول التهديد الإسلامي للحضارة الغربية، نظرية برزت كإطار أيديولوجي واضح للحرب العالمية ضد الإرهاب بعد أحداث 11 سبتمبر.
في نظريته، تأثر هنتنغتون بآراء المستشرقين التقليدية فيما يتعلق بالاختلاف الوجودي بين العالم الإسلامي والغربي، والذي اعتبر أنه سيؤدي لا محالة إلى صراع بين الحضارتين، وتلك مبررات تتجاهل التاريخ المعاصر من آثار الاستعمار والعولمة، فمن الخطأ النظر إلى الاختلافات الثقافية على أنها عقدية، لأنها متغيرة وتتكيف مع الظروف والتأثيرات الإقليمية والدولية مع مرور الوقت.
ولم تسلم الحركات المناهضة للاستعمار، والتي انتشرت في العالم الإسلامي في النصف الأول من القرن 20، من وصف المستشرقين لها بأنها “ظواهر غير عقلانية”، كما واصلت وسائل الإعلام والصحف بالترويج لفكرة أن العرب إرهابيون محتملون، إما كأفراد أو أصحاب نفوذ مالي جمعوا أموالهم عبر الابتزاز على حساب الدول الغربية المتحضرة.
وفي السبعينات، زادت المواقف اللانسانية تجاه “الشرقيين” مع تزايد الطلب على النفط والموارد الأخرى في الغرب، فبعد أزمة النفط عام 1973، بدأ المستهلكون الغربيون في إظهار ما وصفه أستاذ العلوم السياسية المصري، أنور عبد الملك، بأنه “هيمنة الأقليات عبر الامتيازات”.
في الأعمال الأدبية الأوروبية، كثيراً ما يتم تصوير “الشرق” على أنه سمات “أنثوية” نمطية، مثل الإغواء والضعف والخصوبة، وكأن غزوه بالمعنى المجازي يعني الخضوع الجنسي للذكر الغربي!
يعتقد الغربيون، كما يوضح سعيد في كتابه، أنهم يستحقون مستوى معيشي أعلى من نظرائهم في الشرق، كما ينظرون إلى نظامهم الاجتماعي وقيمهم القائمة على الليبرالية والحرية الفردية على أنها معيارية وجزء لا يتجزأ من العالم الغربي، لكن يمكن الاستغناء عنها في العالم الإسلامي الذي يحظى حكامه الديكتاتوريون بدعم دائم ومتواصل من قبل الحكومات الغربية!
ومن السخرية أن الإعلام الغربي والسياسيين دائماً ما يستحضرون استعارات استشراقية تصور الثقافات العربية والإسلامية على أنها متخلفة وغير قادرة على التغيير، في الوقت الذي يسارعون فيه للدعوة إلى “الاستقرار” و”احتواء المتعصبين”، إذا ما أدت المطالبات بالتغيير السياسي والاجتماعي إلى إثارة حركات جماهيرية في تلك البلدان الشرقية.
بدا ملحوظاً إعادة صياغة مفهوم ما يسمى “الاستبداد الشرقي” مؤخراً، من خلال التغطية الإعلامية والتحليلات الغربية للربيع العربي، حيث تم إحياء فكرة أن “العرب غير مؤهلين للديمقراطية” أو أن “حالهم كان أفضل عندما كان يحكمهم دكتاتور”!
الإمبريالية والجندرية
يعد استحضار الصور الجندرية أيضاً من السمات الاستشراقية النموذجية التي تشير إلى الهيمنة الغربية على الشرق، ففي الأعمال الأدبية الأوروبية، كثيراً ما يتم تصوير “الشرق” على أنه سمات “أنثوية” نمطية، مثل الإغواء والضعف والخصوبة، وكأن غزوه بالمعنى المجازي يعني الخضوع الجنسي للذكر الغربي!
تمت دراسة تلك الفكرة التي تمثل العلاقة بين الإمبريالية والنوع الاجتماعي وتطويرها من قبل الباحثين في دراسات ما بعد الاستعمار والجندرية بشكل أساسي، حيث لاحظت
المنظرة الأدبية، غياتري سبيفاك، أن الحركات النسوية الأوروبية، في تعاملها مع النساء غير الغربيات، أعادت إنتاج الأنماط الاستعمارية التي تعود للقرن 19 ، معتمدة على منظورها الشرقي، مثل تصوير الحجاب كرمز لتبعية المرأة المسلمة، ومنعها من تحقيق الاستقلال وتحقيق الذات.
لكن وجهات النظر الاستشراقية هذه، تتجاهل السياقات التي يصبح فيها الحجاب أداة للهوية الفردية، تدافع عنه وتستخدمه نساء يناضلن من أجل العدالة في المجتمعات الغربية والإسلامية على حد سواء.
إنهم يتجاهلون حقيقة أن رئيستي وزراء في بنغلاديش كانا محجبتين، الشيخة حسينة وخالدة ضياء، وهو ما ينطبق أيضاً على رئيسة باكستان بناظير بوتو، والرئيسة التنزانية سامية سولوهو حسن، ورئيسة أندونيسيا السابقة، ميجاواتي نوبوتري، وغيرهن من السياسيات المسلمات حول العالم.
وتتنوع النظرة الغربية للمرأة المحجبة ما بين “ازدراء” و “شفقة” باعتبارها تحتاج إلى “التحرر” الذي يرتبط بشكل مباشر بالتخلي عن ثقافتها الأصلية!
يحذر سعيد في كتابه من الانغماس فيما يسمى “الأصولية العكسية”، أي إنكار واقع المجتمعات المسلمة السلبي من اضطهاد وسوء معاملة المرأة، فليس من العدل تبييض تلك المظالم في سياق النقاش.
لا يزال كتاب “الاستشراق” حتى اليوم مصدرًا قيمًا، ففي نهاية المطاف، يجب أن تستند دراسة البشر على التاريخ والتجربة الإنسانية، في ظل عالم دائم التغير ويزداد تعقيداً وترابطاً، وليس على تصورات قديمة بالية، أو قوانين غامضة أو أنظمة تعسفية
في التسعينيات، كانت الجماعة الإسلامية، وهو الحزب الإسلامي الرئيسي في باكستان، الحزب الوطني الوحيد الذي لم يتحفظ على فكرة وجود رئيسة للوزراء، في السودان، كان الزعيم الإسلامي الراحل حسن الترابي، أول من أيد فكرة إمامة المرأة للصلاة، ومشاركتها في الساحة السياسية، وجعل الحجاب اختيارياً، وفي تونس عمل الحزب الإسلامي على تعزيز مشاركة المرأة في البرلمان.
استشراق عكسي!
رغم رفض سعيد صراحة للخطاب “الاستغرابي”، إلا أن عدداً من المثقفين المسلمين أساؤوا فهم رسالة كتابه، وأشدوا به على اعتبار أنه دفاع عن الشرق وهجوم على الغرب، وهذا الأمر الذي أدى إلى ظهور ما أسماه الفيلسوف السوري، صادق جلال العظم، “الاستشراق العكسي”، يعني موقفين متناقضين ولكن ينطلقان من ذات الفرضية!
الموقف الأول هو “الكومبرادور الفكري”، وهو فرد يولد في دولة ذات أغلبية مسلمة ويسعى إلى الحصول على التقدير في الغرب المليء بالتحيزات الاستشراقية، حيث ينتهي به الأمر إلى استيعابها، ليحصل على الفرص المهنية المرموقة ويروج للصور النمطية الضارة عن الدين وأتباعه، فعلى حد قول عالم النفس، أسيس ناندي، فإن “الاستشراق موجود في كل مكان، في الهياكل وفي التفكير، ويتغلغل في المؤسسات والأنظمة الفكرية في البلدان المستعمرة السابقة”.
أما الموقف الثاني فهو الأصولي الذي يتبنى الموقف العكسي المتمثل في كون “الشرق” مغايراً لكل ما عليه الغرب، حيث يصور علماء ومفكرون مسلمون مثل أبو العلاء المودودي وسيد قطب الغرب على أنه كتلة متراصة عرضة للفساد والمادية والانحطاط الأخلاقي.
ويرى سعيد أن الفرق الرئيسي بين الأصوليين والمستشرقين يكمن في مفهوم “الهيمنة”، فالأول يتبنى مواقف كرد فعل على قرون من القهر، والثاني نتيجة قرون من الهيمنة.
ولا يزال كتاب “الاستشراق” حتى اليوم مصدرًا قيمًا، ففي نهاية المطاف، يجب أن تستند دراسة البشر على التاريخ والتجربة الإنسانية، في ظل عالم دائم التغير ويزداد تعقيداً وترابطاً، وليس على تصورات قديمة بالية، أو قوانين غامضة أو أنظمة تعسفية.
للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)