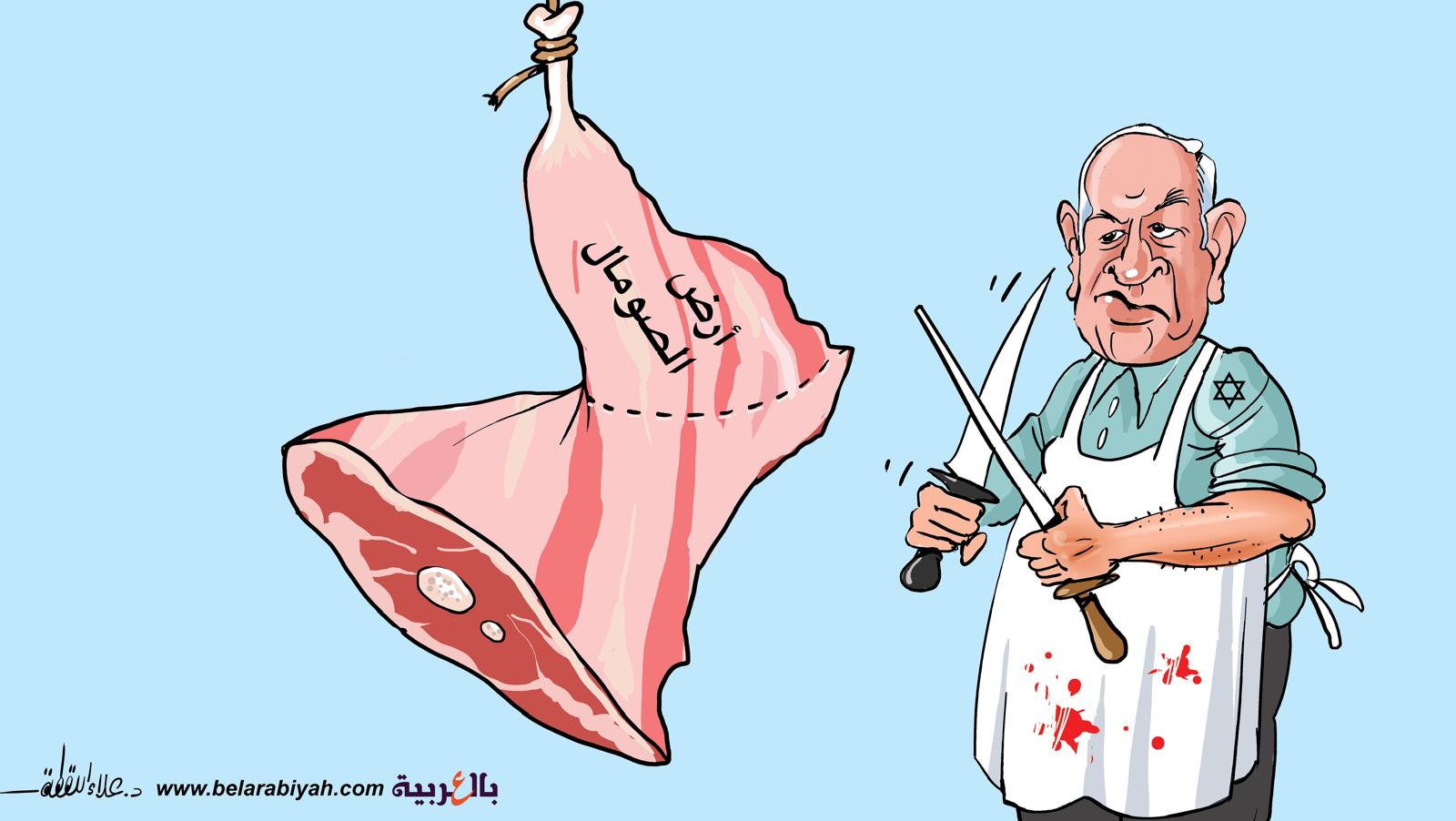بقلم سارة الخطيب
ترجمة وتحرير نجاح خاطر
بعد أكثر من عامين على حرب الإبادة التي شنتها دولة الاحتلال على غزة، أُعلن عن وقفٍ هشّ لإطلاق النار في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2025.
ورغم خروقات جيش الاحتلال المستمرة، فإن فترات الهدوء القصيرة سمحت للفلسطينيين ببدء جهود إنقاذ محدودة، وفتح نقاش طال انتظاره حول ما يجب القيام به بعد مرحلة الإغاثة العاجلة.
خلال الأسبوع الأول فقط من الهدنة، انتشلت طواقم الدفاع المدني في غزة 436 جثمانًا من تحت الأنقاض، في حين أعادت دولة الاحتلال 195 جثمانًا، لم يُعرَف أصحاب سوى 57 منها.
ومع غياب أي تجهيزات جنائية في القطاع، يُدفن كثير من الشهداء بلا أسماء، تاركين عائلاتهم في دوامة من القلق والحزن المعلّقين.
قد يبدو هذا التحدي لوهلة مشكلة لوجستية، إلا أن تداعياته أعمق بكثير، فدمار القدرات الجنائية في غزة يعني أن قرابة 10 آلاف جثمان لا تزال تحت الركام قد لا تُعرّف هويات أصحابها أبدًا، ولا يُحصَون ضمن سجل العدالة أو الذاكرة.
وفي الوقت الذي دخلت فيه فرق دولية للبحث عن رفات الأسرى الإسرائيليين، لا تُبذل أي جهود موازية للتعرف على آلاف الفلسطينيين الذين قضوا، هذا الفارق الفادح في التعامل يكشف خللًا أخلاقيًا عميقًا، يحدد من يُعترف بإنسانيته ومن يُترك للنسيان.
إن غياب القدرة على تسمية الشهداء ودفنهم بما يليق بهم يسرق من العائلات حقها في الوداع، ويحرم الأحياء من أبسط مقومات التعافي النفسي، إنه حزن لا ينتهي، ينتقل من جيل إلى جيل، ويترك فراغًا يعطّل أي إمكانية للتعافي أو العدالة.
أهمية تسمية الشهداء
أظهرت تجارب بلدان خرجت من مجازر جماعية أن التعرف إلى جثامين الضحايا شرط أساسي للتعافي، ففي البوسنة والهرسك، لا تزال رفات الضحايا تُكتشف سنويًا وتُدفن في ذكرى الإبادة في سربرنيتسا، وبعد نحو ثلاثين عامًا، لا يزال مئات المفقودين بلا أثر، ما يعوق تعافي عائلاتهم ومجتمعاتهم.
وخلال السنوات الأولى بعد الحرب هناك، جُمعت صور المتعلقات الشخصية والملابس الملتقطة من المقابر الجماعية في كتاب ضخم، ما يزال حتى اليوم أداة يستخدمها الأهالي للبحث عن أحبّتهم.
ويذكّر هذا العمل المؤلم بأن غياب التعرّف على الضحايا يجعل الحداد ناقصًا، والعدالة مبتورة، والذاكرة مثقلة بصمتٍ موجع.
وتشدد القوانين الدولية ومنها اتفاقيات جنيف على ضرورة إعادة الرفات، لكنها تترك الأمر فضفاضًا ومشروطًا باتفاق بين الأطراف، كما حدث في تبادل الرفات بين مصر ودولة الاحتلال في 1975-1976.
وتؤكد الأدلة العسكرية العالمية أن هذا الالتزام يشمل المتعلقات الشخصية أيضًا، تقديرًا لحق العائلات وواجب تحقيق العدالة.
غياب الطب الشرعي في غزة
تبدأ تسمية الشهداء بانتشال جثامينهم ثم التعرّف عليها، لكن الحصار المشدد على غزة يعرقل الخطوتين، إذ تمنع دولة الاحتلال دخول الأجهزة والكوادر المتخصصة.
وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، قد تستغرق عملية انتشال الجثامين ثلاث سنوات باستخدام الأدوات البدائية المتوفرة حاليًا.
وكلما طال أمد بقاء الجثامين تحت الأنقاض أو دُفنت في مقابر جماعية، تزداد صعوبة التعرف عليها، إذ تتسارع عملية التحلل وتتدهور جودة الحمض النووي، كما تتداخل الأشلاء وتتآكل العناصر العظمية، ما يُعقّد التحليل الجنائي.
ومع دخول فرق جنائية دولية، تركية وقطرية ومصرية، للبحث عن رفات الأسرى الإسرائيليين، لا يُظهر العالم أي استعجال موازٍ للتعرف على آلاف الفلسطينيين.
ويعكس هذا التجاهل درجة القسوة نفسها التي سمحت بقتل أكثر من 70 ألف فلسطيني خلال الحرب، بينهم ما لا يقل عن 20 ألف طفل.
التعافي وإعادة الإعمار
لا يمكن فهم إعادة إعمار غزة على أنها إعادة بناء البنية التحتية فقط، بل هي مشروع يتطلب إعادة ترميم الإنسان أولًا عبر الاعتراف بمعاناته، وتثبيت روايته، وصوغ طريق نحو التعافي يتجاوز مجرد النجاة الجسدية.
ومع وجود آلاف الجثامين المجهولة، يبقى التعافي معلّقًا، والعدالة ناقصة، والثقة الجماعية مكسورة.
إن تسمية الشهداء وإعادة الرفات إلى ذويهم ليست مجرد طقوس دفن، بل ركيزة من ركائز الذاكرة والعدالة والتعافي الاجتماعي.
تُظهر تجارب ما بعد النزاعات، من البوسنة إلى رواندا، أن دفن الشهداء بعد التعرف عليهم يمثّل لحظة تأكيد جماعية للحقيقة، ويمنح الناجين نقطة بداية في مسار شاق طويل نحو التعافي.
وفي الحالات التي يُحرم فيها المجتمع من هذه الخطوة، تتضاعف الصدمات، ويصعب ترميم السردية الجماعية، ما يسمح لطبقات من الألم غير المعالج بالانتقال عبر الأجيال.
وهذا تمامًا ما عاشه الفلسطينيون منذ نكبة 1948، حين مُنع كثيرون من العودة إلى قراهم لاستعادة جثامين أحبّتهم، فبقيت ذكرياتهم معلّقة، وجراحهم مفتوحة.
واليوم يُعاد إنتاج السيناريو ذاته في غزة، حيث تتضافر الحرب والتهجير والحصار لحرمان الناس من حق الدفن والوداع.
بدائل اجتماعية
وفي ظل غياب الفرق الجنائية، ظهرت مبادرات مجتمعية متواضعة لكنها حيوية، فالمؤرخون المحليون، وأصحاب المبادرات الشعبية، وأرشيفات العائلات يعملون على حفظ الأسماء والذكريات والمتعلقات.
ووفق ما ذكره الدكتور محمد الزقّوت، مدير عام المستشفيات في غزة، ستُعرض صور الجثامين والمتعلقات الشخصية حتى يحاول الأهالي التعرّف على ذويهم.
وفي خيام أقيمت لهذا الغرض، تُظهر فيديوهات مؤلمة عائلات تنقّب بين صور الأجساد المتحللة، باحثة عن شامة أو أثر إصابة قديمة أو قطعة ملابس، إنها محاولات موجعة، لكنها ضرورية في مواجهة ما وصفه خبير الطب الشرعي الكندي مايكل بولانين بـ”الطوارئ الجنائية الدولية”.
ومع ذلك، تبقى هذه البدائل محدودة، لا تعالج عمق الأزمة، ولا تعوض غياب المنهجية العلمية التي تتطلبها عمليات التعرّف على الضحايا.
وختاماً، فإن إعادة الإعمار في غزة يجب أن تمتد إلى ما هو أبعد من الحجر والإسمنت، يجب أن تشمل إعادة بناء الذاكرة والعدالة والكرامة، فلا مجتمع قادر على النهوض دون أن يكرّم شهداءه، ويعيد لهم أسماءهم، ويمنح ذويهم فرصة الوداع.
إن طمس الهويات أو تأجيل التعرّف عليها خطرٌ لا يهدد الحاضر فقط، بل يقوّض أي إمكانية للمصالحة، ويترك جروحًا عميقة تنتقل عبر الزمن.
المجتمعات التي تفشل في الاعتراف بموتاها تحمل عبء ألم غير محسوم، وتبقى خطواتها نحو المستقبل مثقلة بالظلم الذي لم يُصحَّح، أما غزة، فلكي تبدأ رحلة التعافي، لا بد أن تستعيد أسماء من فُقدوا، لأن الشفاء يبدأ من الذاكرة.
للاطلاع على المقال الأصلي من (هنا)