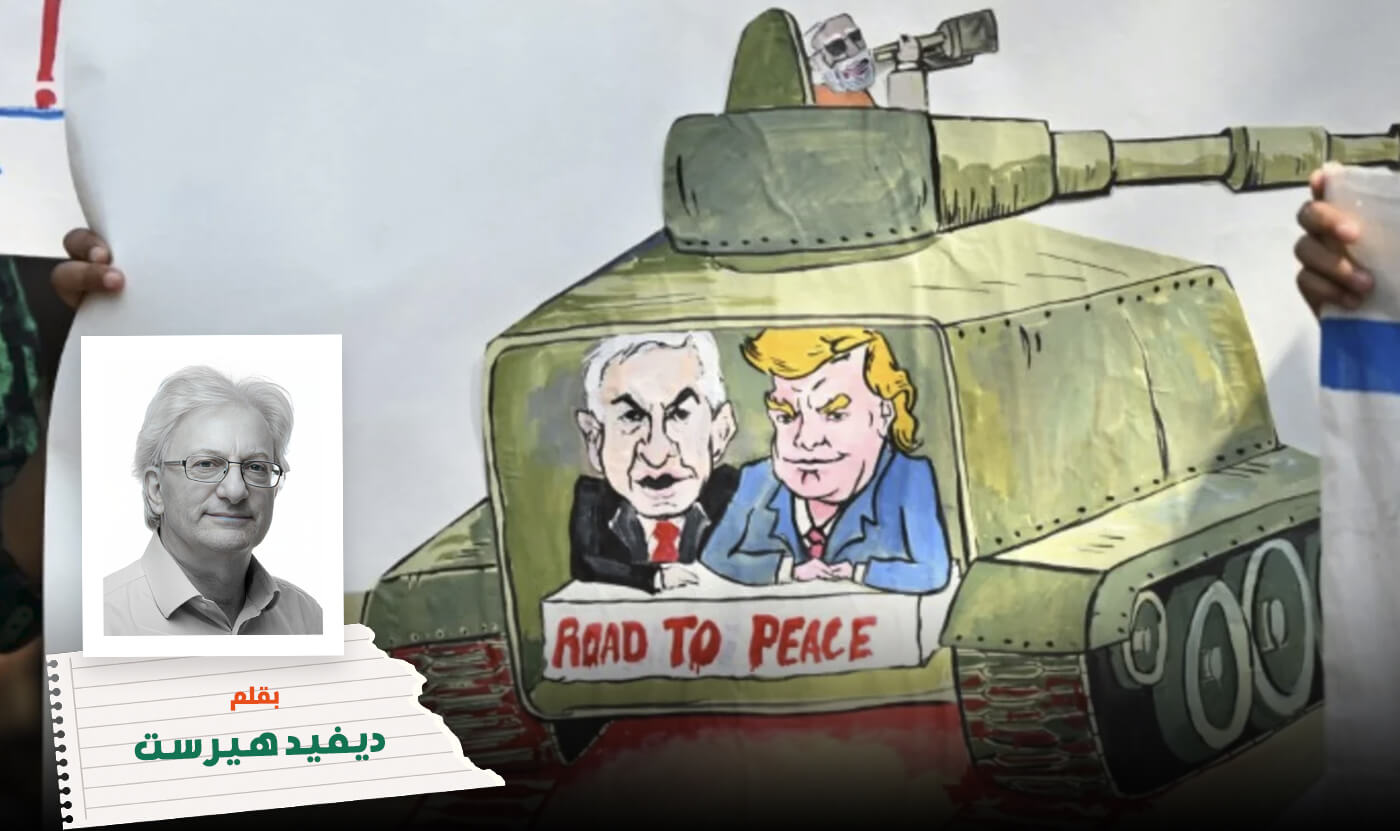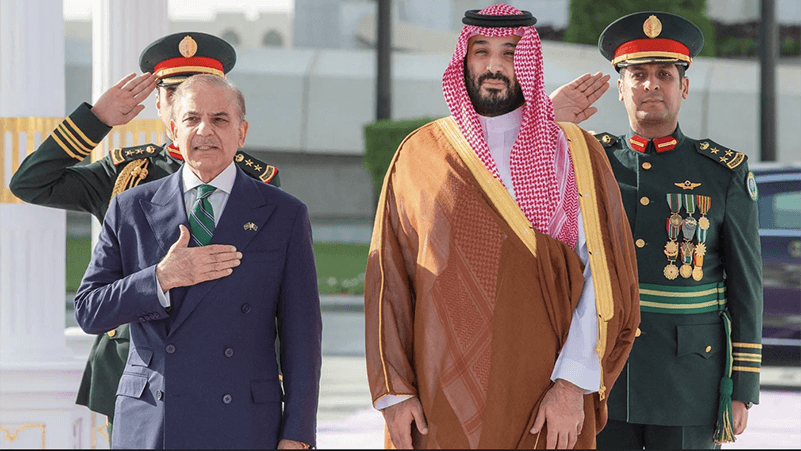بقلم لينا منذر
ترجمة وتحرير نجاح خاطر
كنت أحتسي قهوتي الصباحية في مونتريال عندما تلقيت الخبر، لقد أرسل لي صديقي رامي رسالة على تطبيق واتساب جاء فيها باللغة العربية: “الأوزاعي، الغبيري، صفير، حارة حريك، صيدا، أجهزة النداء تنفجر، اختراق، لقد اخترقوا الهواتف الخلوية وفجّروها، هناك الكثير من المعلومات المتناقضة، وحوالي 500 انفجار حتى الآن”.
في بيروت، كانت الساعة قد تخطت بقليل الثالثة وأربعين دقيقة بعد الظهر، ولا داعي للسؤال عمن “هم”؟ إنهم نفسهم الذين كانوا يبيدون ويجوعون الفلسطينيين في غزة منذ ما يقرب من عام كامل، وهم الذين قصفوا المستشفيات ومخيمات اللاجئين، وهم الذين اغتصبوا الأسرى، ثم عندما تعرضوا للعقاب على ذلك، قاموا بأعمال شغب مطالبين بالحق في اغتصاب الأسرى.
“هم” الذين يحاكمون أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، والذين انتهكوا أمام الكاميرات الخطوط الحمراء المزعومة للقانون الإنساني الدولي.
بعد كل هذا، لا ينبغي لي أن أستغرب أي شيء قد يكونون “هم” قادرين على فعله، ولا كيف سيعذرهم العالم، ومع ذلك، بدأت أتلقى مقاطع فيديو جعلتني غير قادر على تصديق ما رأته عيناي، كانت اللقطات ترد من كاميرات المراقبة المثبتة في متاجر البقالة، حيث تنفجر الأجهزة على خواصر الناس أو في أيديهم، وكانت الشوارع مزدحمة بسيارات الإسعاف والناس الذين يصرخون، وكان الرجال يحملون على النقالات، وبقايا أيديهم الممزقة تنزف دماً.
ما هذا الكابوس المرعب؟ كيف تمكنوا من اختراق أجهزة المستخدمين؟ وما هي الأجهزة المعرضة للخطر؟ أحاول أن أتذكر من أين اشتريت هاتفي؟ هل كان من أحد مراكز بيع الهواتف المحمولة في بيروت، حيث تضرب الانفجارات الآن مشعلة البضائع؟ أم أنني طلبته مباشرة من الخارج؟ هل هو آمن أم مشتبه به؟
لا يهم، يجب أن ألتقط هاتفي، هذا السلاح المحتمل للقتل، لأتصل بأصدقائي وعائلتي، للتأكد من أنهم بخير، وهذا سيجبرهم أيضاً على التقاط سلاح قاتل محتمل للرد.
“أجهزة النداء التابعة لحزب الله”
كان هذا الجهاز يستخدم للاتصال بنا لكنه الآن الشيء الذي يجعلنا نخاف من الاتصال، فهل يبدو مستوى جنون العظمة سخيفاً؟ ليس سخيفاً مثل وقوع عدة آلاف من الانفجارات الصغيرة في جميع أنحاء لبنان في يوم واحد، ثم عدة مئات أخرى في اليوم التالي.
وقبل أن تتضح التفاصيل حول ما جرى بلغ الرعب الذي تسبب فيه استخدام الأجهزة الإلكترونية المنزلية العادية مستوى جعل الناس يسارعون إلى الخروج من منازلهم وفصل بطاريات أجهزة الطاقة وإيقاف تشغيل أجهزة مراقبة الأطفال، في الواقع لم تخترق إسرائيل هذه الأجهزة بما فيها أجهزة النداء، وأجهزة الاتصال اللاسلكية، والألواح الشمسية التي انفجرت على مدى يومين، فقتلت 39 شخصاً وأصابت أكثر من 3250 آخرين، ولكنها اعترضتها وزرعت فيها المتفجرات.
الأمر الأكثر عبثية هو أن أي جهة مرجعية غربية لم تطلق على هذا العمل الإرهابي الجماعي اسمه الحقيقي، وبدلاً من ذلك، أطلقوا على هذه الانفجارات التي تجاوز عددها 4000 انفجار اسم “الهجمات المستهدفة”، وأطلقوا على هذه الأجهزة، التي يستخدمها الأطباء ورجال التوصيل وغيرهم من المهنيين، اسم “أجهزة النداء التابعة لحزب الله”
أكثر من أربعة آلاف انفجار، وقعت في مختلف أنحاء البلاد على مدى يومين، أشعلت شرارة الاحتراق في أجساد الناس، وكان بعض هؤلاء الناس أطفالاً صغاراً، أو في منازلهم مع أطفال صغار، أو في متاجر البقالة أو الصيدليات أو يقودون سياراتهم على الطرق السريعة، فخرجت سياراتهم فجأة عن السيطرة.
لقد غُمرت المستشفيات في مختلف أنحاء البلاد، حيث شهدت بالجرحى الذين تدفقوا بأعداد أكبر من الذي شهدته أثناء انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب 2020، حيث وصف جراحو الصدمات الإصابات بأنها “لا تشبه أي شيء رأوه من قبل، وخاصة العيون والأيدي الجريحة، نتيجة نظر المرضى إلى أجهزة النداء الخاصة بهم قبل انفجارها”.
لقد تم التعامل مع هذا التكتيك السادي غير المسبوق، المصمم للتسبب في إصابات تغير الحياة، على أنه “رائع” ووصف بأنه “دقة مستهدفة”.
جحافل من الأجساد بلا وجوه
لم ترفض وسائل الإعلام الغربية تسمية هذا بالإرهاب فحسب، بل إنها بالكاد كانت قادرة على احتواء تشويقها للمشهد.
حتى المواقع الإعلامية التي نشرت قصصاً تذكر معاناة المدنيين اللبنانيين، أو الإرهاق الذي يعاني منه القطاع الصحي، نشرتها جنباً إلى جنب مع مقالات أخرى تمجد “الجرأة” و”التطور” و”الاستعراض اللافت للنظر للبراعة التكنولوجية الإسرائيلية”.
بل إن عدداً لا يحصى من المعلقين على وسائل التواصل الاجتماعي شبهوا هذه الانفجارات مبتهجين بفيلم هوليوودي وهم على حق، ولكن ليس “التجسس” هو ما يجعل الأمر أشبه بفيلم هوليوودي، بل إن الأمر يتعلق بحقيقة وجود جحافل من الأجساد بلا وجوه يمكن ذبحها دون تفكير ثانٍ، وقتلها جماعياً وسط هتافات الجماهير المنتصرة.
إن هؤلاء الذين قتلوا ليسوا أفراداً، يشكلون نجماً منفرداً في كوكبة من العلاقات، والذين يغير رحيلهم من مدى خطورة الرقعة المحيطة بهم من الكون.
لا، إنهم “كومبارس”، لا يستحقون حتى أي ذكر في التترات الختامية للفيلم، ولا يمر موتهم دون رثاء، بل يتم الاحتفال به علناً، هذه هي الحقيقة السياسية التي تعكسها وتحافظ عليها هوليوود ووسائل الإعلام الغربية أيضاً، وهي الحقيقة التي تعتبر الإرهاب جريمة لا يحكم عليها الفعل بل الفاعل.
لقد كافحت لفترة طويلة لأعبر للناس، الذين لا يعرفون ذلك عن كثب، عن الشعور المذهل الذي ينتابك عندما تشاهد من الخارج بلدك وهو يدمر والطريقة التي يتفاقم بها الشعور بالعجز بسبب التنافر المعرفي، حيث يكون جسدك في مكان ما، محاطاً بأمان عالم ما بينما يركز وعيك بشكل مفرط على رعب عالم آخر.
يسأل الناس ذوو النوايا الحسنة: “ألا تشعر بالامتنان لأنك لست هناك الآن؟” وهو سؤال أجد أنه من المستحيل الإجابة عليه، لقد كنت هناك فقط، قلقاً بشأن ما إذا كان المطار سيغلق قبل إقلاع طائرتي، متعاطفاً مع الأصدقاء بشأن القلق المستمر، وأحياناً يتصاعد الأمر إلى الرعب الصريح الذي نعيشه منذ أكتوبر/تشرين الأول.
اختيار صارخ
سأكون كاذبةً إذا لم أقل إنني ممتنة لخروجي سالمة، ولكني سأكون كاذبة أيضاً إذا لم أقل أنني أتمنى لو كنت قد عدت إلى بيروت، لأنني الآن، بعد أن أُرغِمت، لأول مرة في هذه الحرب، على النظر إلى أحداثها في المقام الأول من خلال الفلتر المشوه لوسائل الإعلام الغربية، أصبح من الأسهل بالنسبة لي أن أعبر عن مدى صعوبة الابتعاد عن بيروت.
إن التنافر المعرفي الناتج عن التواجد في الغرب بينما يحترق الشرق لا يتلخص ببساطة في عدم التوافق بين مكان جسدك ومكان عقلك، بل يتلخص في التواجد في مكان تصر كل مؤسسة محترمة فيه على أن هذا الحرق صحيح وجيد، بغض النظر عن مدى وحشيته أو همجيته.
وليس هناك ما هو أكثر تنافراً من وجود لغة مطهرة لوسائل الإعلام الغربية بيني وبين التجربة الحسية التي أعرف أن الناس هناك يمرون بها.
على الأقل عندما أكون هناك، لا أضع إنسانيتي موضع تساؤل ولا أشعر بالغربة عن أي شعور قد ينتابني، سواء الخوف أو القلق أو حتى الحزن.
كل هذا ينعكس ويؤكده العالم المحيط، فلا أحد بلا وجه أو قابل للتضحية به، ولا أحد بلا ماض أو أحباء، وحتى الحجارة التالفة لها تاريخ، وهناك قدر كبير من الراحة النفسية في هذا الأمر إلى الحد الذي يجعل المرء يميل في كثير من الأحيان إلى استبدالها بالسلامة الجسدية
ولا يوجد أي تراجع على الإطلاق في هذا التنافر الذي يلوح في الأفق، ففي اليوم الذي بدأت فيه محاولة وضع الكلمات للتعبير عن رعب الأحداث الأخيرة، نفذت إسرائيل “ضربة جوية مستهدفة” في ضاحية حارة حريك في بيروت، مما أدى إلى انهيار مبنيين سكنيين، واستشهاد 45 شخصاً وإصابة 66 آخرين، وجعل الحرب الإقليمية تبدو أكثر حتمية.
لقد دخلنا يوم الاثنين في حرب شاملة، حيث تم تدمير جنوب وغرب لبنان بشكل خاص وسط خسائر هائلة، فقد استشهد بالفعل 274 شخصاً وأصيب ألف آخرون.
وتقوم إسرائيل بتطبيق نموذج غزة بسرعة، فتقصف سيارات الإسعاف، والطرق المؤدية إلى المستشفيات، وتأمر الناس “بالإخلاء”، ثم تقصف الطرق التي قد تسمح لهم بذلك، وفي الوقت نفسه تستمر الأسلحة في التدفق عليها.
وقد تم بالفعل تقديم الأعذار وقبولها كما كانت الحال طيلة عام كامل.
وكما أن الجميع في غزة من حماس، فإن الجميع في لبنان من حزب الله، وبالتالي فإنهم أصبحوا هدفاً مشروعاً.
لقد تحقق الكابوس الذي كنا نتوقعه جميعاً طيلة عام كامل، إنه الكابوس الذي كان بوسع أي شخص أن يتوقع حدوثه، والذي كان من الممكن أن يتوقف في أي وقت قبل هذا.
إنني عاجزة عن فعل أي شيء سوى مشاهدة الأخبار، ولا أعرف متى أو ما إذا كنت سأتمكن من العودة إلى بيتي في بيروت.
لقل أصبح الاختيار صعب للغاية بالنسبة لنا نحن المحظوظين الذين تمكنوا من العودة إلى بيتهم، ولكننا نواجه خياراً صعباً، وكما قال أحد الأصدقاء الأعزاء الذي يعيش في الولايات المتحدة منذ عدة سنوات: “إما أن أكون في النيران أو في المكان الذي يشعل تلك النيران”.
للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)