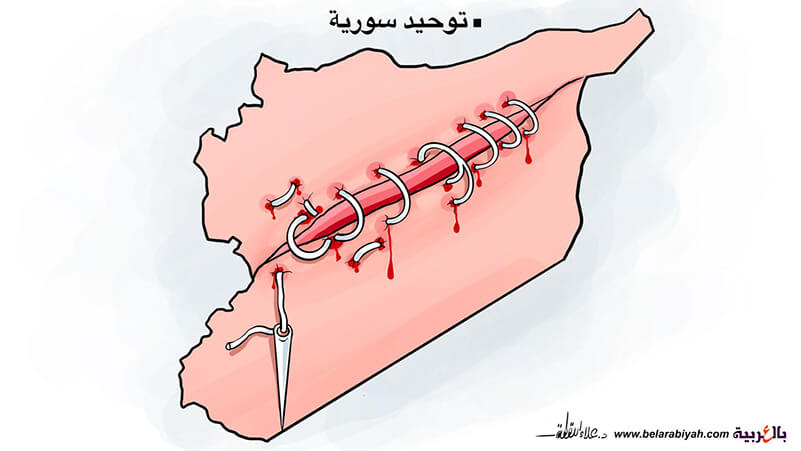بقلم يوسف الجمل
ترجمة وتحرير نجاح خاطر
في تمام الساعة 5:10 صباحاً من يوم 27 سبتمبر/أيلول، استيقظت في شقتي بتركيا، وأنا أشعر بضيق في التنفّس وعطش غريب، كان ينتابني قلق مباغت بلا سبب واضح، التقطت هاتفي لأتفقّد آخر الأخبار القادمة من غزة، فرأيت رسالة في مجموعة الأخبار الخاصة بمدينتي تفيد بأنّ غارة للاحتلال استهدفت منزل عائلتي.
وعلى الفور، بعثت برسالة لأخي عبّود، لكنها لم تصل، وبعد لحظات، اتصلت أمي، التي تعيش قريباً مني هنا في تركيا، كان صوتها يرتجف وهي تسألني إن كنت قد قرأت الخبر، خرجت فوراً من شقتي متوجهاً إلى منزلها، وصدرُي يثقل وكأنّه يغرق في خواء لا نهاية له.
رفضت تصديق أن أسوأ كوابيسي منذ بدء الإبادة في غزة قد أصبح حقيقة، لكن ذلك الشعور بالاختناق كان يزداد عمقاً.
وفي الطريق، اتصلت بصديق من غزة، استطعنا معاً الوصول هاتفياً إلى أختي سارة، مجرد سماع صوتها منحني لحظة خاطفة من الأمل، اعتقدتُ أن عائلتي نجت.
لكن سارة سرعان ما أخبرتني بأنّ عبّود، وزوجته سارة، وابنتيهما هدى وزينب، قد استشهدوا، لقد قتلت الغارة أيضاً أختي غالية، وزوجها يوسف، وابنتيهما مريم وزينب، وكذلك زوج أختي الآخر الدكتور خالد، وأصيبت أختي مريم، واثنان من أطفالها الخمسة بجراح.
لم يدمّر الصاروخ الجدران والأبواب والأرضيات التي نشأت بينها فحسب، لقد هشّم الذكريات التي عاشت داخلها أيضاً، الذكريات التي صنعت منّا عائلة
لم يدمّر الصاروخ الجدران والأبواب والأرضيات التي نشأت بينها فحسب، لقد هشّم الذكريات التي عاشت داخلها أيضاً، الذكريات التي صنعت منّا عائلة
في تلك اللحظة، اجتاحتني موجة حزن عميقة، وخلّفت فراغاً مؤلماً في صدري، وتملّكني شعور بالعجز والذنب، ففي الليلة التي سبقت القصف، أرسلت لي أختي قائمة تضم 24 فرداً من عائلتنا، تنتظر مني المساعدة في إجلائهم.
كانوا يحلمون بالنجاة من الإبادة، وكانوا يريدون أن ينام أطفالهم دون خوف، دون أن يتساءلوا إن كانوا سيستيقظون أم لا، كل ذلك الأمل تبخر في لحظة واحدة، لقد تغيّرت حياتنا إلى الأبد.
عبّود… الركن الذي سقط
كان استشهاد أخي عبّود هو الأكثر إيلاماً، فقد كنّا في العائلة نطلق عليه “بابا عبّود”، لأنه كان يجمع شملنا ويقوينا طوال شهور الإبادة، وحين اشتدّ الجوع، كان يخرج بحثاً عن الطعام، وحين نفد الماء، وجد مورداً آخر، كان يصلح ما يتعطّل، ويمتلك مهارة النجاة.
وفي يوم 26 سبتمبر/أيلول، أرسل لي تقريراً طبياً عن إصابة في كتفه، علّه يدعم طلب إجلائه، لكن ضابطاً في جيش الاحتلال كان قد تسبب في نهاية مختلفة له.
فعند الساعة 4:15 فجراً، أُطلق صاروخ على منزل عائلتنا، أصاب شقّة عبّود في الطابق العلوي، ومنزل والديّ في الأسفل، تسعة من أفراد عائلتي استشهدوا.
كان عبّود يحتضن ابنته زينب (زوزو) عندما تمزق جسده، قُطِع رأسه وقدمه، وانفصلت ذراع زوزو عن جسدها، أما هدى وسارة فقد تمزقتا أيضاً، وعثر المنقذون على أجزاء من جسد سارة فوق سطح منزل مجاور.
وكذلك كان حال أختي غالية، وابنتاها، وزوجها، لقد قُطّعوا واحترقت أجسادهم، وكتب أحد الجيران على وسائل التواصل: “تفقدوا أسطح بيوتكم، قد تجدون بقايا أخرى عند شروق الشمس”.
بيت تحوّل إلى قبر
كانت جثة الدكتور خالد، زوج أختي وطبيب الأطفال الذي كان يحضر لنيل درجة الماجستير، قد اتكأت إلى جدار غرفتي القديمة، تلك الغرفة كانت قد أصبحت مسكنه بعد أن فقد منزله في وقت سابق من الإبادة، لقد أصابته الشظايا من الخلف بينما كان يراجع شرائح طبية، فاستشهد على الفور.
وقبل يوم واحد فقط من استشهاده، أنهى الدكتور خالد توزيع الأدوية على مدارس تحوّلت إلى ملاجئ، ضمن عمله مع وكالة “أونروا”، لقد كان فخوراً لأنه أوصل كل دواء إلى من يحتاجه.
كانت أختي مريم نائمة بجانبه على الأرض، أغمي عليها، وانتشلوها من تحت الأنقاض بإصابة في العين وكسر في الذراع وهي ما تزال تتعافى، أما التوأمان ركان وكنان فقد أصيبا إصابات طفيفة.
لم نكن نتخيّل أن يقدم جيش الاحتلال على قصف بيتنا دون تحذير، وحين وقع القصف، استيقظ أخي إسماعيل ظانّاً أنّ الصاروخ أصاب منزل الجيران، لقد احتاج دقائق ليستوعب الحقيقة.
ففي غزة، كثيراً ما تكون الضربة أهدأ على من يعيش داخل الهدف ممّن يسمعونها من بعيد، وكثير من العائلات عاشت الارتباك ذاته قبل أن تدرك أنّ القصف أصاب منزلها.
كان بيتنا معروفاً بأنه بيت يضج بالأشقاء والأحفاد، لكنه لم يعد الآن كذلك، وها هم الناجون من عائلتي يحاولون ترميم ما يمكن ترميمه من البيت ليعودوا إليه، وهم يقولون: “العيش في البيت أفضل من الخيمة”، لكن عليهم الآن أن يعيشوا في منزل صار مقبرة لإخوتي وأزواجهم وأطفالهم.
أنا لا أستطيع حتى تخيّل ما يعنيه ذلك لهم، ففي غزة، لا يملك الناس سوى الاختيار بين السيئ والأسوأ، فمنذ بدء الإبادة، فقدتُ 16 فرداً من عائلتي المباشرة.
أشعر أحياناً أن من رحلوا هم الناجون الحقيقيون، أما نحن الذين بقينا بعدهم فنحمل وجعاً لا ينتهي، الذنب يخنقني، لم أنقذ أحداً، وأشعر بأن أهل غزة، كجماعة، كـ “ناجين”، لن يكونوا أبداً كما كانوا.
ولكي أخفف هذا الوجع، أتخيل عالماً لم أعش فيه في غزة قط، وأتخيل أن غزة التي صنعتني لم تكن موجودة أصلاً.
في ذلك العالم، أرى عائلتي تعيش حياة نحتفل فيها بهم، لا بذكراهم، يكبر الأطفال بسلام، لا تُجمع أطرافهم من فوق الأسطح
في ذلك العالم، أرى عائلتي تعيش حياة نحتفل فيها بهم، لا بذكراهم، يكبر الأطفال بسلام، لا تُجمع أطرافهم من فوق الأسطح