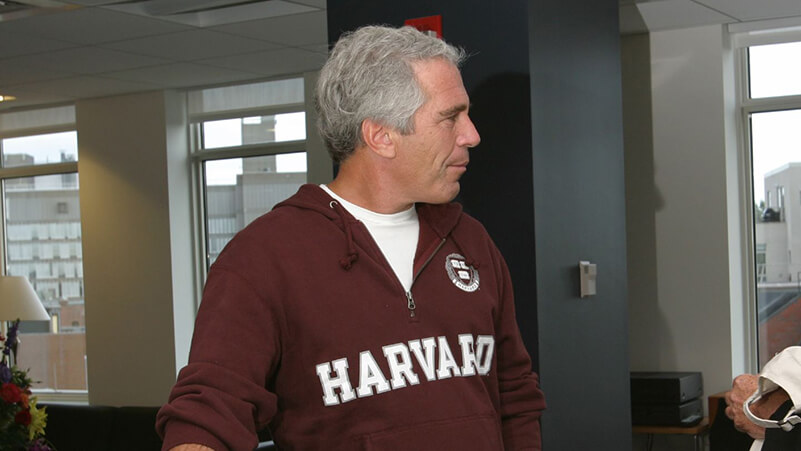بقلم روبرت سبرينغبورغ
ترجمة وتحرير مريم الحمد
أشرف على قتل جماعي لنحو ألف مواطن مصري عند انقلابه في صيف عام 2013، وبعد ذلك أعدم المئات وسجن عشرات الآلاف من المصريين بتهم سياسية مزعومة، حتى أنه دفع ما لا يقل عن ثلث السكان إلى الفقر، وبسببه تراكم الدين القومي إلى ما يقرب من 400 مليار دولار، بعد إهدار جزء كبير منها في مشاريع تافهة واستحواذات عسكرية، ولكن رغم ذلك نجح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في إحكام قبضته على السلطة!
ليس ذلك لأنه فريد من بين جيله من الحكام المستبدين، فقد انحسرت الموجة الثالثة من التحول الديمقراطي أو النظام العالمي الجديد، والتي بدأت منذ سبعينيات القرن العشرين، وعززها انهيار الاتحاد السوفييتي بعد نحو 15 عاماً، تاركة وراءها حكاماً مستبدين أكثر شراسة من أسلافهم، فسلطوية السيسي “صارمة” إذا ما قورنت بسلطوية مبارك “الناعمة” إن صح التعبير هي مثال على ذلك.
السلطان العسكري في مصر يشكل مزيجاً فريداً من جيش موحد سياسياً، يدرك تماماً دوره المركزي في الاقتصاد السياسي للبلاد بل ويعمل على تكريسه، ويرأسه رئيس يكافئ ويعاقب الضباط بناء على معلومات استخباراتية عن سلوكهم ومواقفهم، فخلفيته العسكرية جعلت منه “رئيساً سلطانياً” بامتياز!
وهنا يُطرح التساؤل حول سبب تشدد الأنظمة الاستبدادية مثل نظام السيسي في هذه المرحلة، وما هو مستقبلها المحتمل؟ هل يضطرون إلى التحول لنسخة أكثر ليونة أو حتى شبه ديمقراطية؟ وهل يتمكنون من تكرار الانقلاب العسكري للاستيلاء على السلطة؟ وما هي احتمالات الثورة وانهيار النظام؟! ربما يمكن الإجابة على تلك الأسئلة من خلال تحليل آفاق نظام السيسي كمثال على زملائه الديكتاتوريين.
نقض “الاتفاق”!
إذا ما أخذنا البرتغال كمثال، فإن التحول فيها من النظام الاستبدادي إلى الديمقراطي عام 1974، كان نتيجة لاتفاقيات بين المتشددين داخل الأنظمة والمعارضين المعتدلين، حيث سعى المتشددون إما إلى الاحتفاظ ببعض السلطة أو على الأقل الهروب من انتقام الطرف الآخر بسبب خطاياهم السياسية، فيما كان المعارضون المعتدلون على استعداد للتكيف مع تلك الرغبات والتخلي عن الانتقام من أجل الوصول لانتقال سلمي للسلطة.
أما اليوم، ومع إصرار المستبدين على استبدادهم، فقد أصبحت تلك الطريقة التوافقية لإرساء الديمقراطية أصعب تحقيقاً من أي وقت مضى، فقد أصبحت الشروط المسبقة للتوافق أبعد وصولاً وأصبح لدى المستبدين اليوم المزيد من الأدوات القمعية والدعم الإقليمي والدولي في كثير من الأحيان.
لقد ارتبطت التحولات القائمة على الاتفاق اليوم بوجود مواطنين واعين سياسياً من ناحية، وبجيوش انقسم فيها الضباط من حيث وجهات النظر السياسية المتنافسة من ناحية أخرى، وتحدث هذه التحولات عادة في البلدان التي تتمتع ببعض التقاليد الديمقراطية، وغالباً عقب أزمة سياسية أو اقتصادية أو عسكرية.
من الجدير بالذكر أنه في أدبيات العلوم السياسية وأدبيات العبور والتحول الإنساني، فإن الشكل الوحيد للحكم العسكري، الأقل احتمالاً للخضوع للانتقالات المتفق عليها نحو الديمقراطية، هو ما تم وصفه بأنه “سلطاني”، في إشارة إلى حكم فردي مطلق من قبل شخصية عسكرية بارزة، والسيسي يعد نموذجاً أصلياً لذلك التعريف بالفعل!
“السلطانية” العسكرية
بالنسبة للعالم العربي، فإن السلطان العسكري في مصر يشكل مزيجاً فريداً من جيش موحد سياسياً، يدرك تماماً دوره المركزي في الاقتصاد السياسي للبلاد بل ويعمل على تكريسه، ويرأسه رئيس يكافئ ويعاقب الضباط بناء على معلومات استخباراتية عن سلوكهم ومواقفهم، فخلفيته العسكرية جعلت منه “رئيساً سلطانياً” بامتياز!
الرئيس المصري السابق، جمال عبد الناصر، كان ضابط مشاة، وأنور السادات خدم في الجيش ما يقرب من 5 سنوات، أما حسني مبارك فقد كان من القوات الجوية ولا علاقة له بالسياسة، ولذلك كانت مقاومة انقلاب هؤلاء الرؤساء أمراً صعباً، مثل محاولات وزير الدفاع عبد الحكيم عامر ضد عبد الناصر، ومحاولة وزير الدفاع عبد الحليم أبو غزالة ضد مبارك، ففي كلتا الحالتين، كان الرئيس من يستبق الانقلاب عليه.
أما السادات، فقد استمر في تطهير ضباطه عقب حرب عام 1973، لأنه كان يرى أنهم كانوا يتآمرون عليه، وبالفعل، فقد أودت المؤامرة بالنهاية بحياته، بعد تآمر الإسلاميين والضباط عليه.
الخلاصة، أن الجيش المصري، وبسبب طبيعته المؤسسية وخضوعه للتدقيق من قبل عين نسر السيسي، فهو لا يستوفي المعايير اللازمة لعملية انتقالية متفق عليها، ومن ناحية أخرى، فمن غير المرجح أن تؤدي أي تحركات في الجيش إلى كارثة كما حدث عام 1967، أو كما فعلت الجيوش اليونانية والأرجنتينية سابقاً.
“يد واحدة”
إن الخط المعياري للقيادة العليا المصرية هي أن دور الجيش الدفاع عن حدود مصر، ولكن ذلك غير دقيق إذا ما جئنا لأرض الواقع ورأينا تدخلات الجيش في ليبيا والسودان، لكن مؤخراً، تسعى القيادة المصرية إلى تجنب التورط بالشؤون الخارجية المكلفة سياسياً، مثلما تعثرت في اليمن من عام 1962 إلى عام 1968، والذي كان درساً يفسر رفض السيسي إنضمام الوحدات المصرية إلى قوات محمد بن سلمان السعودية في اليمن.
أما على صعيد الانقسام العسكري المدني، فإن المدنيين بعيدون كل البعد عن التوحد ضد الجيش، وهو يناقض ما تتطلبه التحولات المتفق عليها من مشاعر عميقة تجمعهم مناهضة للمؤسسة العسكرية، ويمكن تذكر شعار “الشعب والجيش يد واحدة” في هذا السياق، فهو لا يُنسى من المظاهرات الحاشدة عام 2011، ويعكس الصورة الإيجابية السائدة للجيش بدقة.
يعد ذلك خلافاً لما جرى في إيران، على سبيل المثال، في الفترة بين عامي 1978- 1979، حيث كان أنصار الخميني عازمين على تقسيم جيش الشاه من خلال تجنيد ضباط صف ساخطين لقضيتهم.
تصور عالمي جديد مفاده أن المستبدين أفضل من الديمقراطيين في توجيه النمو الاقتصادي، وهو اعتقاد تجسده الصين، التي تستخدم قوتها الاقتصادية لتعزيز المفهوم
أما المتظاهرون المصريون فقد سعوا للحصول على دعم المؤسسة العسكرية ككل من أجل طرد مبارك من الرئاسة، حتى أن الإسلاميين والعلمانيين كانوا يتنافسون للحصول على رضى المؤسسة العسكرية، وهو أمر كسبه الإسلاميون لفترة وجيزة، حيث اعتبر الجيش الإسلاميين أكثر كفاءة وبالتالي أكثر قوة فائدة وأكبر تهديداً في نفس الوقت، مما جعل المؤسسة العسكرية تتوخى الدقة والحذر في تحركاتها إبان حكم مرسي.
مثل غيره من الديكتاتوريين، فإن استبداد السيسي المستمر ناتج عن ظهور أدوات جديدة لتحقيق السيطرة الشمولية، فالأساليب القديمة للمراقبة، مثل التنصت على المكالمات و البوابين الذين كانوا يتقاضون الرواتب من أجهزة الاستخبارات، أفسحت المجال لدخول الرقابة الالكترونية على كل جوانب حياة المواطنين تقريباً.
يعد اشتراط معظم التعاملات الحكومية، بدءاً من فواتير الخدمات إلى الحصول على السلع المدعومة، إلكترونياً، جزءاً من اكتمال المراقبة والتضليل على وسائل التواصل الاجتماعي، ناهيك عن التنصت الشامل على الهواتف المحمولة والانترنت، الأمر الذي نتج عنه تأثير مروع على الخطاب العام، وذلك بلاشك هو قصد الحكومة من استخدام وسائل المراقبة، لترى من يستحق، من وجهة نظرها، العقوبة.
في السياق العالمي
مثلما لا يمكن أن يؤدي السياق المصري الحالي إلى التحول من الاستبداد، كذلك السياق العالمي أو الإقليمي، فقد تباطأت موجة العولمة الاقتصادية التي ساعدت في دفع التحول الديمقراطي في الفترة بين عامي 2008-2009، ولكنها لم تتعافَ بعد ذلك.
لقد انتقل الارتباط طويل الأمد بين الديكتاتوريات الشيوعية وغياب الكفاءة الاقتصادية إلى غياهب التاريخ، وحل محله تصور عالمي جديد مفاده أن المستبدين أفضل من الديمقراطيين في توجيه النمو الاقتصادي، وهو اعتقاد تجسده الصين، التي تستخدم قوتها الاقتصادية لتعزيز المفهوم، وعلى الجانب الآخر، هناك النظام العالمي الجديد الذي أنشأته الولايات المتحدة، والذي يرتكز على الدولار لخدمة المصالح الغربية الغنية على حساب الدول الأخرى.
تواجه القاهرة أزمة اقتصادية استعصت على الحل بعد تراجع الدعم الخارجي، وذلك ينذر باستمرار الفقر المقترن بالفساد المستشري مما سيؤدي إلى تآكل الدعم الشعبي
من اللافت عند النظر للتاريخ، أن ما يحصل اليوم مشابه لما حدث فترة الثلاثينات، حين استسلمت الديمقراطيات للكساد الاقتصادي في حين بدأ الاتحاد السوفيتي وألمانيا بالازدهار نسبياً.
يمكن القول أنه حتى استفحال المديونية وأزمة النقد الأجنبي، فقد قدم السيسي الاقتصاد المصري كدليل حي على تعزيزه من قبل حكومة استبدادية، ولم يتخلَ عن هذا الادعاء حتى وهو يتظاهر بتحرير الاقتصاد، من أجل الحصول على المزيد من القروض من صندوق النقد الدولي وغيره.
ومع الاستمرار في الإعلان عن مشاريع جديدة، فإن وعد السيسي لصندوق النقد الدولي باقتصار الإنفاق على المشاريع ذات رأس المال الكبير والفائدة الضخمة يبدو أجوفاً وبلا معنى!
في السياق الإقليمي
يمكن تقسيم الاقتصادات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3 أقسام، في الأعلى تأتي الدول المتطورة اقتصادياً عن غيرها، والتي تشمل دول الخليج وإسرائيل، حيث تتجه اقتصاداتها وطموحاتها السياسية نحو مزيد من العولمة، على حساب مصالحها الإقليمية.
أسوة بواشنطن والعواصم الاوروبية، فقد باتت تنظر دول المنطقة إلى مزيد من الاستثمارات الاقتصادية والسياسية الضخمة في المنطقة، على أنها لا تحقق أرباحاً كافية، مقارنة بالاستخدامات الأخرى لرؤوس الأموال.
إن عواقب إعادة التوجه هذه محسوسة أيضاً في بلدان أخرى في المنطقة، فقد كان لبنان أول من شهد إهمال الخليجيين خاصة السعودية، الأمر الذي تجلي بالتخلي عن سعد الحريري ووقف تدفق رؤوس الأموال إلى بيروت، وهي معاملة تتعرض مصر لها الآن، وإن كانت أقل قسوة.
يظهر ذلك التخلي من خلال وسائل الإعلام السعودية والإماراتية والقطرية والكويتية التي تنتقد السيسي بشكل متزايد، وترفض إيداع المزيد من الأموال في البنك المركزي المصري، بل تطالب بدلاً من ذلك بتعويض رأس المال المقدم من خلال أسهم في الشركات المملوكة للدولة، مساومة أدت إلى تأخير المعاملات لعدة أشهر، مما جعل الرسالة واضحة “السيسي ومصر أصبحا مصدر قلق ثانوي فقط لحكام الخليج.
ينطبق ذلك على إسرائيل أيضاً، فلم تعد مصر تشكل تهديداً عسكرياً، ففي السابق كانت قيمة مصر المتبقية تتمثل بدورها كوسيط مع الفلسطينيين، ومع دول عربية أخرى، لكن نفوذ القاهرة تآكل، والآن تستطيع إسرائيل تجاوزها بثقة والتعامل مباشرة أو الاستفادة من علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي من أجل الضغط على الفلسطينيين.
وعلى الطرف الآخر، توجد الدول الفاشلة، وتشمل ليبيا والسودان وسوريا واليمن، وإلى حد ما العراق ولبنان، فقد باتت المصالح الأساسية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تجاه هذه البلدان تتمثل في ضمان عدم حصول أي طرف معادٍ على اليد العليا، وهي في نفس الوقت غير مستعدة لاستثمار رأس المال المالي والسياسي لإعادة إعمارها.
سوف تتحول مصر إلى ساحة حرب بالوكالة، غير عنيفة في أغلب الأحيان، كما هو الحال في لبنان، حيث تسعى القوى الخارجية المتنافسة إلى تحقيق مصالحها الخاصة لضمان عدم حصول الخصم على اليد العليا
وفي الوسط، الدول العربية التي يمكن تسميتها “الناجية”، منها المغرب والجزائر وتونس ومصر، وجميعها تقع في شمال إفريقيا، فمن الناحية السياسية اتبعوا مسارات مماثلة من الاستبداد الناعم إلى الثورة الشعبية والحكم الاستبدادي الأكثر شراسة، كما لا يوجد لديها أي آفاق اقتصادية أو سياسية مشرقة، ولم يعد أي منها جاذباً لاهتمامات الخليجيين، فهي ليست دولاً فاشلة فهي لا تزال قادرة على السيطرة على تدفق الهجرة وردع الإرهاب، باعتبارها المخاوف التي تحفز الاهتمام الأوروبي نحو أشكال الدعم الاقتصادي والسياسي، بغض النظر عن كونها أنظمة مستبدة مناهضة للديمقراطية!
من المفارقة أن مصر والسيسي أصبحا تحت وصاية الغرب، خاصة أوروبا، ففي الوقت الذي يشتري فيه السيسي أسلحة ومفاعلاً نووياً من موسكو، ويتابع الاستثمارات الصينية في قناة السويس، يظل شريان حياته رأس المال الغربي في شكل منح وقروض، في علاقة أشبه بالابتزاز، حيث تدفع الدول الغربية المال لمنع المبتز من النزوح إليه، وتلك علاقة غير صحية، ولا يمكنها دفع مصر بعيداً عن الحكم الاستبدادي.
ما الذي ينتظر مصر في المستقبل؟
لا شك أن التوقعات السياسية والاقتصادية لمصر ما زالت قاتمة وغامضة، ففي ظل غياب الشروط المسبقة للانتقال المتفق عليه بعيداً عن الحكم العسكري الاستبدادي، فإن آفاق التحول الديمقراطي أو حتى تخفيف سلطوية السيسي لا تبدو مشرقة، وفي الوقت نفسه، فهي غير مشرقة بالنسبة لحكم السيسي أيضاً.
حالياً، تواجه القاهرة أزمة اقتصادية استعصت على الحل بعد تراجع الدعم الخارجي، وذلك ينذر باستمرار الفقر المقترن بالفساد المستشري مما سيؤدي إلى تآكل الدعم الشعبي، وفي الواقع، يبدو أنه من غير المرجح أن يواجه النظام معارضة قوية وموحدة، سواء كانت سلمية أو لا، لكنه لا شك سيواجه اضطرابات غير مألوفة.
ما زالت مقاومة السيسي للانقلاب قوية حتى اليوم، لذلك، ما لم تصل الفوضى والاضطرابات إلى مستوى تهديد الحكم العسكري، فلن نشهد استبدال السيسي من قبل زملائه الضباط.
سيناريو يشبه ما يحصل في لبنان، حيث تتمسك النخبة الحاكمة، التي تعتمد على المخابرات وميليشيا حزب الله، بالسلطة رغم سخط اللبنانيين، ولكن الحقيقة أن الشعب غير قادر على المواجهة، كما أن العالم لا يسارع إلى معالجة محنتهم، تماماً مثلما أنه من غير المرجح فعل ذلك لإنقاذ المصريين من سوء الإدارة والظروف الاقتصادية المتدهورة.
سوف تتحول مصر إلى ساحة حرب بالوكالة، غير عنيفة في أغلب الأحيان، كما هو الحال في لبنان، حيث تسعى القوى الخارجية المتنافسة إلى تحقيق مصالحها الخاصة لضمان عدم حصول الخصم على اليد العليا.
الحقيقة لن تتمكن أي قوة خارجية من استثمار القدر الكافي من الموارد السياسية والاقتصادية لتصحيح مسار الدولة وإنقاذ الاقتصاد، ما سوف ينقذهم على المدى القصير هو الهجرة، مثل اللبنانيين، الذين يسعون للهجرة إلى أراضٍ أكثر ترحيباً بهم.
للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)