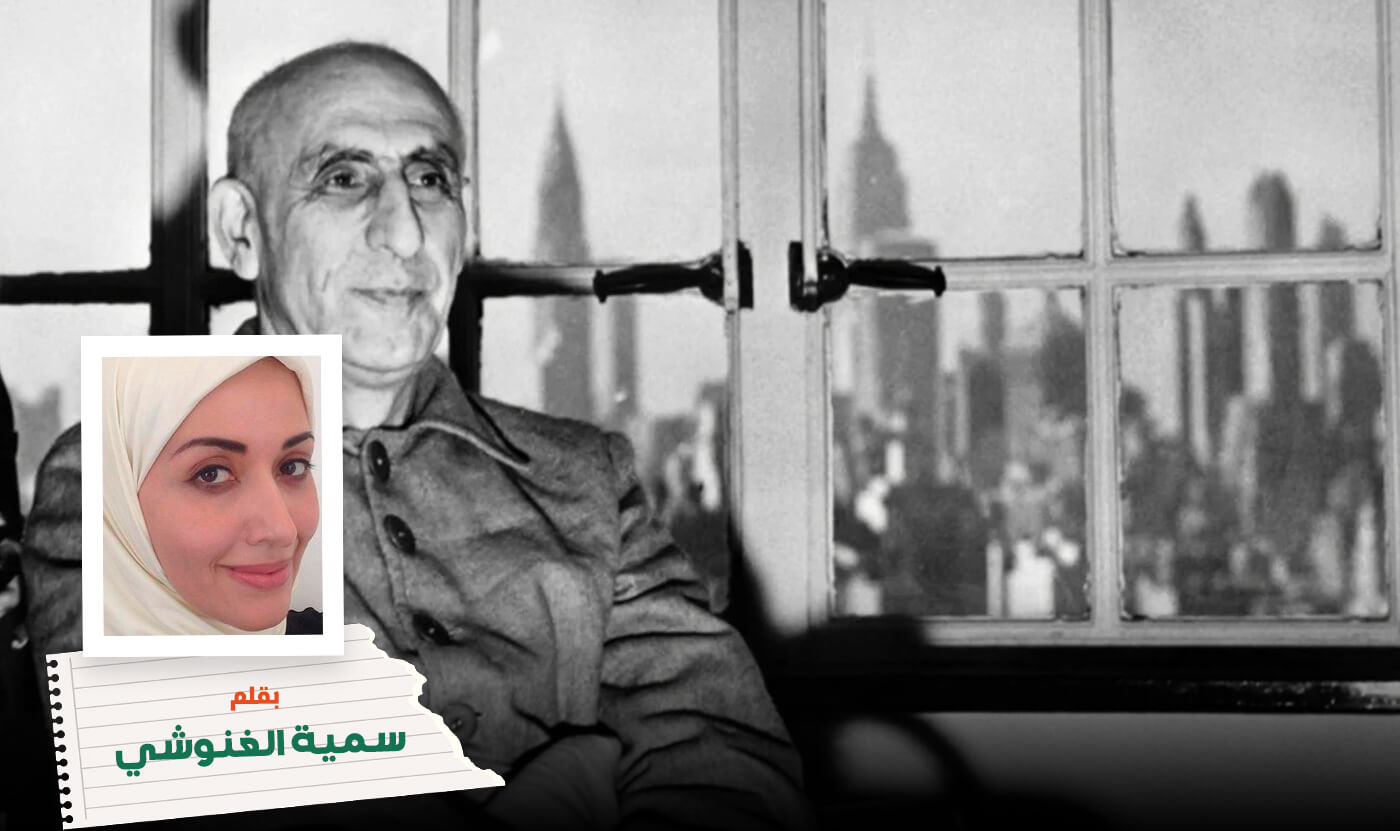بقلم جوزيف مسعد
بعد مرور 140 عاما على بداية الاستعمار الصهيوني لفلسطين، وبعد مرور 75 عاما على إنشاء المستعمرة الاستيطانية “اليهودية”، لا تزال حرب إسرائيل التي تشنها لفرض التفوق العرق اليهودي على الشعب الفلسطيني تتطلب منها قتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين. إن استمرار الفلسطينيين، بعد مرور ما يقرب من قرن ونصف من بداية الاستعمار، في مقاومة معذبيهم الصهاينة بكل ما يملكون من قوة، يجعلهم هدفا مشروعا في نظر إسرائيل وحلفائها الغربيين لآلة القتل الإسرائيلية التي تمارس الإبادة الجماعية.
لقد نفدت الصيغ العنصرية من جعبة الصهاينة لوصف الشعب الفلسطيني، وعادوا لتكرار الصيغ القديمة التي استخدمها الجيل السابق من الغزاة الصهاينة. فإن وصف بنيامين نتنياهو حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني بأنها “حرب بين قوى النور وقوى الظلام، بين الإنسانية والحيوانية”، وكما هو الحال مع كل ألاعيبه العنصرية السابقة، هو وصف يفتقر إلى الأسبقية. فقد كان المؤسس النمساوي- المجري للحركة الصهيونية ثيودور هرتسل؛ هو الذي وصف المستعمرة الاستيطانية اليهودية المستقبلية في عام 1896 بأنها ستشكل “جزءا من متراس أوروبا ضد آسيا، وقاعدة أمامية للحضارة في مواجهة الهمجية”. وبدوره، وصف رئيس المنظمة الصهيونية البيلاروسي حاييم وايزمن الفلسطينيين عام 1936 بـ”قوى الدمار، قوى الصحراء” والمستعمرين اليهود بـ”قوى الحضارة والبناء”. في الواقع، كان وايزمان قد وصف الغزو الصهيوني لفلسطين بأنه “حرب الصحراء القديمة ضد الحضارة، لكننا لن نتوقف”.
إن مثل هذه الأوصاف العنصرية والإبادية لا تقتصر على الصهيونية؛ بل هي نموذجية لجميع الشعوب المستعمِرة. فعندما غزا الفرنسيون كاليدونيا الجديدة ووضعوا سكانها الكاناك الأصليين الذين نجوا من عمليات القتل في محميات بعد سرقة أراضيهم، وصف الفرنسيون مقاومة الكاناك لإبادتهم بأنها حرب “الوحشية ضد الحضارة”، وعندما غزت بريطانيا مصر واحتلتها عام 1882، وصفت حربها بأنها “صراع بين الحضارة والهمجية”. وأمثلة ذلك في الأرشيف الاستعماري وافرة.
أما نتنياهو، وهو من أصول بولندية، فليس فريدا في توصيفاته العنصرية، بل هو نموذج لجميع قادة إسرائيل، الذين -شأنهم شأن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك، وهو من أصول ليتوانية- يشيرون إلى إسرائيل على أنها “فيلا في الغابة”، أو وزير الدفاع الإسرائيلي الحالي يوآف غالانت، وهو من أصول بولندية، الذي وصف الفلسطينيين في اليوم الثالث من الحرب الفلسطينية الإسرائيلية الحالية بأنهم “حيوانات بشرية”.
أما فيما يتعلق بالخطاب الديني الذي يستخدمه الصهاينة “العلمانيون” دائما لتبرير غزوهم لفلسطين، فهو ليس بعيدا أبدا عن الخطاب الرسمي الإسرائيلي. فقد أمر نتنياهو قواته الاستعمارية أثناء قيامها بمهمتها لإبادة الشعب الفلسطيني بأن “يتذكروا ما فعله العمالقة بكم، كما يقول كتابنا المقدس. فنحن نتذكر”. وهذا الخطاب التوراتي ليس أكثر من أحدث استخدام للنصوص التوراتية في الحلبة السياسية. وكان الرب اليهودي قد أمر شعبه قائلا: “الآن اذهبوا وهاجموا العمالقة ودمروا كل ما لهم تدميرا كاملا. لا تدخروهم. اقتلوا الرجال والنساء والأطفال والرضع والبقر، والغنم، والجمال، والحمير”. يبدو أن نتنياهو يقوم بتطبيق هذه الوصية على الشعب الفلسطيني بحذافيرها.
وتشكل دعوات نتنياهو جزءا من الربط الصهيوني الأسطوري بين استعمار اليهود الأوروبيين والعبرانيين القدماء من أجل الزعم بأن أصول اليهود من فلسطين. لكن هذه الأساطير الصهيونية تتناقض مع النصوص التوراتية التي تعتمد عليها، والتي تخبرنا أنه حتى العبرانيون القدماء لم يكونوا من السكان الأصليين لفلسطين، بل كانوا غزاة لأرض كنعان. وهذا ما دفع إدوارد سعيد ذات مرة إلى الرد على هذه الرواية الصهيونية الزائفة في مقالة عنوانها “قراءة كنعانية” لتلك الأساطير.
ولإخفاء طبيعة الغزو الصهيوني والتاريخ الدموي للمستعمرين اليهود في فلسطين، فقد أمطرتنا إسرائيل ووسائل الإعلام الغربية بالادعاء البغيض بأن هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الذي شنته حماس كان الهجوم الأكثر دموية على اليهود “منذ المحرقة”. وتعود المحاولات الإسرائيلية والصهيونية النشطة لتصوير الفلسطينيين كمعادين للسامية وكنازيين إلى عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي على التوالي. إن الهدف من هذه الدعاية الحالية هو تحويل النضال الفلسطيني من نضال مناهض للاستعمار إلى نضال معاد للسامية، لكسب التعاطف العالمي مع إسرائيل.
إن تصوير الجنود والمدنيين الإسرائيليين الذين لقوا حتفهم في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر كضحايا لمعاداة السامية يهدف بوضوح إلى إخفاء حقيقة مفادها أنه عندما يهاجم الفلسطينيون إسرائيل واليهود الإسرائيليين، فإنهم يهاجمونهم كمستعمِرين، وليس كيهود. إن محاولة تبرئة إسرائيل ومواطنيها اليهود من جريمة الاستعمار الاستيطاني والتفوق العرقي من خلال مقارنتهم باليهود الأوروبيين الذين استهدفتهم معاداة السامية فقط لأنهم يهود، ليست بحد ذاتها معادية للسامية فحسب، ولكنها أيضا تقوم بتشويه الذاكرة عبر طرح اليهود الذين سقطوا خلال الحرب العالمية الثانية على أنهم كانوا مرتبطين بطريقة أو بأخرى بالمستعمرة الاستيطانية اليهودية في إسرائيل، والتي لم يزل يقاومها الفلسطينيون بسبب نظام التفوق العرقي والاستعمار الاستيطاني الذي أسسته وليس بسبب يهوديتها. إن القول بأن الفلسطينيين ما كانوا ليقاوموا مستعمريهم لو كان الأخيرون مسيحيين أو مسلمين أو هندوسا وأنهم يقاومونهم فقط لأنهم يهود؛ هو من السخافة بمكان حيث لا يستحق أكثر من الازدراء.
أما قيام إسرائيل وأنصارها بإعادة تسمية المقاومة الفلسطينية على أنها معاداة للسامية إنما هي تعكس الرعب الإمبريالي والعنصري الأمريكي الأخير من استخدام هتاف “من النهر إلى البحر” في التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، والتي يسعى الصهاينة أيضا لتلطيخها بتهمة معاداة السامية. إن هتاف “من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر” كما يستخدم بالإنجليزية، يعني أن فلسطين التاريخية بأكملها يجب أن تتحرر من نظام الامتيازات الاستعمارية والتفوق العرقي اليهودي، وأن جميع المؤسسات والقوانين العنصرية الإسرائيلية يجب أن تُلغى من “النهر إلى البحر” كي يتحرر الفلسطينيون.
أما نظام الفصل العنصري الأقل همجية بعض الشيء والذي يمارس داخل حدود 1948 على فلسطينيي الداخل من “مواطني إسرائيل”، فقد انتقل منذ الشهر الماضي إلى نظام مماثل تقريبا في إجراءاته القمعية الصارمة للنظام العنصري القائم في الضفة الغربية؛ حيث تستمر المذابح ضد الفلسطينيين على أيدي المستوطنين وجيش الاحتلال. لكن يبدو أن أمورا كهذه غير ذات صلة عند أولئك الذين يشوهون معنى هذا الهتاف.
يصر المعترضون على هذا الهتاف، لا سيما أولئك الذين يزعمون أنهم يدعمون حل الدولتين، على أنهم يدعمون إسقاط الاحتلال الإسرائيلي والتفوق العرقي اليهودي في الضفة الغربية وقطاع غزة، لكنهم يعترضون بشدة على إسقاطه داخل إسرائيل نفسها. فما تطرحه هذه الحجج الصهيونية في نهاية المطاف هو أن الهوية اليهودية اليوم تتضمن في جوهرها إقامة نظام تفوق عرقي يهودي على غير اليهود واستعمار أراضي الآخرين، وأن أي شخص يعارض أيا من هذين الأمرين، بحسب هذا التعريف الصهيوني، هو معاد للسامية. لكن ما هو معاد للسامية في حقيقة الأمر هو ليس إلا هذا الإسقاط الصهيوني والإسرائيلي لقيم الاستعمار الاستيطاني والتفوق العرقي اليهودي كجوهر الهوية اليهودية على اليهود واليهودية، بينما هي ليست إلا جوهر الهوية الصهيونية.
إن إجماع الحكومات ووسائل الإعلام الغربية على الدفاع عن إسرائيل اليوم، رغم ما يثيره من دهشة لدى البعض، لا يختلف عن الإجماع الغربي على دعم المستعمِرين الأوروبيين ضد السكان الأصليين المستعمَرين منذ بزوغ الاستعمار الأوروبي. فعلى سبيل المثال لا الحصر كان “الديمقراطي” الفرنسي المحبوب ألكسيس دو توكفيل في القرن التاسع عشر هو من برر الاستعمار الفرنسي في الجزائر قائلا: “لقد سمعت كثيرا رجالا أحترمهم، ولكني لا أتفق معهم، يجدون أنه من الخطأ أن نحرق المحاصيل، وأن نفرغ صوامع القمح، وحتى أن نعتقل الرجال والنساء والأطفال العزل. هذه في نظري ضرورات مؤسفة، لكن لا بد لأي شعب يريد شن حرب على العرب أن يلتزم بها”. أما الأيقونة الليبرالية البريطاني جون ستيوارت ميل، فقد كان هو الآخر واضحا في أن “الاستبداد هو أسلوب شرعي للحكم في التعامل مع البرابرة”.
وفي أثناء الإبادة الجماعية الألمانية لشعب الهيريرو في ناميبيا في أوائل القرن العشرين، كان الديمقراطيون الاشتراكيون الألمان عنصريين تماما شأنهم شأن المحافظين والليبراليين. ففي رده على الوصف العنصري لشعب الهيريرو من قبل البرلمانيين المحافظين والليبراليين على حد سواء، الذين اعتبروا الهيريرو “وحوشا” غير إنسانية، وافق أوغست بيبل، زعيم الديمقراطيين الاشتراكيين الألمان في البرلمان، على الرغم من تعاطفه مع نضال شعب الهيريرو، على أن شعب الهيريرو ليس متحضرا: “لقد أكدت مرارا وتكرارا أنهم شعب متوحش ومنخفض المستوى جدا في الثقافة”. وقد شارك أعضاء كومونة باريس الفرنسيون، الذين تم نفيهم إلى كاليدونيا الجديدة بغية إصلاحهم بعد قمع انتفاضة كومونة باريس عام 1871، بنشاط في الإبادة الجماعية لشعب الكاناك الأصليين.
وقد تساءل بعض المعلقين على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا كيف يمكن لبعض اليهود الإسرائيليين تنظيم مهرجان موسيقي على بعد خمس كيلومترات من معسكر الاعتقال والسجن الكبير الذي هو غزة، حيث قُتل العشرات منهم في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر. لكن آخرين قد وضحوا بأن “حفلات الطبيعة في الهواء الطلق، أو المهرجانات الموسيقية في وديان إسرائيل المشجرة والصحاري الجنوبية، هي هواية شعبية منتشرة بين الشباب الإسرائيلي”.
وهذا ليس وضعا مقصورا على الإسرائيليين، فقد صرح المدعي العام الجنوب أفريقي في مستعمرة ناميبيا الاستيطانية التي كانت تحتلها جنوب أفريقيا في عام 1983، أن “المجتمع الأبيض ليس لديه أدنى فكرة عما يحدث في منطقة العمليات”، حيث كانت مقاومة السود على أشدها. وأضاف أن “البيض في جنوب البلاد يواصلون إقامة الحفلات”. وقد أوضح مؤرخو النضال الناميبي أنه “لا غرابة في أن البيض نتيجة تعودهم على غض الطرف عن المقاومة المحتدة في ضواحي السود التي لا تبعد أكثر من خمسة أميال عن منازلهم، قد تجاهلوا الحرب القائمة بالقرب منهم”.
ما يلفت النظر في الإجماع الغربي المناهض للفلسطينيين اليوم هو حقيقة أن الأكاديمية الغربية، التي كانت في السابق دعامة أساسية لنصرة إسرائيل، قد فضحت في الأعوام الأربعين الماضية جميع المزاعم الصهيونية المركزية لإسرائيل، بدءا من المزاعم التي تدعي حق اليهود في أرض الفلسطينيين وانتهاء بادعاءاتها بأن “ديمقراطية” العرق المتفوق الممأسسة فيها هي بالفعل “ديمقراطية” تنطبق على الجميع. لكن لم يكن لأي من هذا أي تأثير على الحكومات الغربية أو وسائل الإعلام في تصويرها لإسرائيل أو الفلسطينيين.
يكشف استمرار استخدام الاستشراق والمستشرقين، ناهيك عن الصهاينة المتعصبين المؤيدين لإسرائيل، كمستشارين ومخبرين للحكومات ووسائل الإعلام بعد 11 أيلول/ سبتمبر، بما في ذلك برنارد لويس وآخرون الذين فقدت أعمالهم مصداقيتها منذ السبعينيات، التزام القوى السياسية الغربية الصارم بتفوق العرق الأبيض وإصرارها على أن الصهيونية الاستشراقية والعنصرية المعادية للعرب والمسلمين فقط هي التي سيتم استدعاؤها للمساعدة في تنفيذ المشاريع الإمبريالية. وما يشير إليه هذا الالتزام بوضوح هو أن المعرفة والعلوم الأكاديمية الغربية التي تعزز سيطرة الإمبريالية وتفوق العرق الأبيض هي فقط التي يتم تجنيدها لدعم المشاريع الإمبريالية، في حين أن أي معرفة أو دراسات يمكن أن تصرف الانتباه عن الأهداف الإمبريالية فإنها تعتبر غير ذات صلة أو تفقد مصداقيتها وتخضع للرقابة.
لا يزال عالمنا منقسما أكثر من أي وقت مضى بين قوى تفوق العرق الأبيض بقيادة الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، وضحاياها من غير البيض. إن جرائم حرب الإبادة الجماعية المستمرة التي ترتكبها إسرائيل في غزة ليست سوى الأحدث في تاريخ طويل من الفظائع الاستعمارية لحماية التفوق الأوروبي الأبيض في آخر مستعمرة استيطانية له في آسيا. لكن ما يرفض العنصريون البيض الاعتراف به هو أن الشعب الفلسطيني لن يتوقف عن مقاومة إسرائيل حتى تتم هزيمة نظام الفصل العنصري ونظام تفوق العرق اليهودي.
للإطلاع على النص باللغة الانجليزية من (هنا)