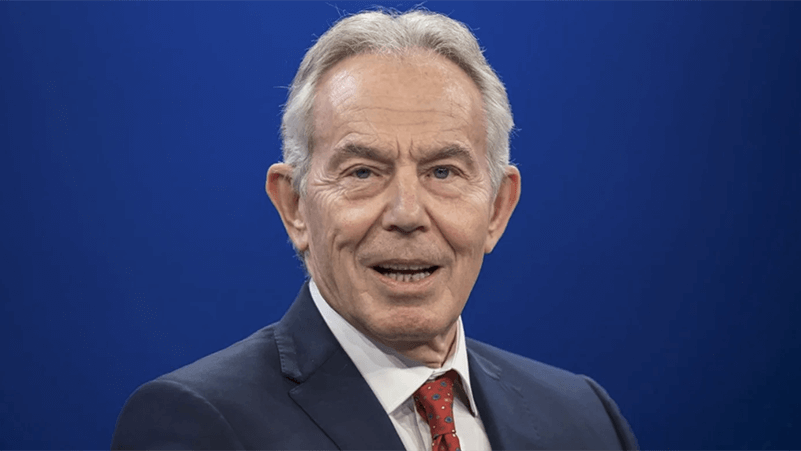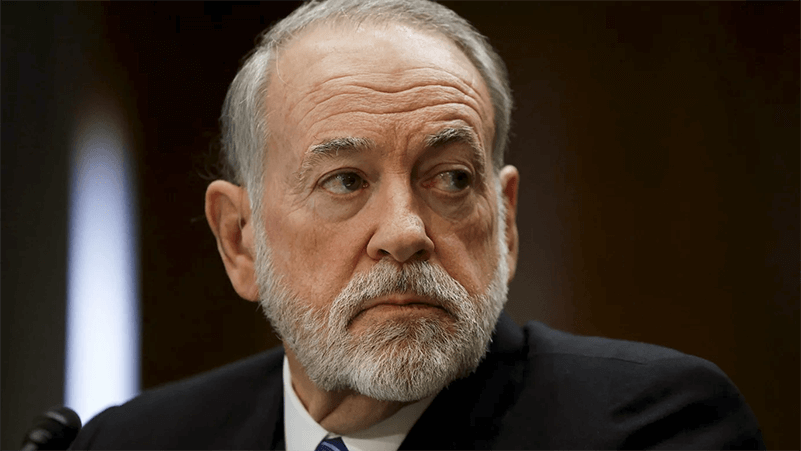بقلم حسني محمد
ترجمة وتحرير نجاح خاطر
تحولت “ممرات الإغاثة” زيكيم ونيتساريم وموراج إلى مختبرات نفسية يجري الاحتلال فيها تجارب بشرية جماعية، وفي هذا الإطار، ينهار المنطق، وتتفكك القيم الشخصية، ويعاد تشكيل البشر، ولكن فقط بعد تفكيكهم نفسيًا.
تتسلق دبابة للاحتلال تلالًا رملية تطل على منطقة مفتوحة مسطحة، وخلفها تقع تلة رملية أخرى، يستخدمها المدنيون كملاذ أخير من إطلاق النار العشوائي المتواصل الذي يشتد مع ابتعاد شاحنات الإغاثة عن المركبات العسكرية.
في تلك اللحظة، ينقطع الخيط الأخير الذي يربط الإنسان بذاته، وتتوقف الاستجابات الإنسانية الطبيعية، بحيث يصبح الإنسان شيئًا آخر، شيئًا غير مألوف، تندفع الحشود للأمام، ويسقط البعض، ويموت آخرون، لكن أحداً لا يتوقف، إنه سباق ضد الموت.
الهواء مليء بالغبار، كثيف لدرجة أنك تكاد لا ترى ما أمامك، يعلو صوت إطلاق النار المدوّي فوق كل شيء، يركض الناس نحو شاحنات الإغاثة، التي تبدو ضئيلة الحجم وسط هذا الهيجان المحيط بها.
من يسقطون تحت الأقدام يتم دوسهم أو تُسحق جماجمهم بإطارات السيارات، وإن حالفهم الحظ، فإن الكسر لا يطال سوى أرجلهم، إنه مشهد يشبه فيديو مُسرّع لفقاريات تتحلل، فيتحول جسدها إلى عظم نظيف في لحظة، وهكذا تُبتلع الشاحنات، فتتحول إلى هياكل جوفاء في دقائق.
هذه المشاهد ليست مرعبة فحسب، بل تُمثل أيضًا مجالًا نادرًا ومعقدًا لفهم السلوك البشري، فما الذي يُرتكب بحقنا؟ ما الذي يدفعنا إلى هذه الحالة؟ وكيف يُمكن، في ظل ظروف معينة، تجريد البشر من جميع دفاعاتهم الغريزية لصالح انغماسهم في هذا السلوك الفوضوي الشبيه بالقطيع؟
اقتصاد الجوع
للوهلة الأولى، قد يبدو الجوع وحده كافياً لتفسير الوضع، لكن الجوع غالباً ما يكون مجرد شرارة البداية، فمع مرور الوقت، يمكن أن تصبح الفوضى مورداً أساسياً في السوق، ويظهر شكل جديد من العمل، يضم فئات مميزة من العمال.
في المقدمة، يقف المحترفون، المعروفون محلياً باسم “وحدات السكر والنوتيلا”، وهم الأسرع والأكثر كفاءة وتنظيماً، فهم يستولون على أفضل وأثمن السلع.
ثم يأتي أولئك الذين يضطرون للعمل لتأمين قوت يومهم، أو لبيعه لتلبية احتياجات أخرى، بدأ الناس يدركون بشكل متزايد ضآلة عوائد مشاريعهم الصغيرة مقارنةً بما يمكن تحقيقه من خلال السعي وراء المساعدات، ويتزايد عدد الأشخاص الذين ينجذبون إلى هذه الظاهرة.
الصدمة الجماعية، وهي حالة نفسية تصيب السكان المعرضين لأحداث ساحقة ومرعبة كالقصف والتشويه وسفك الدماء والجوع والحرمان، في ظل ظروف من العجز التام، لها آثار موثقة جيداً، ويطور الكثيرون منهم سلوكيات إدمانية كآليات للتكيف.
نحن نشهد إعادة تشكيل للفرد والمجتمع والسوق والنسيج الاجتماعي الذي يربط الناس، وفي هذا السياق، لم يعد اقتحام شاحنات المساعدات، الذي شرّعته قوة الاحتلال باعتباره الخيار الوحيد “لإخماد الجوع”، بما يتماشى مع مصالحها الأمنية، مجرد فعل يائس، بل أصبح نمطًا قهريًا، ووسيلة للبحث عن آثار الذات في عالم يحكمه العجز والعبث.
يصبح الحصول على المساعدة الوسيلة الوحيدة التي يمكن للأفراد من خلالها الشعور بوجودهم، حتى لو كان ذلك عبر طرق مدمرة وفوضوية.
لم تعد سلة الغذاء، أو كيس الدقيق، مجرد مصدر غذاء مادي، بل أصبحت شكلاً من أشكال الإشباع النفسي الذي يوفر الطمأنينة، وسيلة لتأكيد المكانة الاجتماعية والتسلسل الهرمي الاجتماعي والشعور بالفاعلية في بيئتهم.
تترسخ الرغبة، بل والإكراه، في تكرار التجربة مرارًا وتكرارًا على الرغم من أن الفرد قد حصل بالفعل على طعام آمن وشعور مؤقت بالأمان، لكن الدافع لا يهدا، بل على العكس، يزداد قوة.
آليات المكافأة
يمكن تقسيم أولئك الذين يتجمعون على طول طرق المساعدة، والذين يُطلق عليهم أحيانًا اسم “عمال زيكيم”، إلى مجموعتين تقريبًا: المنتصرون، الذين عادةً ما ينجحون في الحصول على الطعام، والذين يعتمدون على الحظ، قائلين عبارات مثل: “هذا ليس بمهارتي، بل هو مجرد فضل من الله”، وبالتالي، هناك نمطان عاطفيان متمايزان يتعلقان بالمكافآت النفسية.
ترتبط مشاعر النصر الروتينية بنظام المكافأة في الدماغ، حيث يُفرز الدوبامين استجابةً للإنجاز أو النجاح، ويعمل هذا كحافز إضافي، يشجع على تكرار السلوكيات ويعززها لتصبح روتينًا.
يمكن أن تؤدي مشاعر المكافآت العشوائية أو المتقطعة، كما هو الحال في المقامرة، إلى مستويات أعلى من الدوبامين، حيث يتفاعل الدماغ بشكل أكثر كثافة مع النجاح غير المتوقع، وترتبط هذه الاستجابات العاطفية ارتباطًا وثيقًا بالسلوكيات الإدمانية، حيث يُطور الشخص دافعًا قهريًا لتكرار الفعل، حتى في غياب نتائج ملموسة.
يكمن الخطر في كيف يمكن لهذه المشاعر أن تُضعف مقاومة المرء للأوضاع الفوضوية، إذ يعيش الناس في غزة على شفا كارثة، يضربهم القمع من كل حدب وصوب.
وفي هذا السياق، غالبًا ما يجد الأفراد ممرات الإغاثة مساحةً للتحرر الجسدي والنفسي، وقد تنطوي هذه العملية على مجهود شاق، كالمشي لمسافات طويلة للوصول إلى القوافل، إلى جانب الازدحام والتدافع واحتمالية المواجهات الجسدية.
يُصبح العنف وجهًا آخر لهذه الفوضى، وطريقة بدائية لاستعادة السيطرة، شعورٌ عابرٌ ولكنه ملموسٌ بالحضور في عالمٍ يُعرّف بالغياب والعبث.
السلوك الجماعي
في السياقات الاجتماعية المتجذرة، كالأسر الممتدة، وجماعات الأحياء، ودوائر الأصدقاء، والملاجئ، أو مخيمات النزوح، غالبًا ما يجد الأفراد صعوبة في مقاومة التوافق مع الجماعة، وحتى عندما تتعارض هذه السلوكيات مع القناعات الشخصية، فإنها تنتشر كالعدوى، وفي هذه البيئة، يصبح الذهاب إلى مواقع المساعدة أمرًا طبيعيًا، لأن الجميع يفعلون الشيء نفسه.
يتعلق الجانب الآخر من هذه الظاهرة بالخوف من تفويت الفرصة، وهو ميل سلوكي شائع، يتجلى بشكل خاص في الأسواق المالية، حيث ينشأ ارتفاع الطلب نتيجة الاعتقاد بأن عدم التحرك الآن يعني ضياع الفرصة إلى الأبد.
تزداد هذه الديناميكية في الأيام التي يقل فيها عدد الأشخاص الذين يغامرون بالخروج، سواء بسبب الإرهاق النفسي أو عوامل أخرى، وتصبح ممرات المساعدة فرصة ذهبية لمن يحضرون، حيث يشعر من يفوتهم الوصول بالندم، بينما تضخم قصص النجاحات الفردية، فتُستخدم كأدوات تعبئة، وتُغذي تدفق الناس إلى مواقع المساعدة في اليوم التالي.
نحن نشهد إعادة تشكيل للفرد والمجتمع والسوق والنسيج الاجتماعي الذي يربط الناس ببعضهم، ما تبقى من قدرة إنسانية ذات معنى يتلاشى، تاركًا الفلسطينيين يواجهون مصائر غامضة.
في هذا المسرح المفتوح، تنفذ دولة الاحتلال سياسة ممنهجة لتفكيك الأفراد والهياكل على حد سواء، ممهدة الطريق لمرحلة أخيرة، مرحلة استسلام جماعي، واعتماد نفسي على الظالم، وانهيار الثقة بالمجتمع نفسه.
وهذا بدوره يمهد الطريق لنظام جديد يعلق فيه الناس آمالهم على من يبدو أقوى وأكثر قدرة وأقدر على إطعامهم، وسنكون حينها قد أصبحنا طينًا لينًا، تُشكله دولة الاحتلال كما تشاء أو تُرمى، وتُترك حطامًا بشريًا محطمًا تحت سيطرة أمراء الحرب واللصوص.
هذه هي النتيجة التي توصلت إليها تجربتي الشخصية في زيكيم، آمل أن أتمكن من خلال كتابة هذا من لفت الانتباه إلى الواقع الكارثي الذي يتكشف في غزة، وهو واقع غالبًا ما يُختزل في صور سطحية وتبسيطية تمنعنا من طرح أسئلة أعمق، أو البحث عن إجابات ضرورية لأسئلة من قبيل: ماذا عسانا أن نفعل؟ كيف نوقف هذه الكارثة؟
للاطلاع على المقال الأصلي من (هنا)