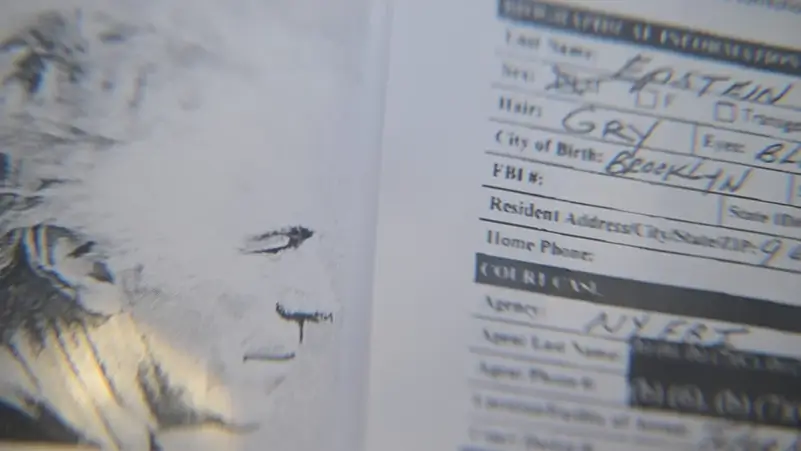بقلم فريد حافظ
ترجمة وتحرير نجاح خاطر
في مقال حديث لمجلة فورين بوليسي، أبرز جون هوفمان الكيفية التي كان القادة الاستبداديون في الشرق الأوسط يستخدمون من خلالها مبادرات الأديان والمشاريع التي ترعاها حكوماتهم لزراعة ما يسمى بالإسلام المعتدل.
وأظهر هوفمان أن الهدف من ذلك الاستخدام كان تبييض السياسات القمعية والعدوانية لأولئك القادة داخلياً وخارجياً.
قد يكون لتداعيات ذلك عواقب بعيدة المدى على السكان المسلمين في أوروبا الغربية، وهو الموضوع الذي غالبًا ما يتم تجاهله.
فبعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وإنهاء استعمار العديد من البلدان الإسلامية وتزايد هجرة شعوب الجنوب من المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة، لم تكن الحكومات الأوروبية في البداية منخرطة بشكل خاص في دين هؤلاء المهاجرين.
ووفقًا للنخب السياسية في أوروبا الغربية، فإن من يُطلق عليهم “العمال الضيوف” من تركيا أو البلقان كانوا سيعودون إما إلى ديارهم مرة أخرى بعد الانتهاء من وظائفهم أو سيندمجون في المجتمع الغربي.
وقد أسندت حكومات أوروبا الغربية بشكل فعال إدارة شؤون المسلمين إلى الدول الموثوقة التي قدموا منها، وهو ما أطلق عليه عالِم السياسة جوناثان لورانس “إسلام السفارة”.
بمجرد أن أدركت هذه النخب السياسية أن المسلمين كانوا يأتون إلى أوروبا للبقاء، تخلت الدول عن الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة الإسلام وبدأت في تنظيم العلاقة بينها وبين رعاياها المسلمين من الناحية الدينية بشكل مباشر.
وفي أواخر التسعينات، وخاصة في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، سيطر الشك على منظور معظم الدول القومية الأوروبية تجاه سكانها المسلمين وتم تقديم سياسات جديدة من قبل وزارات الداخلية المعنية للسيطرة على النشاط الإسلامي داخل تلك البلدان باعتبار المسلمين أهدافاً للمراقبة.
ولكن بعد أن انتشر الربيع العربي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أوائل عام 2001 من القرن الحادي والعشرين، ظهر عامل جديد من شأنه أن يشكل مصير المستقبل للمسلمين الأوروبيين، ألا وهو المستبدون العرب الذين كانوا يخشون فقدان سلطتهم.
ملاحقة الإسلام السياسي
في أعقاب الثورات، خشيت العديد من الممالك الخليجية أن تؤدي الانتفاضات السياسية إلى قيام هياكل ديمقراطية من شأنها أن تمنح السلطة في نهاية المطاف للحركات الإسلامية المنظمة جيدًا، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين.
يبدو أن قيادة الإمارات العربية المتحدة أصبحت مذعورة لدرجة أنها رأت تهديدًا محتملاً في كل منظمة إسلامية غير مرتبطة بجهود الدولة.
لم تقم القوى الإقليمية القوية القائمة والناشئة، مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بقمع الحركات الإسلامية المحلية فحسب، بل دعمت أيضًا الأنظمة الاستبدادية الأخرى مثل الجيش المصري في هجومه على الإسلاميين المنتخبين حديثًا، وأعلنت تلك الحركات منظمات إرهابية.
ولم تتوقف هذه الإجراءات عند حدود منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فمن أجل تعميم سياساتها المتمثلة في إعلان جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية محليًا، مارست هذه الأنظمة أيضًا ضغوطًا لتحقيق الشيء نفسه في بروكسل ولندن وواشنطن.
وفي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، ضغط العديد من القادة الجمهوريين من أجل سن قانون المنظمات الإرهابية الأجنبية، لكنهم فشلوا في النهاية في مواجهة اعتبارات السياسة الخارجية، فالتحذيرات المتزايدة من قبل كبار المسؤولين وممثلي الأنظمة الاستبدادية، حين يجتمعون مع نظرائهم الغربيين، موثقة بشكل جيد.
كما يصاحب هذه السياسة ما هو أكثر خطورة، وهو أن الإمارات لم تكن تطارد جماعة الإخوان فحسب، بل بدأت في استهداف المنظمات الإسلامية الأوروبية.
وكما أظهر ديفيد كيركباتريك مؤخرًا في مقالته الاستقصائية حول الأسرار القذرة لحملة التشهير، فقد تم دفع أموال لمحققين خاصين للبحث في ممارسات منظمات المجتمع المدني الإسلامية في جميع أنحاء أوروبا لنشر شائعات حول صلات مزعومة لها بالإسلاميين.
يأتي هذا كنتيجة أخرى مهمة لحقبة ما بعد الربيع العربي، حيث لم يقتصر سعي العديد من الأنظمة الاستبدادية على تصدير سياساتها الأمنية الداخلية لكسب المزيد من الدعم وإضفاء الشرعية على أهدافها فحسب، وإنما تجاوزه إلى التدخل في السياسات المحلية للدول المضيفة حول كيفية تنظيم الدين الإسلامي.
الطاعة المطلقة
وكما جادل هوفمان، فإن هذه الأنظمة تدعم القراءات السياسية الهادئة للإسلام التي تؤكد على الطاعة المطلقة للسلطة الراسخة، حيث يكون ما يسمى بـ “الإسلام المعتدل” الذي تقدمه الدولة فعالاً في خدمة النظام الاستبدادي.
يمكن للعديد من دول ما بعد الاستعمار مثل مصر والأنظمة الملكية كالإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الاستفادة من تراث وزارات الأوقاف، المصممة أصلاً لإدارة الأوقاف من حقبة ما قبل الاستعمار، ولكن أعيد تصويرها كمؤسسات دينية تسيطر عليها الدولة لتسخير السلطة الدينية لخدمة أهداف الدولة القومية أو النظام.
وتتبع الأنشطة الدينية للحكومة فكرة العلمانية التي تنادي بفصل السلطة الدينية عن سلطة الدولة، لكن المستبدين العرب يريدون أن يصب الدين في خدمة السلطة، وإضفاء الشرعية على الحاكم، حتى لو جلب الأذى.
يمكن لهؤلاء الحكام الاعتماد على تقليد طويل من الفكر الإسلامي السني الذي يفضل النظام والأمن على المعارضة والفوضى المحتملة.
لكن هذه الصورة لا تتناسب حقًا مع التصور الغربي فيما يتعلق بالفصل بين الكنيسة والدولة، حيث يُعتقد أن الطوائف الدينية تتمتع باستقلال ذاتي في مجالها الديني، بعيدًا عن تدخل الدولة والعكس صحيح.
في الواقع، فإن فكرة سيطرة الحكومة على المؤسسات الدينية هي أقرب إلى الأنظمة الشيوعية (ما بعد) الاتحاد السوفيتي السابق أو الصين أو روسيا اليوم، حيث قام كل من الحزب الشيوعي الصيني وروسيا بتدجين الكنائس والمؤسسات الإسلامية التي تدعم سياساتهما.
الأمثلة على ذلك كثيرة ومتشعبة وفي بعض الأحيان تكون قاسية، فالمفتي العام السابق لمصر، علي جمعة، شرّع قتل المتظاهرين ضد الانقلاب العسكري في عام 2013 الذي أطاح بأول رئيس منتخب بديمقراطية نزيهة منذ إعلان مصر جمهوريةً في عام 1952.
أرض خصبة
بشكل عام، فإن وجود نظام ديني تسيطر عليه الدولة يعني ضمناً غياب العديد من الحريات المهمة: من حرية التجمع وحرية الدين إلى حرية التعبير.
وهذا هو المسار الذي تحاول الأنظمة الاستبدادية إقناع صناع السياسة الغربيين باتباعه فيما يتعلق بالمسلمين.
كان وزير الدولة الإماراتي للتسامح قد قال ذات مرة لوكالة الأنباء الألمانية دي بي إيه: “لا يمكن للمرء ببساطة فتح مسجد ودعوة الجميع للحضور وإلقاء الخطب”.
تندمج السياسات الاستبدادية للحكام العرب المستبدين أكثر فأكثر مع السياسات الأوروبية التي تعامل المسلمين بشكل مشبوه كتهديد محتمل.
وبلغ هذا الاندماج مبلغ أن يلقي وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة، عبد الله بن زايد آل نهيان، باللوم على العديد من الدول الأوروبية لإيوائها “متطرفين وإرهابيين قادمين من أوروبا بسبب عدم القدرة على اتخاذ القرار، ومحاولة الحفاظ على الصواب من الناحية السياسية”.
ويبدو أن هذه الأفكار قد استوفت من الناحية المؤسسية، معايير الأرض الخصبة لتلك الحكومات التي قامت بالفعل باستخدام وزاراتها الداخلية لرعاية المسلمين الأوروبيين.
وكشف الصحفيان الاستقصائيان يان فيليبين وأنتون روجيت أن هناك محاولات للضغط على الجمهور الفرنسي لحظر جماعة الإخوان المسلمين.
وفي هذه الأثناء، كان الرئيس إيمانويل ماكرون يضغط من أجل إسلام فرنسي جمهوري معتدل تسيطر عليه الدولة، وتعرضت المنظمات الإسلامية المستقلة، بما في ذلك المنظمات المناهضة للعنصرية، التي انتقدت هذه السياسات لهجوم شرس.
منح ماكرون الزعيم المصري عبد الفتاح السيسي أعلى وسام، متجاهلاً الحملة القمعية الوحشية التي يمارسها المستبد ضد المعارضة المحلية ونشطاء حقوق الإنسان.
وفي النمسا، أدخلت الحكومة اليمينية المحافظة بقيادة المستشار السابق سيباستيان كورتز قانونًا لحظر “الإسلام السياسي” بعد حملة مداهمة واسعة النطاق ضد أعضاء مزعومين في جماعة الإخوان المسلمين، والتي حُكم فيما بعد بأنها كانت غير قانونية.
وبات كورتس، الذي ترك السياسة بعد تحقيق في الفساد، يدعم الآن الإمارات في سياستها الخارجية مع تعميق التعاون في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب.
وبالمثل، أنشأت ألمانيا أقسامًا للدين الإسلامي في الجامعات الحكومية بناءً على نصيحة بعدم وضع التعليم الديني في أيدي المؤسسات الإسلامية غير الحكومية.
رسالة قاتلة
لم يقم الأساتذة المسلمون المشهورون الذين تم الترحيب بهم كأصوات إسلامية لكنها ليبرالية ومتسامحة بتأسيس جمعيات إسلامية تمولها الدولة أو مؤسسات الأحزاب السياسية مثل الاتحاد الديمقراطي المسيحي، لكنهم دعموا القوانين المناهضة للمسلمين وأشادوا بمصر والمملكة العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة لمشاريعها ضد ما يسمى بـ “الإسلام السياسي”.
وزادوا من تأجيج نظريات المؤامرة الكاذبة لإضفاء الشرعية على حملة قمع المجتمع المدني الإسلامي المستقل في أوروبا على التلفزيون المصري الحكومي.
يبدو أن دولًا مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة قد دعمت أيضًا العديد من المسلمين الآخرين، الذين يستخدمون لقب الليبرالية، لكنهم يطالبون بمزيد من المراقبة والسيطرة على المؤسسات الإسلامية غير الحكومية.
تسلط العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، من وزارة الخارجية الأمريكية إلى اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية، الضوء على التمييز المتزايد ضد المسلمين في أوروبا المبرر بمزاعم مكافحة التطرف، خاصة في العامين الماضيين، حتى أن الرئيس جو بايدن تحدث عن الإسلاموفوبيا في بيانه الأخير بمناسبة عيد الفطر.
إن الرسالة من كل هذا إلى مسلمي أوروبا هي رسالة قاتلة مفادها أن العلاقات الاقتصادية تتفوق على حقوق الإنسان، وهذا ما يجعل السياسات الاستبدادية للحكام العرب المستبدين تندمج أكثر فأكثر مع السياسات الأوروبية التي تتعامل مع المسلمين بشكل مريب كتهديد محتمل.
في هذه العملية، يتم تجريد المسلمين أكثر فأكثر من حقوقهم الإنسانية كمواطنين في الديمقراطيات الغربية، وتصبح العلمانية التي عادة ما يتم النظر إليها على أنها مفهوم قاصر بين المسلمين، مستنكرةً على المستوى البنيوي، ويصبح استبداد الدول العربية هو الدليل الجديد والبديل عن العلمانية لتغيير مصير المسلمين في أوروبا.
للإطلاع على النص الأصلي من (هنا)