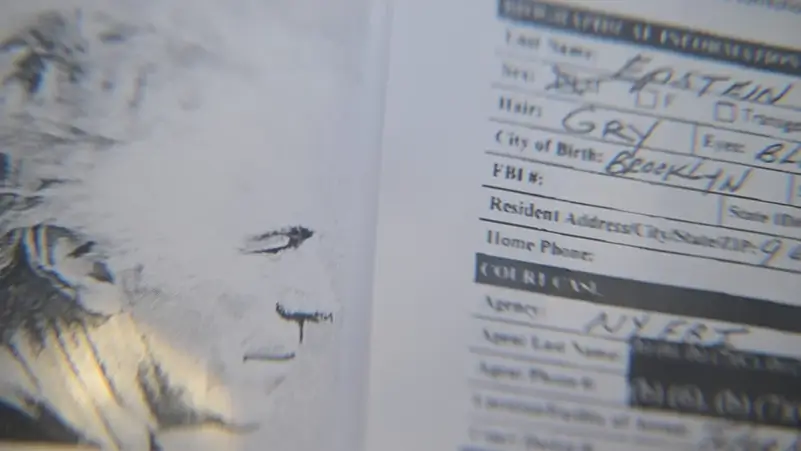بقلم أحمد درملي
ترجمة وتحرير مريم الحمد
ذهبت أخيراً إلى منزل أختي هيا، بعد ما يقرب من 5 أشهر على تدميره بالغارات الجوية الإسرائيلية، وذلك بهدف جمع الأثاث والمواد الأخرى لاستخدامها كحطب وجمع ما قد يفيد مما بقي موجوداً في المنزل.
حاولت في البداية تجنب ألم الذهاب إلى هناك، فقد كونت ذكريات غنية في منزلها الذي أصبح الآن تحت الأنقاض، فقد كانت هناك أوقات كنت أجلس فيها أنا وأختي معاً نتحدث مع فنجان من القهوة أو حين ألجأ إليها هرباً من الأماكن المزدحمة من حولي فأجد في منزلها مكاناً هادئاً للكتابة والجلوس مع أفكاري.
كان لدى هيا وزوجها همام محل صغير لبيع الزهور والديكور المنزلي في الطابق الأرضي من المبنى الذي يسكنان فيه، فقد كان منزلهما مليئاً بالتفاصيل الجميلة، التي كانت أشبه بمتحف فني صغير.
شعرت بالعرق البارد يتصبب من ظهري خوفاً من قصف مفاجئ، إذ تقصف طائرات الاحتلال المنازل المدمرة دائماً بدعوى وجود مقاومين يختبئون بين الأنقاض
لقد كان هناك تناغم بين الأرائك الأرجوانية اللون والسجاد البيج والستائر البيضاء، وكان هناك ركن للزهور الطبيعية وآخر لفن التطريز الفلاحي الذي كانت تصنعه هيا، كما كانت غرفة أطفالهم تحتوي على رف كتب على شكل شجرة على الحائط، وكانت هناك طاولة طعام كبيرة كانت مكاني المفضل للكتابة.
في 15 مايو الماضي، تعرض المبنى المكون من 5 طوابق لموجة مكثفة من الغارات الجوية طالت حي شارع الوحدة، وهو حي مكتظ بالسكان في وسط مدينة غزة، وقد كان هذا القصف هو الأفظع منذ آخر مجزرة شهدها الحي قبل عامين في مايو عام 2021، والتي أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 44 فلسطينياً.
كانت هيا وهمام وأطفالهما محظوظون لأنهم استطاعوا الفرار إلى الجنوب قبل استهداف بنايتهم، فقد حوصر 25 فرداً من عائلة همام في الداخل لمدة 15 يوماً أثناء التوغل الإسرائيلي في الحي، ولم ينجُ إلا شخص واحد فقط، فيما لا تزال جثث الآخرين مدفونة تحت الأنقاض.
ذكريات بعيدة
كنت على وشك الخروج من الحمام عندما تلقينا أخباراً عن أقارب همام، حيث انضممت إلى عائلتي في غرفة المعيشة وقد جلسوا في صمت مخيف ووجوههم شاحبة، فسألتهم: “من استشهد؟”، فتمتمت أمي بألم: “لقد قصف منزل هيا واستشهد كل من فيه، صب الله غضبه على إسرائيل”، فعدت إلى الحمام على الفور وأخذت أبكي على مصيرنا الذي بدا مليئاً بخسارة مجهولة لا نهاية لها!
بعد أسابيع من الاجتياح الإسرائيلي للحي، حاولت تجنب المرور من ذلك الشارع، فلم أكن أرغب في تقبل حقيقة أن المنزل قد دمر وأن الأشخاص الطيبين الذين عاشوا فيه ما زالوا تحت الأنقاض.
فجأة أصبحت كل لحظة قضيتها هناك مجرد ذكرى، وكأن ذكرياتنا في غزة تشبه أشجار الزيتون، عميقة الجذور ويصعب اقتلاعها رغم التكلفة المؤلمة للمقاومة.
تعتمد عائلتي، مثل معظم الفلسطينيين في غزة خاصة أولئك الذين بقوا في الشمال، على الحطب للطهي وغلي الماء، فلم يدخل غاز الطهي إلى غزة منذ أكتوبر من العام الماضي، فأصبح الكثير من الناس يقومون بجمع الأخشاب من بقايا منازلهم المدمرة أو قطع الأشجار الموجودة في الشوارع، كما قام البعض باستخدام ملابسهم وأثاثهم لإشعال النار، وبالنسبة لعائلتي، فقد استخدمنا أثاثنا القديم أولاً ثم اشترينا بعض الحطب رغم كون ذلك أمراً صعباً مع استمرار الحرب لأكثر من عام حتى الآن.
تحركنا بسرعة، فقد علمتنا هذه الحرب أن نكون مستعدين دائماً للضربة التالية ومعها الفرار، ولكني كنت أشعر بقلبي يخفق في صدري بينما كنا نقف على الحطام
كان الذهاب إلى منزل هيا خياري الوحيد للحصول على الحطب، وقد شعرت بالإرهاق لأنها كانت المرة الأولى التي أذهب فيها إلى هناك، ليس من أجل الزيارة أو مشاركة فنجان من القهوة أو الكتابة، ولكن لجمع ما تبقى من المنزل المدمر!
ذهبت مع صديقين حتى إذا حدث شيء لأحدنا يقوم الآخرين بالمساعدة، فقد علمتنا هذه الحرب ألا نفعل أي شيء بمفردنا، فإذا استشهد أحدنا، على الأقل سيعرف شخص ما بذلك.
استطعنا الوصول للمنزل من خلال أنقاض منزل أحد الجيران المدمر جزئياً، وهناك ألجمت في مكاني عندما اجتاحتني الذكريات مثل موجة ساحقة ومؤلمة، فكل ذكرى من ذلك المنزل كانت أمامي وكأنها مشاهد من فيلم بعيد.
في لحظة، سمعت الهمسات والضحكات والدموع والأحاديث التي ملأت هذا المكان ذات يوم، وشعرت وكأنني في كابوس حتى أعادني صوت صديقي وسام وقد وجد قطعاً كبيرة من الخشب، ثم حفرنا عميقاً في الأنقاض بحثاً عن المزيد، وكانت تلك اللحظات مليئة بمزيج غريب من المشاعر، بين مرارة عندما عثرت على الملابس وألبومات الصور وقطع الأثاث المكسورة، وشعور بالحزن على الأشخاص الذين ما زالوا تحت الأنقاض على بعد أمتار قليلة منا.
أصبحت مخدراً أمام الدمار
كانت نبضات قلبي تتسارع كلما لمست أي قطعة أثاث، فقد كان ذهني يدرك أن المكان الذي كان يبدو وكأنه منزل في السابق قد تحول الآن إلى ركام، ومع ذلك الشعور امتزج شعور طفيف بالارتياح مع كل قطعة خشب وجدناها كما لو كنا نستخرج كنزاً مدفوناً.
رغم الدمار الكبير الذي حل بالمنزل، إلا أنني حاولت البحث عن أشياء لم أتمكن من العثور عليها أبداً، مثل الكرسي الذي كنت أجلس عليه والمرآة الكبيرة ذات الإطار المطرز المعلقة في غرفة المعيشة والصورة العائلية التي استقبلتني ذات مرة في ممر المنزل وغير ذلك من القطع التي لا يمكن تعويضها.
تحركنا بسرعة، فقد علمتنا هذه الحرب أن نكون مستعدين دائماً للضربة التالية ومعها الفرار، ولكني كنت أشعر بقلبي يخفق في صدري بينما كنا نقف على الحطام، فمن ناحية، كنت أتخيل أن الحطام الذي كان فوقنا من الممكن أن ينهار على رؤوسنا في أي لحظة، ومن ناحية أخرى، شعرت بالعرق البارد يتصبب من ظهري خوفاً من قصف مفاجئ، إذ تقصف طائرات الاحتلال المنازل المدمرة دائماً بدعوى وجود مقاومين يختبئون بين الأنقاض.
توقفنا بعد 5 ساعات من التنقيب المستمر، فقد حل علينا الليل ولم أكن قد أدركت حتى تلك اللحظة أن يدي وملابسي ملطخة بالدماء من تحريك قطع الزجاج والحجر، فقد جعلني الدم أدرك كم أصبحت مخدراً أمام الدمار الذي يحيط بي.
عدت إلى المنزل على عربة مليئة بالخشب، وفي الطريق كان الناس يحدقون بنا بأعين ملؤها إما الحسد أو اليأس، حتى أن رجلاً أخذ ينظر إلينا وكأننا نملك عربة مليئة بالذهب فقال: “لن تحتاج إلى شراء الحطب لعدة أشهر”، فيما اقتربت منا امرأة وقالت ببؤس: “لا توجد قطعة خشب واحدة في منزلي، فقد كنت أبحث لساعات في الشوارع دون أن يحالفني الحظ، من فضلك أعطني الحطب حتى أتمكن من طهي الطعام لأطفالي”، فأعطيتها بعضًا منه، دون أن أتمكن من أشرح لها أنه لم يكن مجرد حطب، بل كان كومة من الذكريات!
للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)