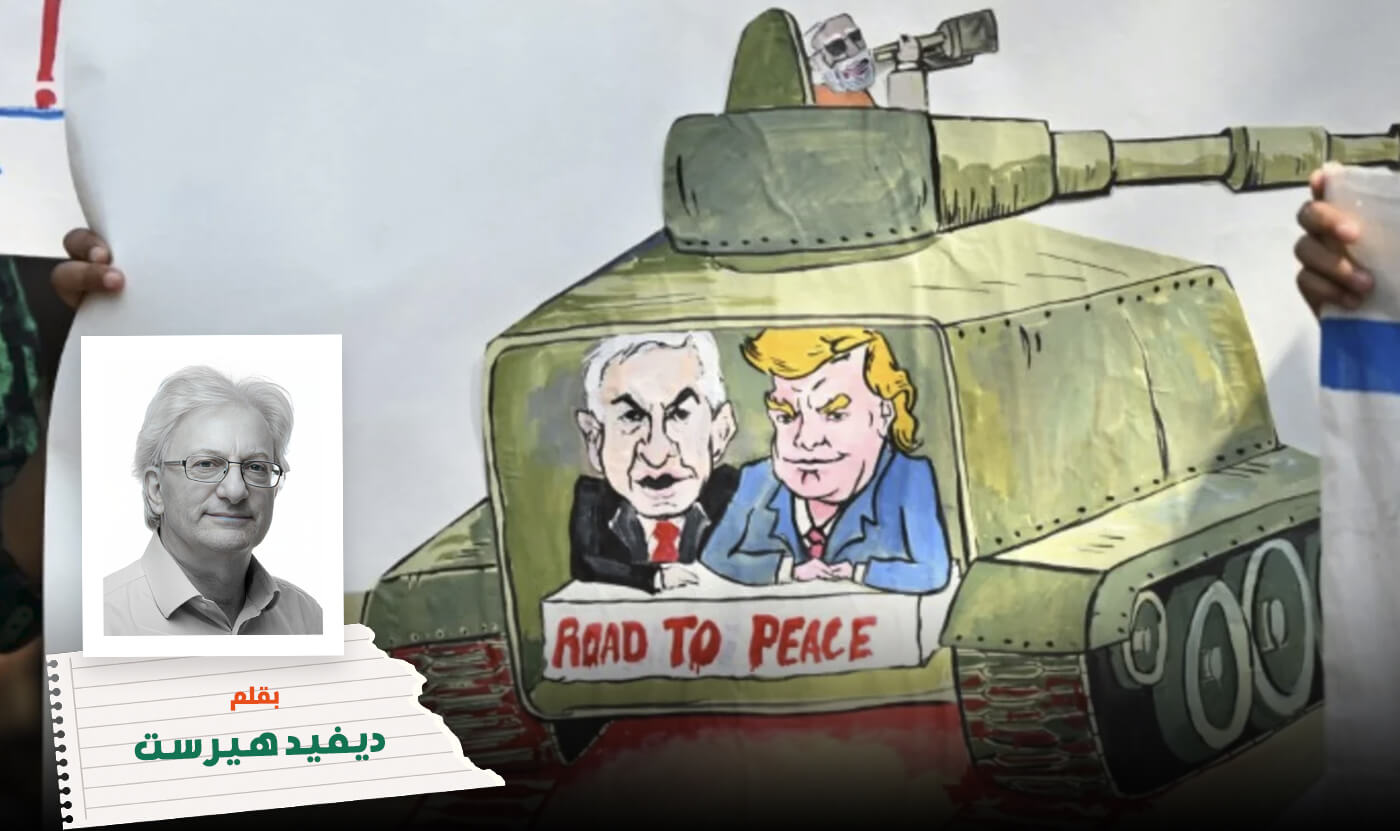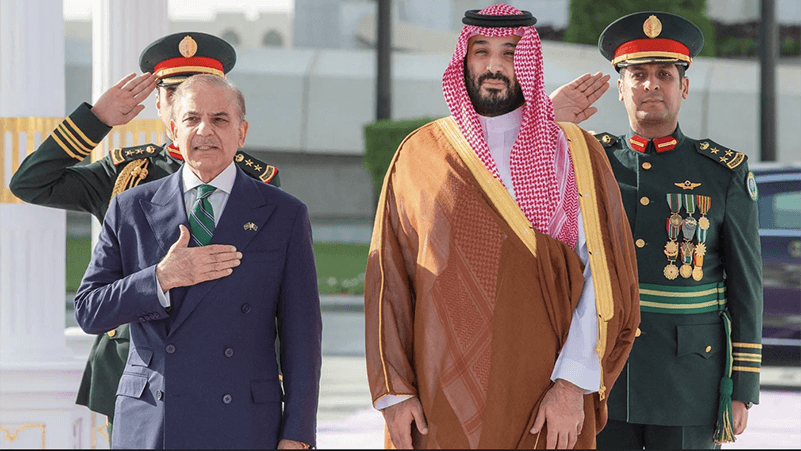بقلم جوين دانيال
ترجمة وتحرير نجاح خاطر
في مقالته المميزة “إذن بالرواية”، والتي نشرت في مجلة (London Review of Books) في فبراير/شباط 1984، كتب إدوارد سعيد: “لم يتم الاعتراف رسمياً بالرواية الفلسطينية في التاريخ الإسرائيلي، إلا باعتبارها سردًا لغير اليهود، الذين كان وجودهم الخامل في فلسطين مصدر إزعاج يجب تجاهله أو حتى طردهم”.
وكما أنه لا يمكن النظر إلى العبارة المشينة “أرض بلا شعب” باعتبارها مجرد كذبة تم نشرها لأغراض سياسية فحسب، بل وأيضًا باعتبارها طموحًا استعماريًا استيطانيًا مستمرًا، فقد اختار سعيد كلمة “خامل” لا للوصف، ولكن لاستحضار الخيال الصهيوني حول الوجود الفلسطيني المثالي.
ربما كان من الواجب على المستعمر أن يكون هذا الوجود المثالي بلا حياة أو “مختفيًا”، ولكن نظرًا لإصرار الفلسطينيين العنيد على البقاء على أرضهم، فمن الأفضل أن يتسببوا في أقل قدر ممكن من الإزعاج للمستعمرين.
وإلى جانب عدم إظهار الهوية الثقافية، يجب ألا يكون هناك شغف ولا فخر ولا فرح ولا حزن ولا غضب، بل يجب ألا تكون هناك مشاعر واضحة قد تزعج مضطهديهم.
وقد قال عالم النفس الفلسطيني الراحل أديب جرار في عام 2016: “يجب أن نكون الشعب المضطهد الوحيد الذي تتمثل مهمته في جعل مضطهدينا يشعرون بالرضا عن أنفسهم”.
وسوف أعود لاحقاً إلى النرجسية المتطرفة التي تميز العديد من التفاعلات الإسرائيلية مع الفلسطينيين.
إن السياق المباشر لهذه المقالة هو الأمر الإسرائيلي الذي يقضي بأنه لا ينبغي للفلسطينيين الذين يرحبون بعودة أحبائهم في أولى عمليات تبادل الأسرى كجزء من وقف إطلاق النار في غزة أن يظهروا أي فرح أو احتفال علني.
وقد تعززت هذه الأوامر باستباق الجنود إلى منازل عائلات أولئك المحررين قبيل وصول أبنائها، حيث كان أغلب الأسرى المفرج عنهم في الجولة الأولى للتبادل من النساء اللاتي تعرضن للاحتجاز غير القانوني، ولم يصلن إلى بيوتهن إلا في الساعات الأولى من الفجر، وغني عن القول إن كل من انتظر عودتهن استقبلهن بفرحة عارمة.
تناقض صارخ
ينبغي لنا أن نتوقف ونطرح السؤال التالي: ما الذي تعنيه هذه المحاولة لحظر الفرح العام؟ إنها تتناقض بشكل صارخ مع التدفق العام للعواطف الذي استقبل به إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.
يعكس هذا النرجسية والشعور بالاستحقاق والاعتقاد بأن مشاعر المواطنين اليهود فقط هي التي تهم، حيث يتعزز هذا الشعور بالاستحقاق بسبب الحصانة التي تمنحها الحكومات الغربية لإسرائيل للنظر فقط في مصالحها الخاصة.
كما تعكس وسائل الإعلام الرئيسية هذا الشعور، فهي تغطي معاناة الأسرى الإسرائيليين وأسرهم بالتفصيل، وتشرح رواياتهم وتشير إليهم دائمًا كأفراد وبالاسم، في حين يتم تصوير الفلسطينيين القابعين في السجون الإسرائيلية على أنهم كتلة غير مكتملة، ونادرًا ما يتم إرفاق قصص شخصية عنهم.
فعلى سبيل المثال، نشرت صحيفة نيويورك تايمز قصصًا إنسانية مطولة عن الجنديات الإسرائيليات المفرج عنهن، لكنها فشلت في تغطية اعتقال الدكتور البطل حسام أبو صفية بأي تفاصيل.
إن محاولة قمع مظاهر العواطف التي تتحدى الظالمين راسخة بعمق في نظرة عالمية عنصرية وغير إنسانية
لقد تم تكرار هذا التركيز على مشاعر اليهود الإسرائيليين فقط، فيما لا يزال يُطلب من أي شخص يتحدث عن معاناة الفلسطينيين أن يدين أولاً هجمات حماس في 7 أكتوبر 2023.
وبأي حال من الأحوال، ودون تجاهل صدمة ذلك اليوم للإسرائيليين، يمكننا أن نرى كيف تم تكثيف هذه الصدمة من خلال التغطية المستمرة على وسائل الإعلام الإسرائيلية، والتي عززت الشعور بالخوف وعززت اللامبالاة المروعة تجاه الإبادة الجماعية التي تشن على بعد أقل من 80 كيلومتراً من تل أبيب.
لقد أشارت المؤلفة نعومي كلاين إلى هذا باعتباره “تسليح الصدمة”، وهي تزعم أنه يتم الحفاظ على حالة الصدمة منذ 7 أكتوبر بحيث لا يمكن التعافي منها أبدًا، مما يبقي الناس في حالة من العاطفة الخام التي تمنع أي إمكانية للتعاطف أو التحليل المدروس أو أي شعور بالذنب أو العار بشأن الحملة الإبادة الجماعية التي تجري باسمهم.
والحقيقة أن الوجه الآخر لهذه العاطفة المفرطة هو رفض قبول أن الفلسطينيين يحق لهم إظهار أي مشاعر، ووصف مثل هذه المشاعر بأنها تهديد، وعليه، فإن “حظر الفرح” يتناسب مع نمط من المراقبة ليس فقط لحركات الفلسطينيين وأنشطتهم وكلامهم، بل وأيضاً لمشاعرهم.
إن مراقبة المشاعر هي جانب آخر من التدخل العميق للدولة الاستعمارية الاستيطانية في العوالم الذاتية والحميمة للشعب الخاضع، فعلى سبيل المثال، فإن الفلسطينيين الذين يتم احتجازهم لساعات عند نقطة تفتيش ويعبرون عن إحباطهم بالصراخ أو إطلاق أبواق سياراتهم معرضون للعقاب، ونتيجة لهذا، يتعين قمع مشاعر الغضب والعنف.
ورقة مساومة
تخضع المظاهر العامة للعواطف، سواء كانت فرحة بإطلاق سراح الأسرى أو حزنا على دفن الشهداء، لرقابة شديدة وبطرق متعددة، فلطالما اعتاد الاحتلال على رفض إعادة جثث الفلسطينيين الذين تعرضوا للقتل خارج نطاق القضاء، والذين يتهمون دائما بهجمات إرهابية، ولكن يتم اغتيالهم قبل أن تتاح لهم الفرصة للمثول أمام المحكمة، وفي هذه الحالات، غالبا ما يتم الاحتفاظ بالجثة كورقة مساومة، ووسيلة للسيطرة.
وقد اعترف وزير حرب الاحتلال السابق موشيه يعلون في عام 2015 بأن دولته رفضت إعادة جثث الفلسطينيين الشهداء ما لم يتم التعهد بإقامة جنازاتهم “كشأن عائلي متواضع خلال الليل”، وأضاف: “حيثما كان هناك التزام بالجنازات الهادئة والمتواضعة، سنستمر في إعادة الجثث، وحيثما لا يكون هناك التزام، فلن نعيدها، حتى لو كان ذلك يعني دفنها هنا”.
إن الضيق الذي تعاني منه الأسر الفلسطينية بسبب اضطرارها إلى دفن أحبائها في ظل هذه الظروف المفروضة يتفاقم بسبب عدم قدرتها على أداء طقوس الدفن الإسلامية والحالة السيئة للغاية لجثة مجمدة منذ أسابيع، لكن التعبيرات عن الضيق التي تثيرها هذه الظروف التي لا تطاق ينظر إليها من هم في السلطة فقط على أنها تهديد سياسي.
لقد رأى دينيس روس، الدبلوماسي الأمريكي والصهيوني الملتزم، ذات يوم أنه من المناسب أن يعلن: “في وقت الانتفاضة الثانية، كانت الجنازات العامة تُستخدم لتعبئة الحشود الكبيرة والغضب وتغذية نوع المشاعر التي تروج للعنف ضد الإسرائيليين”، وبالتالي، يُنظر إلى المشاعر والعواطف فقط من حيث التأثير الذي تخلفه على إسرائيل.
لقد ارتكب أحد أكثر الأمثلة فظاعة لتعطيل الحزن العام في عام 2022 في جنازة الصحفية الشهيرة في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة في القدس الشرقية المحتلة، حين هاجم الجنود الإسرائيليون حاملي النعش، مما تسبب في سقوط نعشها على الأرض.
إن حقيقة أنهم رأوا أن من المناسب القيام بذلك في جنازة امرأة كانت شخصية رمزية محبوبة من قبل الملايين في العالم العربي، وعلاوة على ذلك، قتلها جندي إسرائيلي، تشير إلى مدى ضآلة اهتمام إسرائيل والولايات المتحدة بالتسبب في الأذى أو الإساءة للرأي العام العربي.
مجردة من السياق
وعلى حد تعبير سعيد عن تعليقه حول الحقائق، فإن المشاعر “لا تتحدث عن نفسها على الإطلاق، بل تتطلب سردًا مقبولًا اجتماعيًا لاستيعابها ودعمها وتداولها”، إن كيفية “سرد” المشاعر هي وظيفة القوة، وفي سياق من اختلال التوازن الشديد في القوة، يُسمح فقط لمشاعر أولئك الذين يتمتعون بالسلطة بالحساب.
ومع ذلك، فقد شارك الآلاف من العلماء والصحفيين والناشطين والشعراء والروائيين الفلسطينيين في السرديات التاريخية التي تشكل التجربة الفلسطينية المعاصرة وبالتالي وضعوا الأفعال والمشاعر بما في ذلك المشاعر الانتقامية في السابع من أكتوبر في سياقها.
إن رفض إسرائيل والمدافعين عنها ربط الأفعال الفلسطينية بأي تاريخ أو سياق، إلى جانب تصويرهم لكل أشكال المقاومة على أنها “إرهاب” وإنكارهم لما ينتجه سياق غير صالح للعيش، كل هذا يفضح ممارسات القوة العقيمة، والحاجة إلى “مراقبة العواطف” باعتبارها في نهاية المطاف علامة على الضعف والهشاشة.
في اليوم الأول لوقف إطلاق النار في غزة، خرجت ثلاث شابات إسرائيليات من الأسر إلى النور وسط تعبيرات من الفرحة التي لن يحسدهن عليها أو على أسرهن إلا القليلون.
وفي منتصف تلك الليلة، خرجت تسعون امرأة وطفلاً فلسطينياً من ظلمة أسرهم، لا يعود اختيار الليل لإطلاق سراح الأسرى إلى خجل المحتلين من الطريقة التي عاملوهم بها، على الرغم من أن كل من رأى صور السياسية خالدة جرار بعد عام من الأسر يعرف مدى العار الذي لحق بالمحتل نتيجة لهذه المعاملة، بل لأن المحتلين يعتبرون الأسر هو المصير اللائق للفلسطينيين.
وليس المقصود أن يخرج الأسرى إلى نور بهيج، حيث إن محاولة قمع مظاهر العواطف التي تتحدى الظالمين راسخة بعمق في رؤية عالمية عنصرية لا إنسانية.
لقد رفضت عائلات المعتقلين المفرج عنهم هذا التجريد من الإنسانية وأصرت على الاحتفال، وهذا يشكل عملاً من أعمال المقاومة، ومع ذلك، فإن كلمة “مقاومة” تنقل رد فعل على الظلم، مما يمنح الظالم قدراً كبيراً من القوة.
إنها أكثر من مجرد مقاومة، فهي إصرار على الحق في الحياة والقدرة على العيش والحرية في إعطاء صوت لكل المشاعر الإنسانية، سواء كانت الفرح أو الحزن أو الغضب أو الكبرياء.
للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)