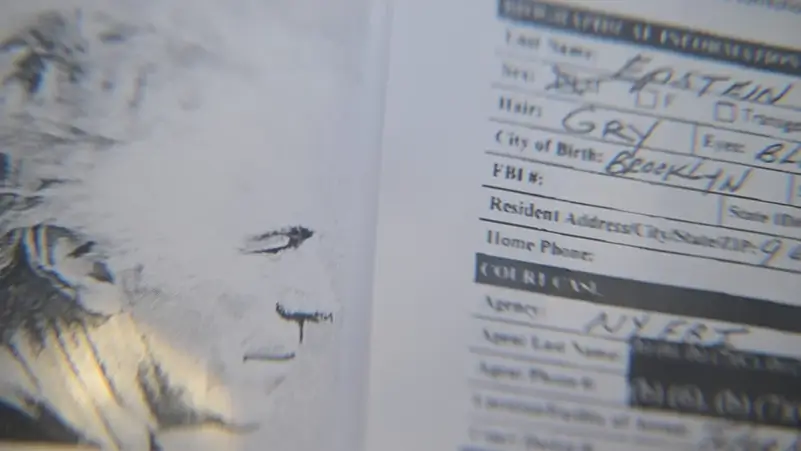بقلم حسام الحملاوي
ترجمة وتحرير نجاح خاطر
في ظل تواصل الحرب الإسرائيلية الفلسطينية، تزايدت المخاوف في جميع عواصم المنطقة، وأبرزها القاهرة.
يجد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الديكتاتور العسكري الذي يحكم مصر منذ العقد الماضي، فرصًا إيجابية وكذلك مخاطر جسيمة في كل مرة تواجه فيها المقاومة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي.
وخلال عهدي الرئيسين السابقين أنور السادات وحسني مبارك، عززت مصر دورها كأداة لتحقيق الاستقرار في المنطقة وفقًا لمصالح الولايات المتحدة، المتمثلة في حماية أمن دولة إسرائيل من خلال ضمان عدم شن المزيد من الحروب من قبل الجيوش العربية التقليدية بالإضافة إلى لعب دور الوسيط بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
إلا أن هذه “الوساطة”، خاصة منذ سيطرة حماس على قطاع غزة في عام 2007، تعني فعليًا الضغط على المقاومة الفلسطينية لتهدئة عملياتها أو قبول التنازلات السياسية.
واستخدمت القاهرة أوراقاً مختلفة لتنفيذ مثل هذه المخططات، بما في ذلك التعاون الأمني مع حركة فتح والسلطة الفلسطينية، والأهم من ذلك إدارة معبر رفح الحدودي، شريان الحياة الوحيد بالنسبة إلى غزة الذي لا يخضع لسيطرة تل أبيب.
ولم تكن القاهرة وسيطاً محايداً، فقد اندلعت حرب غزة عام 2008 بعد وقت قصير من لقاء وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني بمبارك في مصر، كما شارك مبارك في فرض الحصار الكارثي على غزة، ما تسبب في أزمة إنسانية حادة، وسط انتقادات مستمرة من قبل مسؤولو الدولة ووسائل الإعلام المصرية لحماس.
و عقب انقلاب عام 2013، سارعت مصر مباشرة إلى تشديد الحصار على غزة وأغلقت معبر رفح لفترات طويلة من الزمن.
ولتسليط الضوء على الأصول المشتركة لحماس ومنظمة الإخوان المسلمين المصرية، زعمت وسائل الإعلام أن الإخوان المسلمين هم المسؤولون عن هجمات نفذت ضد جنود في سيناء بالإضافة إلى حوادث أخرى، وهو ما نفته حماس.
القمع والمقاومة
شهدت حرب 2014 تواطؤ مصر بشكل كامل مع إسرائيل في العمل من أجل القضاء على حماس، مع فرض عقاب جماعي على السكان الفلسطينيين في غزة.
وينبع هذا من عاملين رئيسيين: الأول هو التحالف الوثيق الذي نشأ بين مصر وإسرائيل بعد الانقلاب، والذي شهد سماح القاهرة للقوات الجوية الإسرائيلية بشن ضربات سرية في سيناء ضد أهداف “إرهابية” مزعومة، وتدخل إسرائيل في الولايات المتحدة نيابة عن مصر لفتح الطريق أمام المساعدات العسكرية.
أما العامل الثاني فهو هجوم السيسي على أي قضية تبناها الثوار خلال ثورة 2011، وهي قضية تحتاج إلى دراسة أكثر تعمقاً، لأن كلاً من الأمل واليأس، والقمع والمقاومة، هي مفاهيم جدلية شائكة.
ولطالما كانت القضية الفلسطينية عاملاً رئيسياً في تأجيج أجيال من الشباب المصري، وبمثابة بوابتهم إلى المعارضة المناهضة للنظام.
ففي حين أن معظم الأدبيات المتعلقة بالحركات الاجتماعية العالمية عام 1968 تميل إلى التركيز على تمردات الطلاب والعمال في الشمال العالمي، إلا أن احتجاجات جماهيرية حدثت بالفعل أيضًا في الجنوب العالمي، بما في ذلك مصر.
وبعد خيبة أمل جزئية في الرئيس السابق جمال عبد الناصر بعد هزيمة مصر في حرب عام 1967، تم إحياء الحركة الطلابية في وقت لاحق، التي طالبت بإصلاحات ديمقراطية وبمحاسبة قيادة الجيش، كما انطلقت “الموجة الثالثة” من الشيوعية المصرية عام 1968.
كان النشطاء المؤيدون لفلسطين في الجامعات المصرية جزءًا أساسيًا من هذه الحركة الاجتماعية الجديدة، التي بلغت ذروتها مع “انتفاضة الخبز” عام 1977، والتي أثارتها المراسيم النيوليبرالية التي رفعت الدعم عن السلع الأساسية، ما اضطر السادات في النهاية إلى إلغاء هذه الخطة وإرسال الجيش لقمع الانتفاضة.
السيطرة على سيناء
وبعد عقود، وقعت الثورة المصرية عام 2011 كذروة لعملية معارضة طويلة الأمد بدأت عام 2000 مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وكما بقية الأنظمة العربية، لم يلتزم النظام المصري بالحقوق الفلسطينية، بل نظر إلى المقاومة الفلسطينية المسلحة والشعبية كمصدر لعدم الاستقرار، و كنموذج يمكن أن يتبعه المعارضون المصريون.
لكن عداء السيسي تجاه حماس بدأ يتحول تدريجياً إلى تقارب نسبي منذ عام 2017، فمن ناحية، أثبتت حماس قدرتها على الصمود، ومن ناحية أخرى، في ظل مواجهة الخسائر البشرية في قتال المتمردين في سيناء، كانت مصر بحاجة إلى مساعدة حماس في السيطرة على تدفق المتمردين والأسلحة من غزة، إلى جانب السيطرة على طرق الهروب إلى رفح.
وتضمن ذلك التقارب تخفيف الحصار، وفتح معبر رفح، وعقد اجتماعات مع قادة حماس في جهود التوسط للتوصل إلى هدنة طويلة مع إسرائيل، إلا أن الوضع الإنساني في غزة لم يتحسن بشكل كبير، وظلت السياسة الخارجية لمصر تعتمد على المبادئ التوجيهية الأمريكية، والتي وصلت إلى مستويات متطرفة جديدة في ظل إدارة ترامب.
كما أن انتخاب الرئيس جو بايدن عام 2020 افتتح فصلاً جديدًا في العلاقات بين مصر وغزة، فقبل توليه منصبه، تعهد بايدن بمحاسبة “الديكتاتور المفضل” لترامب، وكان خطاب حقوق الإنسان يشكل أولوية قصوى في الحزب الديمقراطي، بقيادة جناحه “التقدمي”.
لكن اندلاع حرب غزة عام 2021 كان بمثابة فرصة ذهبية للسيسي لتقديم نفسه على أنه “وسيط” موثوق يمكنه التأثير على حماس مع ضمان أمن إسرائيل، حيث تمكنت مصر بالفعل من التوسط لوقف إطلاق النار، ما منح السيسي إشادة من إدارة بايدن.
ومنذ ذلك الحين، استأنفت القاهرة دورها المعتاد، حيث عملت على وقف التصعيد وإطلاق النار كلما اندلعت توترات بين إسرائيل والفلسطينيين، في مقابل اكتساب نفوذ سياسي لدى واشنطن والعواصم الغربية الأخرى. وكان ضمان الهدوء يعني أيضاً استخدام معبر رفح كورقة مساومة مع حماس، ونقل المعلومات الاستخبارية إلى إسرائيل حول أية مخاطر وشيكة.
وفي خضم الحرب الحالية، يتوجب على السيسي أن يسير على حبل مشدود، فهو يعرض نفسه على زعماء العالم، الذين انتقد بعضهم سجله في مجال حقوق الإنسان، كوسيط ذي مصداقية يحاول وقف التصعيد.
لكن السيسي في الوقت نفسه يشعر بالقلق من أن كارثة إنسانية قد تجبر اللاجئين الفلسطينيين على الانتقال إلى مصر، وبالتالي قد تثير حالة من عدم الاستقرار السياسي الداخلي.
فقد صرّح السيسي علنًا أنه يرفض أي اقتراح لنقل الفلسطينيين إلى سيناء، واقترح بدلاً من ذلك نقلهم إلى صحراء النقب “حتى تنجز إسرائيل مهمتها المعلنة بتصفية المقاومة”.
ومع ذلك، أفاد موقع مدى مصر، وهو موقع إعلامي محلي مستقل، أن هناك مفاوضات جارية حيث كانت القاهرة على وشك قبول إعادة توطين الفلسطينيين في شبه الجزيرة مقابل حوافز مالية.
لكن إدارة الموقع أزالت التقرير في وقت لاحق، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بـ “الأمن القومي”.
مخاطر الاضطرابات
لكن الأمر الأكثر خطورة بالنسبة للسيسي هو التداعيات المحلية المحتملة، حيث يشعر المصريون بالإحباط بسبب تدهور مستويات المعيشة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، إلا أن فوز السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، على الرغم من تراجع شعبيته، هو أمر مؤكد ببساطة بسبب قضائه على المنافسين الجادين، حيث سيتم حشد أجهزة الدولة لصالح المستبد.
وخلال الأسبوع الماضي، اندلعت احتجاجات عفوية تضامناً مع الفلسطينيين في حرم الجامعات وفي النقابات المهنية وفي المساجد وبعض الساحات العامة.
وتعتبر مثل هذه المستويات من التعبئة غير مسبوقة في مرحلة ما بعد الانقلاب، حيث تذكرنا بالعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حينما أحيت الانتفاضة الفلسطينية الثانية احتجاجات الشارع في عهد مبارك.
فمنذ يوم الأربعاء، والدولة منخرطة في بعض التحركات في الشوارع، حيث أمرت السلطات موظفي الخدمة المدنية أو تم توجيههم من قبل حزب مستقبل وطن الذي تديره الأجهزة الأمنية بعقد تجمعات عامة، لدعم “موقف السيسي المتحدي للأوامر الإسرائيلية دفاعًا عن الأمن القومي المصري “.
وما من شك أن هذه التحركات تحاول نزع فتيل الغضب الشعبي الذي يمكن أن يتطور إلى احتجاجات مناهضة للنظام، ومن ناحية أخرى، فمن المحتمل أن تساعد السيسي في التفاوض على صفقة أفضل مع إسرائيل، إذا ما قبل خطة إعادة التوطين أو في حال قرر إيقافها.
إلا أن الاحتجاجات المتواصلة تعمل على تطبيع سياسة الشارع مرة أخرى، فالبلاد، حتى بعد قمع السيسي للمعارضة المنظمة، أصبحت بمثابة برميل بارود جاهز للانفجار، بينما يمكن لفلسطين أن تكون بمثابة الزناد، في حال لم يقف إطلاق النار بسرعة.
للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)