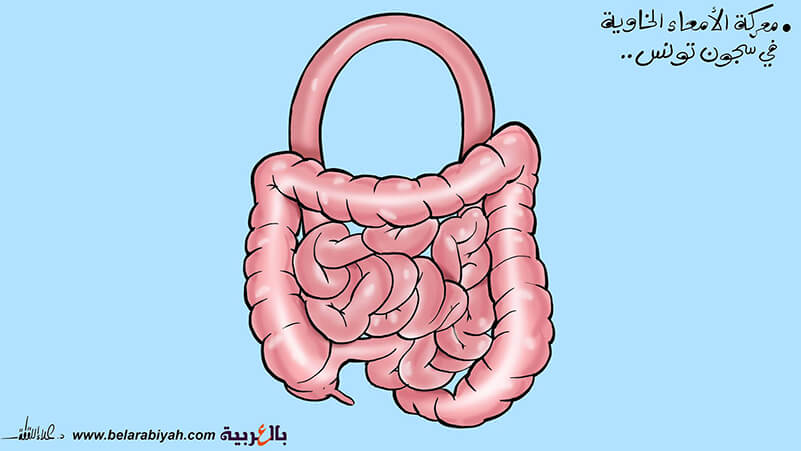بقلم حسام الحملاوي
ترجمة وتحرير نجاح خاطر
من المقرر أن تجري مصر الانتخابات الرئاسية في نهاية العام الجاري، ومن المتوقع ظهور النتائج بحلول منتصف كانون الأول/ ديسمبر، أو كانون الثاني/ يناير في حال تم الذهاب لإجراء جولة الإعادة.
لا يوجد الكثير من التشويق فيما يتعلق بالنتيجة: سيفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي.
خلال صيف 2013، قاد السيسي، وزير الدفاع آنذاك، انقلاباً عسكرياً ضد أول رئيس منتخب ديمقراطياً في البلاد، محمد مرسي، وعبر ركوب موجة الخوف الجماعي واللعب على وتر الطبقة المتوسطة التواقة إلى الاستقرار بعد ثورة 2011، أطلق السيسي العنان لحمام دمٍ لتهدئة الوضع.
وفي الوقت ذاته، وعد المصريين بالرخاء الاقتصادي و بمستقبل وردي ما جعل البلاد تغرق في هوس السيسي، وأصبح هناك مجال للقول إنه فاز حقًا بأول انتخابات رئاسية بعد انقلاب عام 2014، سواء كانت مزورة أم لا.
لكن شعبية السيسي أخذت بالتراجع منذ ذلك الحين، حيث أهدر المليارات على مشاريعه الضخمة، وقمع المعارضة من جميع الأطياف، ودمّر منظمات المجتمع المدني، وعسكر أجهزة الدولة، وأفقر المصريين من خلال تخفيضات متتالية لقيمة العملة، إلى جانب السياسات النيوليبرالية الصارمة التي تركت الاقتصاد في حالة من الفوضى، تحت سيطرة جنرالات الجيش.
وبرغم أن التلويح بالعلم و الشوفينية الوطنية أمران أساسيان في الخطاب العام للسيسي، إلا أن مصر فقدت الكثير من نفوذها الإقليمي في السنوات الأخيرة، إذ يعتمد النظام على الدعم المستمر من الطغاة في الخليج العربي، وتحديداً في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ومؤخراً قطر.
وفي خطوة جعلت الكثيرين يشعرون بالإهانة الوطنية، تخلى النظام عن جزيرتين استراتيجيتين في البحر الأحمر للسعودية مقابل الدعم المالي، وشهدت مصر أيضًا انخفاضًا حادًا في أهميتها في مناطق نفوذها التاريخية، مثل فلسطين والسودان، ناهيك عن دول حوض النيل الأخرى، حيث تهدد إثيوبيا موارد مصر المائية من خلال إقامة السد، على الرغم من معارضة القاهرة الشديدة للخطة.
سلسلة القيادة الموازية
لقد استهزأ السيسي بسيادة القانون من خلال السيطرة على القضاء، وضمان الإفلات من العقاب على جرائم القتل على أيدي الشرطة والجيش، وتعديل الدستور لإطالة أمد حكمه، بالإضافة إلى تشييد مجمعات السجون الضخمة لإيواء الأعداد المتزايدة من المعارضين خلف القضبان.
لم يعد الوزراء والمسؤولون التنفيذيون الحكوميون صانعي سياسات ولم يعودوا يتمتعون بالحق باتخاذ المبادرات، بل، أصبحت البلاد تدار بشكل تفصيلي من قبل السيسي وأبنائه واللواء عباس كامل، مدير جهاز المخابرات العامة المصرية، إلى جانب سلسلة موازية من القيادة تتكون من عصابة من ضباط الجيش العاملين والمتقاعدين الذين يشغلون المناصب في جميع الدوائر الحكومية.
إن السبب المنطقي لخوض المعارضين للانتخابات هو ببساطة قتل السيسي للسياسة وإلغائه أي هوامش للاحتشاد في الشوارع أو في الفضاء الإلكتروني
وفي الدورتين الانتخابيتين السابقتين، في عامي 2014 و2018، أُعلن فوز السيسي بنسبة 97% تقريبًا من الأصوات في كل مرة، وكما هو متوقع، قامت وسائل الإعلام المصرية، والتي تخضع في الغالب لسيطرة جهاز المخابرات العامة، في الأسابيع الأخيرة، بنشر تأييدات داعمة للسيسي من رجال الأعمال والنقابات المهنية والعمالية التي تهيمن عليها الدولة، ونجوم السينما والمطربين.
وفي الوقت نفسه، قامت الشرطة بتوزيع عبوات من السلع الاستهلاكية الأساسية على فقراء المناطق الحضرية في جميع أنحاء البلاد، مع طباعة وجه السيسي المبتسم على كل عبوة، كأداة للدعاية الانتخابية.
وفي يوم الاثنين، مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن البدء الرسمي للمنافسة نشرت وسائل الإعلام صوراً لمصريين “يندفعون” إلى مكاتب التسجيل المحلية للتوقيع على تأييد السيسي.
ووفقاً لمصادري الخاصة، فقد تم نقل العاملين والموظفين الحكوميين بالحافلات من قبل إدارات شركاتهم للمشاركة في مهازل التأييد هذه.
ويشترط القانون على أي مرشح يتطلع إلى الترشح للانتخابات أن يجمع، من الآن وحتى 8 تشرين الثاني/ نوفمبر، إما 20 تأييدًا من أعضاء البرلمان (الذي يهيمن عليه حزب “مستقبل الوطن” الداعم للنظام)، أو يحصل على تأييد 25 ألف مواطن على الأقل من 15 محافظة، وبما لا يقل عن 1000 مؤيد في كل محافظة، في خوارزميةٍ تجعل من المستحيل تقريبًا على أي منافس جاد تحدي السيسي.
تصويت احتجاجي
تتباين وجهات النظر الخاصة بالناشطين المحبطين والمقيدين، والمواطنين بشكل عام، حول ما يجب القيام به، حيث دعا البعض إلى المقاطعة لأن النتيجة النهائية معروفة مسبقاً.
وبناءً على هذا الاعتقاد، يُنظر إلى العديد من المتنافسين الذين يعتزمون خوض الانتخابات ضد السيسي بعين الريبة، باعتبارهم متعاونين لا بد وأنهم عقدوا صفقة ما مع الأجهزة الأمنية، ومن المؤكد أن هذا الوصف ينطبق على بعض السياسيين، الذين يؤيدون النظام بقوة أو لديهم تاريخ من التعاون مع الدولة.
كما يؤيد تيار آخر من المعارضة وعامة الشعب المشاركة في الانتخابات، لكن من خلال التصويت الاحتجاجي للمعارضة “الحقيقية”، وهنا، تصبح الأمور أكثر تعقيدًا.
فلغاية وقت كتابة هذا التقرير، أعلنت ثلاث شخصيات من أحزاب المعارضة نيتها الترشح للانتخابات: أحمد طنطاوي، البرلماني السابق عن حزب الكرامة الناصري، جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور شبه الليبرالي، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
من المؤكد أن المنافس الأكثر جدية بين المرشحين الثلاثة هو طنطاوي، فهو سياسي محنك من محافظة كفر الشيخ شكّل مصدر إزعاج للنظام حينما كان نائباً حتى أنه خسر مقعده لاحقاً بسبب تزوير الأجهزة الأمنية للتصويت، وكان قد انتقد السيسي علناً ودعاه إلى ترك منصبه، ما أثار غضب الدكتاتور وأجبر طنطاوي على مغادرة مصر إلى لبنان العام الماضي.
وبينما يقيم بالمنفى، أعلن طنطاوي عن نيته الترشح للرئاسة، وعاد إلى مصر في شهر أيار/ مايو الماضي، وأخذ منذ ذلك الحين يُعد حملة جادة على الأرض، على الرغم من الحملات الأمنية المتكررة التي طالت أقاربه والناشطين في الحملة.
تصدّر طنطاوي الأخبار الدولية مؤخرًا عندما تم اكتشاف استهداف جهاز الآيفون الخاص به ببرامج تجسس (على الأرجح من قبل النظام المصري)، ما دفع شركة أبل إلى نشر تحديثات أمنية لجميع منتجاتها.
وفي الوقت ذاته، اتُهم إسماعيل وزهران في وقت سابق من هذا العام بالاجتماع مع رئيس المخابرات المصرية، حيث زُعم أن الأخير شجعهما على الترشح للانتخابات لتوفير واجهة ديمقراطية، فيما نفى كلاهما هذا الاتهام.
ولم تصل المناقشات الرامية إلى توحيد صفوف المعارضة للوقوف خلف مرشح واحد إلى أي نتيجة، ما يجعل فوز السيسي في هذا السباق شبه مؤكد، ليس بسبب شعبيته، بل لسيطرته على مؤسسات الدولة وأجهزتها القمعية المخيفة، فإن السبب المنطقي لدى المعارضين لخوض الانتخابات هو ببساطة قتل السيسي للسياسة وإلغائه أي هامش للحشد والتنظيم في الشوارع أو في الفضاء الإلكتروني.
والآن بعد أن بات النظام أضعف وأقل ثقة مما كان عليه قبل عقد من الزمان، حيث يرجع الفضل في ذلك في المقام الأول إلى أخطائه الاقتصادية الفادحة، فإن الانتخابات تقدم فرصة نادرة لإحياء القدرة على التنظيم، على مستوى متواضع على الأقل، حيث يقول الناشطون إن هذه خطوة على الطريق الطويل نحو استعادة الحق في النزول إلى الشوارع.
للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)