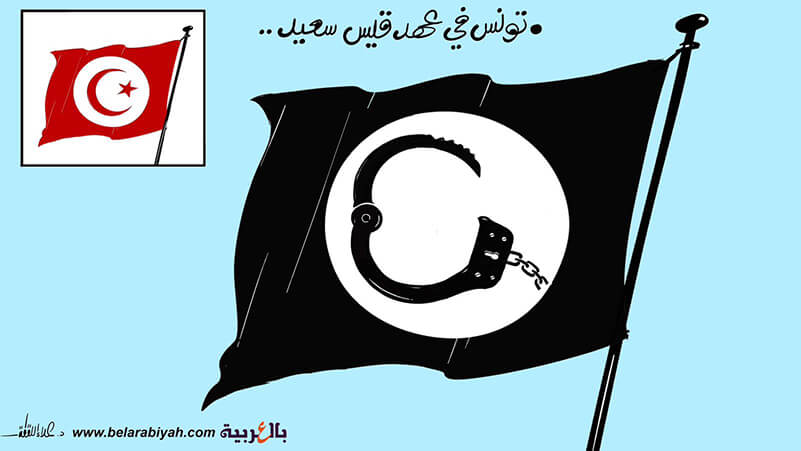بقلم بتول دوغان أكاش
ترجمة وتحرير موقع بالعربية
في خضمّ التحولات الإقليمية المتسارعة، برزت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السعودية كحدث يتجاوز البروتوكول الدبلوماسي، ليعكس إعادة تموضع أوسع في سياسات المنطقة.
فقد جاءت الزيارة في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الرياض وأبوظبي، على خلفية تضارب المصالح في اليمن والقرن الإفريقي، بالتزامن مع تكهنات حول احتمال انضمام تركيا إلى ترتيبات عسكرية تقودها السعودية وباكستان.
وعلى الرغم من تعدد الملفات الساخنة، يبقى السؤال المحوري اليوم: أين تقف تركيا ضمن ما يسميه ولي العهد محمد بن سلمان بـ “السعودية الجديدة”؟
منذ اغتيال الصحفي جمال خاشقجي عام 2018، انتهج محمد بن سلمان سياسة خارجية أكثر حذرًا، مفضّلًا خفض الانخراط الإقليمي والتركيز على مشروعه الداخلي الطموح، ولم يكن ذلك تراجعًا اضطراريًا بقدر ما كان خيارًا استراتيجيًا محسوبًا.
ذلك أن “السعودية الجديدة” التي يسعى ولي العهد إلى تكريسها لم تعد مستعدة لحمل الأعباء الجماعية للعالم العربي، بعد إخفاقات مكلفة في اليمن وسوريا، وعقب عقود من الصراع المفتوح في فلسطين.
غير أن هذا التوجه بدأ يشهد مراجعة تدريجية، لا سيما بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا في ديسمبر/كانون الأول 2024، وهو حدث أعاد رسم ملامح التوازنات الإقليمية، ودفع السعودية إلى استعادة دور أكثر فاعلية في محيطها، بهدف إعادة تعريف سياستها الخارجية وموقعها القيادي.
“السعودية الجديدة”.. هوية داخلية بامتياز
ويبدو الطابع الداخلي لـ “السعودية الجديدة” متجذراً في رؤية 2030، التي تضع أنماط حياة جديدة تشمل السياحة وإعادة صياغة التاريخ والهوية في صلب مشروعها، إلا أن هذا التحول البارز لا يخلو من إشكاليات، إذ يعيد رسم حدود الانتماء الوطني وتعريف من هو السعودي؟ وبأي شروط؟
وتستند هذه الرؤية إلى مجموعة عوامل متداخلة من بينها التحوّل الديموغرافي الذي وضع نحو ثلثي السكان تحت عتبة سن الثلاثين، والحاجة الملحّة لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، وترسيخ سلطة محمد بن سلمان مؤسسيًا ولا سيما تعيينه رئيسًا للوزراء عام 2022 إضافة إلى إعادة تعريف مفهوم “السعودية” نفسها، عبر تعزيز دور الملكية والهوية الوطنية، مقابل تراجع النفوذ الوهابي التقليدي.
إن هذه العناصر مجتمعة تتيح صياغة “خيال وطني” جديد، تُعاد فيه كتابة العلاقة بين الدولة والمجتمع، وبين الماضي والمستقبل.
مفترق طرق سعودي
واليوم، تقف السعودية عند مفترق طرق حاسم، فالهويّة الجديدة تسعى إلى تصدير صورة الاستقرار والحداثة، داخليًا وخارجيًا، لكنها لا يمكن أن تُفرض بالكامل من أعلى.
إن نجاح هذا المشروع مرهون بتفاعل السعوديين أنفسهم وما إذا كانوا سيعتنقون السرديات الجديدة للتاريخ والتراث ونمط الحياة، أم سيحاولون إنتاج صيغ بديلة للانتماء؟
ضمن هذا السياق، لا يبدو التركيز الداخلي لولي العهد تفصيلًا ثانويًا، بل يشكّل حجر الزاوية في استراتيجيته السياسية.
غير أن هذه المقاربة، من منظور إقليمي، تفرض حاجة ملحّة إلى شركاء موثوقين يعززون الحضور الدبلوماسي للرياض.
ففي اليمن، أدى منح الإمارات الأولوية لمصالحها الوطنية الضيقة على حساب أهداف التحالف الذي تقوده السعودية إلى تعميق التوترات بين الطرفين، أما في فلسطين، فرغم اقتراب الرياض من التطبيع مع دولة الاحتلال قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، فإن تحقيق تهدئة حقيقية في غزة ما زال يُعلَن كأولوية رسمية.
قد يسعى محمد بن سلمان إلى ربط عهده بمرحلة جديدة من الحراك الإقليمي، لكن ذلك يتطلب أولًا شركاء يعتمد عليهم.
سياسة خارجية أقل عبئاً وأكثر تشاركًا
ما يميّز “السعودية الجديدة” عن مقاربات سابقة هو أن الرياض لم تعد راغبة في تحمّل أعباء الشرق الأوسط وحدها، غير أن هذا التحول لا يخص السعودية فقط، فحلفاؤها ومنافسوها تغيّروا أيضاً، كما يظهر بوضوح في المشهد اليمني.
واليوم، يواجه محمد بن سلمان تحدي إعادة معايرة استراتيجيته، بما يراعي صعود أدوار قوى إقليمية مثل قطر والإمارات، والانتقال من منطق الهيمنة إلى منطق تقاسم النفوذ.
في هذا الإطار، تبرز تركيا بوصفها شريكًا محتملًا يحظى بقبول متزايد في الرياض، خاصة في ظل دورها الإقليمي الذي اتسم خلال السنوات الأخيرة بالسعي إلى تثبيت الاستقرار، والمشاركة في جهود التهدئة في غزة، ودعم الدول القائمة في إفريقيا واليمن، بدل الرهان على الميليشيات غير الحكومية.
هذا التقارب يمنح محمد بن سلمان هامش مناورة أوسع للحفاظ على قدر من الاستقرار الإقليمي، في مقابل سياسات إماراتية أكثر اندفاعًا وتدخلًا.
محور قوة آخذ في التشكل
تُبرز احتمالية مشاركة تركيا في الترتيبات العسكرية السعودية–الباكستانية، رغم أنها لم تتبلور بعد، ملامح محور قوة إقليمي جديد قيد التشكل.
وبالنسبة لأنقرة، فإن الموازنة بين المواقف الإقليمية المتباينة لكل من الإمارات والسعودية تتطلب قدرًا عاليًا من الدقة السياسية، خاصة في ظل تنافس خليجي محتدم على النفوذ.
ففي ختام زيارة أردوغان إلى الرياض الأسبوع الماضي، أصدر الزعيمان السعودي والتركي بيانًا مشتركًا عبّرا فيه عن رفضهما اعتراف دولة الاحتلال الأخير بما يُسمّى “أرض الصومال”، وأكدا دعمهما الكامل لوحدة الأراضي الصومالية.
وأعاد أردوغان التأكيد على هذا الموقف في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط، واصفًا الخطوة التي أقدمت عليها دولة الاحتلال بأنها “غير شرعية وباطلة”.
هذا التوافق لم يكن معزولًا عن السياق الأوسع، ففي اليمن، تتقاطع مواقف أنقرة والرياض عند دعم وحدة البلاد، وهو ما يضعهما في خندق واحد ضد النزعات الانفصالية الجنوبية التي غذّت أحد أكثر النزاعات تعقيدًا في المنطقة، وهذا التقارب يعكس إدراكًا مشتركًا بأن تفكيك الدول لا يخدم سوى الفوضى الممتدة.
كما أشار الجانبان إلى تطابق مواقفهما بشأن الحفاظ على وحدة السودان، والسعي إلى وقف الحرب في غزة، والمطالبة بانسحاب فوري لقوات الاحتلال من الأراضي السورية.
وفي الملف السوري تحديدًا، شدد أردوغان على أن معيار بلاده يتمثل في أن “سوريا لا تشكل تهديدًا لجيرانها، ولا توفر ملاذًا للتنظيمات الإرهابية، وتحتضن جميع مكونات المجتمع على أساس المواطنة المتساوية”.
في المقابل، برزت السعودية كداعم رئيسي لمسار توحيد السلطة في سوريا تحت قيادة الرئيس أحمد الشرع.
غير أنه إذا أُريد لهذا المسار أن ينجح ويجنّب البلاد موجات توتر جديدة، لا بد أن يقوم على إعادة دمج المكونات المختلفة في النسيج الوطني، من أكراد وعلويين ودروز، إضافة إلى مجتمعات الشتات السوري.
وتدرك كل من الرياض وأنقرة أن قيام دولة سورية موحدة وشاملة ليس خيارًا أخلاقيًا فحسب، بل ضرورة استراتيجية لمنع إعادة إنتاج دوائر العنف والتطرف، ولإغلاق أبواب التدخلات الخارجية التي طالما استثمرت في هشاشة الدولة.
الدفاع والتكنولوجيا.. ركيزة الشراكة المقبلة
تشكل العلاقات الدفاعية محورًا أساسيًا في مسار التقارب الراهن، فقد سبق أن وقّعت شركات سعودية وتركية اتفاقيات في مجال الصناعات الدفاعية، ركزت خصوصًا على نقل التكنولوجيا، في إطار سعي الرياض إلى تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي العسكري، بما في ذلك تطوير صناعة الطائرات المسيّرة.
وفي البيان المشترك الأخير، اتفق البلدان على تفعيل اتفاقيات التعاون الدفاعي القائمة، لمواجهة الجريمة المنظمة والتطرف والإرهاب.
ويعكس هذا التوجه رغبة متبادلة في تحويل التقارب السياسي إلى شراكات عملية طويلة الأمد، تتجاوز ردود الفعل الظرفية إلى تأسيس بنى تعاون مؤسسية.
نحو شراكة مفتوحة على الاحتمالات
من الواضح أن السعودية لم تعد في موقع الجمود، لا على المستوى الداخلي ولا في سياستها الإقليمية، فهي تعيد صياغة صورتها وتحالفاتها في آن واحد، مدفوعة برغبة في ترسيخ “السعودية الجديدة” كقوة مستقرة وحديثة، غير أن السؤال الجوهري يبقى: هل ستنجح هذه المقاربة في الصمود أمام تعقيدات الإقليم وتقلباته؟
في هذا المشهد المتغير، تبرز تركيا كشريك يمتلك خبرة سياسية وعسكرية، وقدرة على المناورة بين المحاور، دون الانزلاق الكامل إلى سياسات التدخل الصدامي.
وإذا ما استمر هذا التقارب، فقد يشكّل ركيزة أساسية لمرحلة جديدة من التوازن الإقليمي، تقوم على تقاسم الأدوار بدل احتكارها، وعلى إدارة الأزمات بدل تغذيتها.
يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الشراكة ستتطور إلى تحالف مستدام، أم أنها ستظل محكومة بحدود المصالح المتغيرة، لكن المؤكد أن “السعودية الجديدة”، وهي تعيد تعريف ذاتها، لا تستطيع خوض هذا المسار منفردة.
للاطلاع على المقال الأصلي من (هنا)