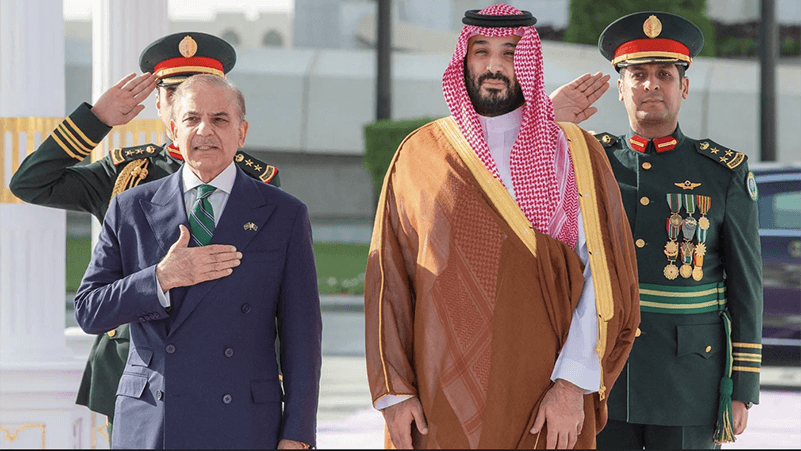بينما تم نسيان أصولهم في الغالب، تشرح الكاتبة ديانا دارك كيف كان للثقافة العثمانية تأثير كبير على أوروبا.
بعد مرور مئة عام على انتهاء الإمبراطورية العثمانية والذي صادف الأول من نوفمبر/ تشرين ثاني لعام 1922، يحين الوقت لإلقاء نظرة من جديد على العثمانيين.
استمر حكم الإمبراطورية العثمانية لأكثر من ستة قرون، بين عامَي 1299 و1922، وامتدت رقعة الأرض التي بسطوا سيطرتهم عليها بين ثلاث قارات: أوروبا وآسيا وإفريقيا، وحكموا أكثر من 70 إثنية عرقية ناطقة بأكثر من 12 لغة مختلفة، وحكمت إمبراطوريتهم مساحة أكثر اتساعاً من الدولة البيزنطية، واستمرت لمدة أطول من الإمبراطورية الرومانية.
ومع ذلك، يبدو الأمر كما لو أن العثمانيين، كشعب، قد اختفوا، وأُهمل إرثهم، وأحيانًا تم تجاهله عن عمد.
في كثير من الأحيان كان هناك تركيز مشوه على السنوات الكارثية الأخيرة، على حساب الصورة الأوسع، فلذلك أصبح من الجدير النظر في الأسباب الكامنة وراء تعميرهم الملحوظ وخاصة دراسة سنواتهم الأولى عندما تم تشكيل مبادئهم التوجيهية.
ويكشف شعار الإمبراطورية، “الدولة الخالدة”، عن مستوى الطموح العثماني.
وتقول الكاتبة أنه من الصعب تغيير الصور النمطية لكن الحقيقة المزعجة تتجلى في وصف الإمبراطورية العثمانية بعبارة “رجل أوروبا المريض” والتي استخدمها لأول مرة دبلوماسي إسباني في وصف سابق لإنجلترا في القرن الخامس عشر الميلادي، حيث تبين خلال الحصار الثاني لفيينا عام 1683، كيف قاتل حوالي 100000 مسيحي مجري مع الجانب العثماني، مثلما فعل الآلاف من الإغريق والأرمن والسلاف والبروتستانت الترانسيلفانيين، محبطين من الحماسة الكاثوليكية لآل هابسبورغ والرسوم الإقطاعية لأرستقراطيتهم.
لم يكن أي من الجانبين ملائكة بالطبع، لكن الرواية التي تقاتل فيها أوروبا المسيحية الشجاعة ضد شرق مسلم مستبد هي نسخة ديزني من التاريخ.
الإمبراطورية العثمانية والتجمعات البشرية
جذبت الامبراطورية العثمانية تجمعات بشرية متنوعة وعرضت عليهم الحماية، وهي فلسفة تمثل النقيض تماماً من مفهوم الدولة القومية المعاصرة.
الأدلة على عالمية المواطنة في دولتهم، والنهج الجامع يتجلى بوضوح حتى يومنا هذا في الإرث المعماري لمراكز المدن العثمانية في ربوع إمبراطوريتهم السابقة.
اعترفت منظمة اليونسكو بمدينة بورصة، أول عاصمة عثمانية، بأنها موقع تراث عالمي في عام 2014، وذلك بسبب “عملية تخطيطها المعماري غير المسبوقة وقيم المجتمع” التي عكستها.
وصارت نموذجاً لجميع المدن العثمانية التي شُيدت لاحقاً، فصُممت لخدمة الاحتياجات المجتمعية والتجارية والدينية والتعليمية والصحية للمجتمع من خلال ما يعرف بمجمع “الكلية”، حيث كان مسجد أولو جامع، أو الجامع الأعظم، محاطاً بالخانات والأسواق، بجانب المدارس والمستشفيات والحمامات وسبل المياه ومطاعم الفقراء.
إن المجتمع العثماني الذي تسوده أجواء المساواة، حيث يعيش المسلمون والمسيحيون واليهود ويعملون جنبًا إلى جنب، في ظل تقدير مهارات الجميع التي جلبوها للمجتمع، يعد أحد العوامل الرئيسة في تعمير العثمانيين، فعلى سبيل المثال لا يزال بازار بورصة ينبض بالحياة حتى يومنا هذا، إذ يعتبر المركز التجاري للمدينة.
في النظام العالمي العثماني، كان التجار والحرفيون الماهرون يحظون باحترام وتقدير كبير، اعترافاً بالقيمة التي يمنحونها لمجتمعاتهم ولخزانة الدولة من خلال الإيرادات التي يدرونها.
تكرر النموذج في العاصمة الثانية للعثمانيين في أديرنة، ثم في القسطنطينية “إسطنبول حالياً”، حيث لا يزال البازار الكبير يحتوي على 4 آلاف متجر متوزع على 61 شارعاً مغطى.
وكان نفس النهج المعتمد على المجتمع واضحاً في سلوكيات العثمانيين تجاه اللاجئين، ومنذ البداية – وحتى النهاية – تم الترحيب باللاجئين، سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو يهود أو أي أقلية أخرى تعاني من الاضطهاد، ليصبحوا مواطنين عثمانيين ويحصلون على حماية الدولة العثمانية.
لقد مُنحوا المال والأرض لمساعدتهم على الوقوف على أقدامهم، مقابل أن يصبحوا – بعد فترة سماح مناسبة – مواطنين يدفعون الضرائب، أحرارًا في العبادة كما يشاءون وفي استخدام محاكمهم الخاصة.
كان الإنصاف مبدأ إرشادياً بالنسبة للحكومة، استناداً إلى نظام “دائرة العدل”، حيث اعتمد السلطان والجيش والشعب بعضهم على بعض وأدركت الدولة أن بقاءها ارتبط بازدهار رعاياها.
جرى تعديل قيم الضرائب لتعكس الازدهار النسبي، حيث فرضت على القرى الغنية الواقعة على الأنهار الخصبة معدلات أعلى من القرى الفقيرة القريبة من أراضي الصحراء والسهول، فمثلا بعد الجفاف أو المجاعات أو الحروب، تم تخفيض الضرائب أو حتى التنازل عنها لصالح تشجيع الانتعاش الاقتصادي.
الموروثات الثقافية
ويعتبر المطبخ العثماني أساس ما يشار إليه عادة بـ “حمية البحر المتوسط الصحية”، مع وجود أسماء على شاكلة الزبادي والبقلاوة والكباب، التي تبقى شاهدةً على أصولها التركية.
ففي المطابخ الكبيرة لقصر طوب قابي، كان يُوظف 60 طاهياً يُنتدبون من جميع أنحاء الإمبراطورية بعد اختبارات مضنية وكانت الوصفات الأكثر تعقيداً وتطوراً تظل سرية، ولم تُدوّن قط، وتعتمد على المكونات الطازجة.
وشاع انتشار محال القهوة في أرجاء الإمبراطورية، حيث وصلت إلى العاصمة العثمانية في خمسينيات القرن السادس عشر عن طريق ميناء المخا في اليمن.
وعرف السلطان سليمان القانوني بعشقه للقهوة، وهو الذي أسس الطقوس المرتبطة باحتسائها تحت مسمى وظيفة “صانع القهوة الرئيس”، التي تضمنت الكؤوس الخزفية المطرزة المصنوعة بحرفية فريدة في أفران إزنيق وكوتاهية.
انتشرت عادة شرب القهوة من إسطنبول إلى باقي أوروبا بعد أن أدى فشل حصار فيينا الثاني إلى تخلي الجيش العثماني عن كميات كبيرة من المؤن، بما فيها حمولة من حبوب القهوة.
وفي حينه لم يكن الأوروبيون يعرفون كيفية تحضير مشروب القهوة باستثناء ضابط بولندي كان سجيناً سابقاً لدى العثمانيين؛ و يعود إليه الفضل في صنع القهوة بالأسلوب المتعارف عليه في فيينا الان.
وفي عام 1700 بلغ عدد متاجر القهوة في لندن ما يقارب الـ 500 متجر، وكانت تعرف باسم “جامعات البنس”؛ لأن كوب القهوة كان يباع ببنس واحد فقط وكان المفكرون من النخب في ذلك العصر يرتادون تلك المقاهي لاحتساء القهوة خلال مناقشاتهم للمواضيع الهامة.
وفي يومنا الحالي تشرب جميع دول البلقان فعلياً القهوة التركية، بالإضافة إلى البلاد العربية، ويعاد تهيئتها بصور أخرى، مثل القهوة العربية والتركية والبلغارية والألبانية وغيرها، مع جميع طقوسها المألوفة المتعلقة بالصداقة وحسن الضيافة.
وتعد الخيام الكبيرة من بين الموروثات العثمانية وهي النسخ القديمة من السرادقات التي تُنصب في عصرنا الحالي، والتي تعود إلى القرون التي شهدت الهجرات البدوية لكونها توفر مساحات كبيرة متعددة الاستخدامات وتتمتع بمرونة عالية.
ومن أفخم هذه الخيام ما كان يغطَّى بالخيوط المطرزة الحريرية والفضية والذهبية ذات الأشكال الجميلة والتي تصور لوحات تشبه البلاط المزين برسومات فنية كحدائق الفردوس المكتنزة بزهور التوليب، الذي يعد رمزا للعثمانيين.
كان الحكام الأوروبيون، ومن بينهم لويس الرابع عشر ملك فرنسا، من كبار هواة الخيام العثمانية، وصارت الخيام التركية موضة تُستخدم بوصفها أماكن لإقامة الحفلات الكبرى.
بالإضافة إلى الخيام لا تزال الأريكة المبطنة التي تحتوي على مساحة تخزينية داخلية، توصف بـ “العثمانية” في عصرنا الحالي، وكانت قطعة أثاث متعددة الاستخدامات؛ فعادة ما تكون غنية بالوسائد، وهو إرث بدوي آخر يسمح للمفروشات والأثاث أن تؤدي أكثر من غرض في وقت واحد.
صممت الملابس العثمانية في أوروبا لتوفر الراحة والمرونة، فقد كانت ملابس النساء على وجه الخصوص متأثرة بالذوق العثماني والجانب العملي، بل إن حفيدة الملكة فيكتوريا، ألكسندرا فيودوروفنا، آخر إمبراطورة لروسيا، كانت ترتدي قفطاناً فضفاضاً عند تتويجها في عام 1896، على النقيض تماماً من الفساتين المشدودة التي كانت ترتديها النساء من المجتمع الراقي.
أصبح القفطان جزءاً من الثقافة التي انتشرت في الستينيات، أسفل الجلابيب الملونة، حيث كانت النساء التركيات يرتدين نفس السراويل الواسعة مثل الرجال، كي يستطعن القتال بجانبهم ويمتطين الخيول، بل كن يحملن الرضع من الأطفال بحزام فوق ظهورهن.
جلبت أولى النسويات السراويل إلى إنجلترا، بعد أن شاهدنها في الديار العثمانية، ومن هناك انتشرت إلى أمريكا، وحملت اسم “بلومرز” على اسم أميليا بلومر، التي عرفت بدفاعها عن حقوق المرأة، قبل أن تنسى أصولها العثمانية.
حتى المناشف، التي كانت منتشرة في الأصل في الحمامات التركية بوصفها قطعاً ذات حلقات ومصنوعة من القماش الذي يمتص المياه، فلم تصبح شائعة الاستخدام في الغرب قبل أن تتبنى صناعتها الشركة الإنجليزية كريستي آند سونز بعد أن رأتها في البازار الكبير بإسطنبول، وتبنت تصنيعها في خمسينيات القرن التاسع عشر.
لا تزال الموروثات العثمانية بين أيدينا تثري حياتنا بشكل يومي، ولكن قليلا من الناس لا يزالون على قيد الحياة ممن يمكنهم تذكر التراث الثقافي العثماني الفريد – الذي تجلى بالعيش في تلك المدن متعددة الأعراق والأديان في جميع أنحاء الإمبراطورية، من إزمير وسالونيك والقدس إلى دمشق وحلب وحتى اسطنبول نفسها.