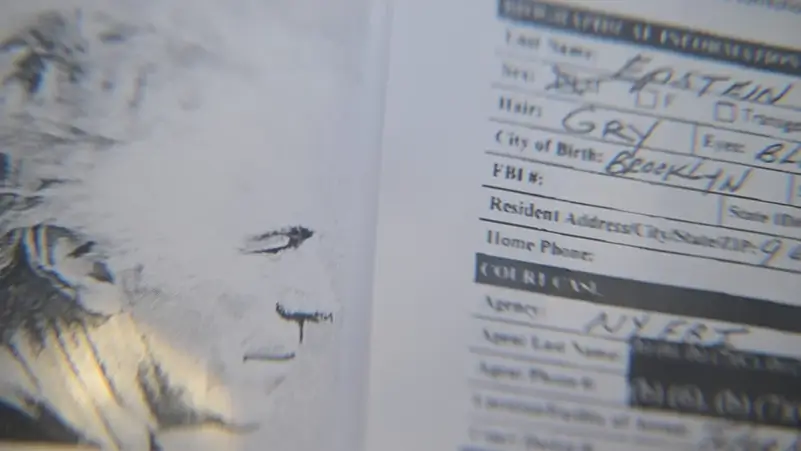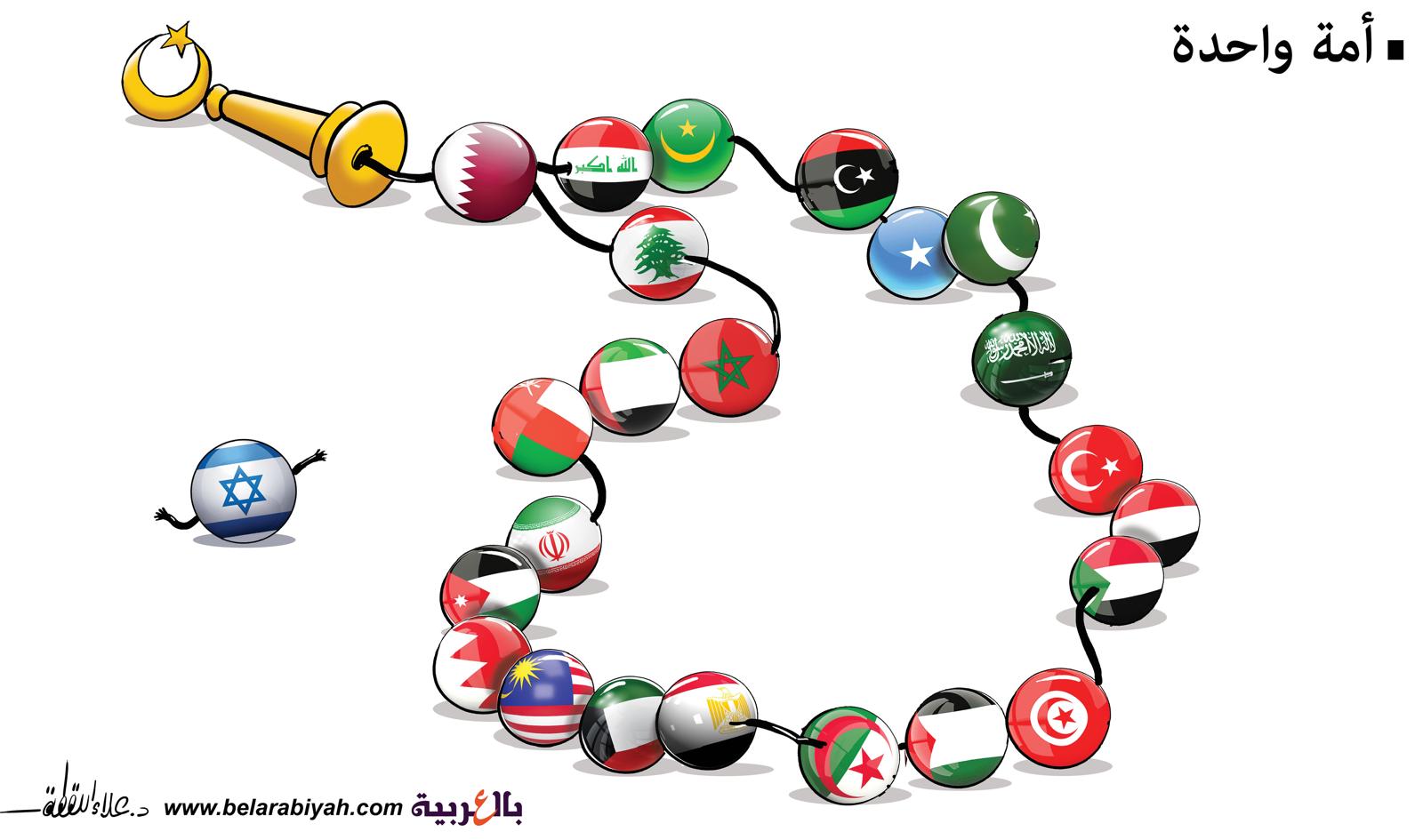بقلم جوزيف فهيم
ترجمة وتحرير نجاح خاطر
هل يمكن أن ينجح مهرجانّ سينمائي دون نجومٍ أقوياء؟ هنا تكمن المعضلة التي واجهت مهرجان البندقية السينمائي في دورته الثمانين والذي عقد في ظل الإضراب المتواصل لنقابة الممثلين، ما منع المشاركين من الانخراط في الترويج لأي عمل تنتجه شركات هوليوود.
على مدار العقد الماضي، ظلت مدينة البندقية نقطة الانطلاق الأوروبية صوب موسم الجوائز، ومثلت قوة النجوم عامل جذب رئيسي للمدينة، وهذا ما جعل نسخة العام الحالي غير معتادة إلى حدٍّ ما.
كان آدم درايفر مع شركة فيراري مستقلة التمويل، وجيسيكا تشاستين مع شركة الإنتاج المكسيكي ميموري، ومادس ميكلسن مع الملحمة الدنماركية “أرض الميعاد” من بين كبار النجوم القلائل الذين وصلوا إلى السجادة الحمراء في موسترا على عكس ما جرى عليه الحال في السنوات السابقة.
وكما كان متوقعًا، قاد هذا النقص في عدد المشاركين إلى مهرجان أفضل، فقد توجه الانتباه إلى الأفلام الواقعية وإلى الفنانين خلف الكاميرا.
وفي الوقت الذي واصلت فيه هوليوود ونتفليكس هيمنتهما على نسخة هذا العام، كان مهرجان البندقية الـ 80 أكثر تنوعًا، وربما أكثر غنىً بالمضمون السياسي من السنوات السابقة.
لم يعترِ أفلام الشرق الأوسط هذا العام نقصٌ في قائمة النجوم، غير أن بعض الأفلام العالمية فتحت الكثير من الآفاق للتفكير في قضايا المنطقة.
فقد ترشح فيلم Poor Things، وهو أحدث عمل للمخرج اليوناني يورغوس لانثيموس (The Lobster)، لجائزة الأوسكار، وهو الفائز بجدارة بجائزة الأسد الذهبي لأفضل فيلم كوميديا سوداء خيالية حول التطور النسوي لبيلا باكستر (إيما ستون)، التي قامت بدور شابة عادت من الموت على يد (ويليم دافو).
أكثر الأدوار ارتباطاً بالشرق الأوسط هو الذي قام به الممثل الكوميدي المصري الأمريكي رامي يوسف، حيث لعب دور ماكس ماكاندلز، وهو خطيب بيلا سيئ الحظ الذي يظهر بشخصية عقلانية تقدمية.
لكن تألق الفيلم في المهرجان يسلط الضوء على الحالة الرجعية التي تمر بها المنطقة، ويظهر في ذات الوقت المعايير العربية الضيقة التي تواصل السينما العمل فيها وفيما تفتقده فكريًا وجماليًا.
تصوير الدكتاتور
هناك فيلم آخر يبدو ملهماً لصنّاع الأفلام العرب وهو El Conde، من أحدث إبداعات التشيلي المنشق بابلو لارين، الذي تعتمد مسيرته المهنية إلى حد كبير على النقد اللاذع لإرث أوغستو بينوشيه.
في أكثر أعماله سريالية حتى الآن، يتخيل El Conde المتوفر على (نيتفليكس) الديكتاتور المتوفى كمصاص دماء يبلغ من العمر 250 عامًا محاطًا بعشيرة من الأطفال الجشعين الذين يسعون جاهدين لإبقائه على قيد الحياة من أجل اكتشاف ثروته المخفية.
لا يتعمق لارين في جذور الشر ولا يقدم تصوراً نفسياً حول المكيافيلية للديكتاتورية، لكنه يُظهر بينوشيه كرجل عجوز متناقض ومغرور، لا يشغله غير كيفية تصويره كلصّ جمع الثروة من سرقة شعبه دون أن يبدي أي ندم على إراقة الدماء التي تسبب فيها، وهنا يشير لارين إلى أن استبداد مصاصي الدماء وممارستهم للقتل جزء متأصل في كينونتهم.
و El Conde قصة رمزية عن جميع روايات الطغاة المغرورين الذين لا يملكون وعياً ذاتياً، فهو عضو في ناد يمكن ضم معظم زعماء الشرق الأوسط إليه أيضًا، وعلى الرغم من ضعفه الإيديولوجي، فمن السهل رؤية بينوشيه وقد هبط إلى جوهره المجرد من صلاحياته، واخُتزل إلى مجرد مخلوق مثير للشفقة يعيش وجوداً عفا عليه الزمن.
ببساطة، يمكن أن يكون بينوشيه أياً من مستبدي الشرق الأوسط: الأسد، السيسي، وآخرين، فهم جزء من عشيرة مصاصي دماء غير الشريفة الذين لم ينالوا العقاب الذي يستحقونه.
لم يتم تصوير أي زعيم عربي سابق بهذه الطريقة المهينة في السينما، ولا حتى الملك الحسن الثاني ملك المغرب، أو عبد الناصر، اللذين تم التعرض لإرثهما بتمعن بعد وفاتهما.
لكن، في الوقت الحالي، يظل مستوى السخرية والازدراء المطلق الذي يظهره لارين تجاه القادة التشيليين الأكثر وحشية بعيدًا عن متناول صناع الأفلام في الشرق الأوسط.
تجنب قضية فلسطين
يبرز فيلم “مايسترو” للمخرج برادلي كوبر محتوى يتعلق بسياسة الشرق الأوسط ظاهريًا، لكن ما لا يصوره هو علاقة هوليود المعقدة مع المنطقة.
يُعرض الفيلم لأول مرة على Netflix في كانون الأول/ ديسمبر، وهو عبارة عن سيرة ذاتية رائعة ومُصممة بعدسات رائعة لليونارد بيرنشتاين، قائد الأوركسترا والملحن الأمريكي الأسطوري، المعروف على نطاق واسع بأعماله الموسيقية لـ On the Waterfront وقصة الجانب الغربي.
وكما أشار العديد من النقاد، فإن فنه يأخذ المقعد الخلفي للدراما المحلية، مما يخلق صورة نمطية إلى حد ما، وإن تحلت بالفخامة البصرية.
ولد برنشتاين لمهاجرين يهود أوكرانيين، وكان مؤيدًا مخلصًا للبلاد، حيث قام بجولات وأداء عروض في الدولة الصهيونية عدة مرات من بينها زيارة في تشرين الثاني/نوفمبر 1948، عام النكبة، وأيضا بعد حرب 1967، وكان أداؤه على جبل المشارف، احتفالاً بانتصار إسرائيل، موضوع فيلم وثائقي بعنوان رحلة إلى القدس، صدر في العام نفسه، لكن علاقته بإسرائيل دفنت تحت سجادة المهرجان.
ومن المسلم به أن ولاء برنشتاين لإسرائيل كان متجذراً في تراثه اليهودي، وليس من العداء تجاه القضية الفلسطينية، ومع ذلك، فهو لم ينتقد إسرائيل قط، حتى عندما أصبحت معاملتها العنصرية والمهينة للفلسطينيين واضحة للعالم، فهو لم يدافع قط عن القضية الفلسطينية، ولم يعترف في أي مرحلة بمعاناة الفلسطينيين.
وإذا كانت السياسة خارج اهتمامات كوبر أو هوليود، فليس من المستغرب التغاضي التام عن موقف برنشتاين السياسي المثير للجدل لصالح التركيز على خلافاته الزوجية.
تصوير الأراضي الليبية القاحلة
تناولت أفلام عديدة مشاركة في المهرجان منطقة الشرق الأوسط بشكل مباشر، وإن كان ذلك من الزاوية المألوفة للهجرة غير الشرعية.
في فيلم Io capitano الفائز بجائزة أفضل إخراج، يستحضر المخرج الإيطالي ماتيو جاروني (جومورا) ملحمة تدور قصتها عن الشاب السنغالي سيدو البالغ من العمر 16 عامًا وهو يشق طريقه من داكار إلى إيطاليا.
كان سيدو ساذجاً بشكل لا يصدق لكنه تحلى بتصميم من الفولاذ وامتلك قلباً من ذهب، وتعرض للخداع على يد المحتالين طوال طريق هجرته، وكان أشرسهم أولئك الذين التقاهم في ليبيا، بوابة إيطاليا.
يسلط جاروني الكاميرا على تفاصيل رحلة سيدو الكابوسية، على الرغم من أن القليل من الأفكار لم تعرض من قبل، باستثناء الجزء المتعلق بليبيا التي تم تصويرها على أنها أرض قاحلة ينعدم فيها القانون ويحكمها المرتزقة والمافيا ورجال الأعمال المشبوهون.
يعكس انعدام القانون في ليبيا في الفيلم غياب المؤسساتية المسؤول عن كارثة العاصفة دانيال.
وتُظهر اللقطة المختصرة لطرابلس كمدينة تعج بوجوه أفريقية أُكرهت على العبودية، مدينة مشوهة خالية من العدالة والرحمة.
ربما تهدف هذه الصورة الصارخة لليبيا التي شوهدت في الفيلم، إلى القول أن ما يعانيه الأفارقة في ليبيا لا يختلف عما يعيشه العرب على حدود أوروبا.
ازمة اللاجئين
ظهر فيلم “الحدود الخضراء” للمخرجة البولندية المخضرمة أنيسكا هولاند، كأكثر الأفلام طموحًا وامتلاكاً للطبقات المتعددة، وقد حصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة.
تدور أحداث الفيلم في عام 2021 على الحدود البولندية البيلاروسية، ويوثق أزمة اللاجئين من وجهات نظر مختلفة.
ومن بين اللاجئين الذين يتحدث عنهم الفيلم عائلة سورية فرت من تنظيم داعش وباتت تسعى جاهدةً للاجتماع بأقاربها في السويد، وكذلك مدرس لغة إنجليزية أفغاني يهرب من حركة طالبان العائدة للحكم حديثًا، بالإضافة إلى حرس الحدود البولنديين والناشطين.
وبالنسبة للمشاهدين المطلعين على أفلام اللاجئين، فإن الجزء الأول من الفيلم لا يقدم من الجديد إلا القليل: فقصص السوريين والأفغان مألوفة للغاية، حتى أن أحدهم أقر بأن “العالم كان يراقب قصصنا لمدة عشر سنوات ولم يفعل شيئًا”.
لكن ما يمنح الفيلم أهميته وعمقه هو البيئة البولندية غير المعروفة وشخصياته البولندية الغنية.
إن الحدود البولندية البيلاروسية هي أرض محظورة، يتم إساءة معاملة اللاجئين واستغلالهم فيها، حيث يحاصرون بين الطاغية البيلاروسي لوكاشينكو الذي يصر على استخدامهم لاستفزاز جيرانه الأوروبيين، والسلطات البولندية التي لا تريدهم.
لقد أصبح اللاجئون من الشرق الأوسط مجرد بيادق في لعبة بين حكومتين يمينيتين معاديتين للأجانب.
ومن خلال توسيع نطاق تركيزها إلى ما هو أبعد من تجربة اللاجئين المباشرة التي يتم تدوينها في كثير من الأحيان، تكشف هولاند عن عدد من الموضوعات التي لم يهتم سوى عدد قليل من صانعي الأفلام بمعالجتها: تفاهة عمل الحراس الخاملين والثقل النفسي لعملهم القاسي والفراغ العاطفي الذي يسعى الناشطون إلى ملئه بعملهم التطوعي، والتكلفة الأخلاقية للتقاعس عن العمل التي تعاني منها القلة المستنيرة.
ما الذي يجعل الناشط ناشطاً؟ هل هو دافع إنساني للمنفعة أم رغبة خفية في اكتساب إحساس بالهدف؟ لماذا لا يقدر الحراس على تحدي الأوامر الفاسدة؟
تقدم هولاند الكثير من القضايا للتفكير، والنتيجة واحدة من أكثر قصص اللاجئين تشجيعاً وإدراكاً في السنوات الأخيرة، ومع توقع أن يكتسح السياسيون اليمينيون الانتخابات البرلمانية البولندية المقبلة، فإن فيلم الحدود الخضراء يصبح أكثر أهمية.
إن مقارنة وزير العدل زبيغنيو زيوبرو للفيلم بـ “الأفلام الدعائية للرايخ الثالث” هي شهادة على قوة الفيلم وإمكاناته في التأثير على جزء من التصويت المقبل.
عودة طالبان
يضم كل من Green Border وIo capitano نصيباً من الرعب، ولكن أياً من الأفلام التي عرضت في البندقية لم يكن مدعاةً للقلق ومثاراً للغضب مثلHollywoodgate، حيث يتناول الفيلم الوثائقي للمصري إبراهيم نشأت العواقب المباشرة لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان عام 2021.
في المقام الأول، يركز نشأت على وجهة نظر قائد القوات الجوية ملاوي منصور والجندي إم جي مختار، وقد حظي الفيلم بصلة غير مسبوقة إلى إعادة غزو طالبان لأفغانستان.
بدأ نشأت، وهو صحفي في دويتشه فيله وقناة الجزيرة، التصوير في 31 آب/ أغسطس 2021، أي اليوم التالي لعملية الإخلاء الكبرى، وما عرضه في النهاية من مشاهد وحشية كان مرعبًا.
لا يظهر الطالبانيون أي ضبط للنفس ويستخدمون كاميرا نشأت للإعلان عن دعاية الحرب الحماسية: قوتهم التي لا حدود لها، شهوتهم للسيطرة على العالم، عقيدتهم المتطرفة التي لا تتزعزع.
لا يحاول الجنود إخفاء احتقارهم للمرأة، ولا كراهيتهم للغرب، أو حتى رغبتهم في قتل أكبر عدد ممكن من الجنود الأمريكيين.
ثمة رسالة واحدة ترغب طالبان أن يعرفها العالم: إنهم يريدون إخافة العالم الغربي ومنعه من التدخل في الأراضي التي اكتسبوها بشق الأنفس.
على هذا النحو، سرعان ما يصبح من الواضح أن إمارة أفغانستان الإسلامية لديها ما هو أكثر مما يُسمح لنشأت برؤيته.
لا يمكن التمييز بين شخصيتي منصور ومختار: فكلاهما لا يظهران إلا باعتبارهما مجرد متحدثين آليين لطالبان.
الصورة المعروضة للمخرج المصري هي بالتأكيد غير مكتملة، وربما مشوهة، ونتيجة لذلك، يعد فيلم Hollywoodgate أكثر أهمية كوثيقة لفترة ما بعد الإخلاء، منه كعمل سينمائي عظيم، ويثير أسئلة أكثر من الإجابات المحددة.
لكن ما لا شك فيه هو أن الانسحاب الأمريكي سمح لطالبان بتدمير كل المكاسب الديمقراطية التي حققتها وترك للحركة المسلحة ما قيمته أكثر من 7 مليارات دولار من المعدات العسكرية لترسيخ حكمها وتهديد الدول المجاورة، ففي أحد المشاهد يتساءل منصور بشكل عرضي عن إمكانية غزو أوزبكستان.
لا يقدم فيلم Hollywoodgate مجرد تحقيق شامل عن حكم طالبان، بل إنه بمثابة لقطة تأملية للرماد الذي خلفته أمريكا التي لم تعد قادرة على الادعاء بزعامة العالم الحر.
للإطلاع على النص الأصلي من (هنا)