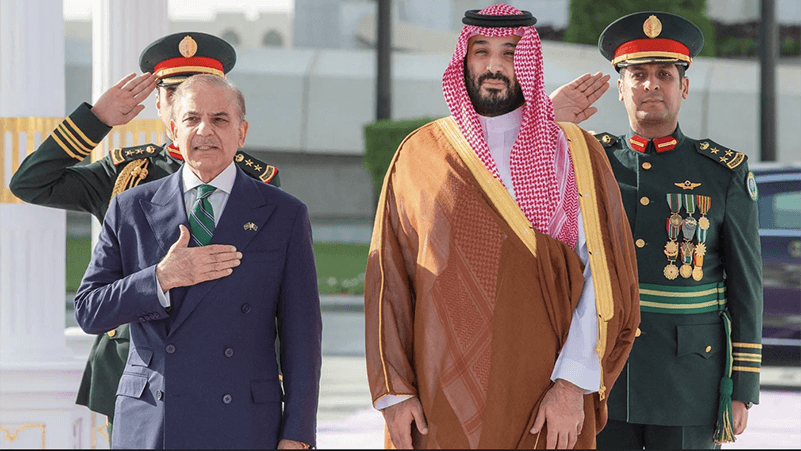بقلم فرح عبدالصمد
كان المعبد الذي يعود تاريخه للقرن الثامن في صحراء مصر الغربية موضع اهتمام الحكام اليونانيين والفرس، بما في ذلك الإسكندر وقمبيز.
وعبر التاريخ، عرفت واحة سيوة، المنعزلة والواقعة على بعد ثلاثين ميلاً شرق الحدود الليبية كموقع حيوي استحق المنافسة.
ولو قُدر لـ “جبل الموتى” القديم أن يتكلم، فسينقل حكايات تشبه الحلم عن الغرباء الذين حاولوا الوصول إلى الواحة وفشلوا، وبالنسبة لأولئك الذين نجحوا، فإن إقامتهم فيها كانت قصيرة.
نظرًا لموقعه في وسط الصحراء المصرية، فلا يزال المعلم الديني يقاوم التأثيرات الخارجية منذ فترة طويلة.
تم إنشاء معبد مخصص للإله آمون (آمون رع)، وهو واحد من آلهة مصر البارزين، خلال القرنين السابع والثامن قبل الميلاد، وفي القرون اللاحقة، تم توثيق آثار إضافية للثقافة المصرية القديمة في سيوة.
كان كاهن المعبد يتمتع بجاذبية مغناطيسية، مما أثار الغيرة والحسد في قلوب أقوى الملوك القدامى، وكان الناس يأتون لعرض الأسئلة والنبوءات، بينما عمل الكهنة كمترجمين للإله.
وقيل إن الأبطال كانوا يقومون بزيارة الكاهن في المعبد حيث كانت تقام الاحتفالات وطقوس العبادة في مشاهد أذهلت العديد من الغرباء.
الإسكندر وقمبيز و “الوحي الإلهي“
سعى الملك الأخميني في بلاد فارس، قمبيز، ابن كورش الكبير، إلى استشارة كاهن سيوة لإضفاء الشرعية على غزو مصر عام 525 قبل الميلاد.
ووفقًا للمؤرخ اليوناني هيرودوت، قرر قمبيز إعادة توجيه 50 ألف جندي لتدمير معبد سيوة واستعباد سكان الواحة، بعد أن رفض الكاهن تأييد طموحاته.
تمركز جيش الملك الفارسي في الأقصر، وفقد الاتجاهات في أرض مجهولة على بعد 500 ميل في موقع يفصل مصر العليا عن الواحة.
ولا يزال الخبراء يناقشون ما إذا كان جيش كامل قد هلك، كما ادعى هيرودوت، وإذا كان الأمر كذلك، فهل من الممكن أن تكون عاصفة رملية قد تسببت في زوالهم؟
لكن ما يمكننا استخلاصه من تقارير المؤرخ هو أنه حتى الملك كان يحتاج إلى مباركة من وحي بعيد في الصحراء الغربية لتأكيد مزاعم قوة لا جدال فيها.
كانت سيوة واحدة من أكثر النبوءات السبعة تمجيداً في العصور القديمة وهي الوحيدة التي لم تكن يونانية.
انتشرت أهميتها الثقافية عبر عوالم البحر الأبيض المتوسط اليونانية وغير اليونانية وتم اللجوء اليها بشكل خاص لمعرفة مصير الطموحات السياسية والعسكرية.
وكان الناس ينظرون إلى كاهن سيوة على أنه أقل تسييسًا من الآخرين، كدلفي على سبيل المثال، وأنه من الصعب إفساده، فلم يكن باستطاعة أحد أن يهاجم الكاهن أو يهدده، وهو ما فشل به قمبيز الغاضب وجيشه الضائع، وكان أيضا لا يقبل الرشوة، حيث حاول الجنرال الإسبرطي ليساندر أن يفعل ذلك دون جدوى.
وبشكل ربما يدعو للغرابة – والتي من الممكن أن تفسر بالبعد الجغرافي عن ممفيس وطيبة (الأقصر) وغيرها من المراكز الدينية الرئيسية على طول نهر النيل– اجتذبت سيوة بشكل أساسي الزوار من غير المصريين، فلم يزرها أي فرعون قط، ولا تزال المزاعم المحيطة بزيارة كليوباترا لسيوة غير مؤكدة.
إلا أن الاسكندر المقدوني، الذي اعتنقت والدته الباطنية الروحانية، فهم هذا، لقد حسب أنه سيحتاج أولاً إلى احترام الكاهن والسفر إلى سيوة، أو بدلاً من ذلك إرسال وفد إلى بلدة الواحة للمصريين لقبول حكمه الأجنبي عندما دخل جيشه إلى البلاد.
مباشرة بعد تأسيس مدينة الإسكندرية، اختار الفاتح المقدوني الذهاب بنفسه وترك الساحل المصري، دون سابق إنذار، إلى معبد آمون في عام 331 قبل الميلاد.
ادعى الإسكندر أن كلا من بيرسيوس وهرقل هم أسلاف له من طرف بعيد وقيل أيضًا أنهما استشارا آمون
في حين اعترف كهنة ممفيس بالقرابة المصرية للإسكندر، إلا أنه أعلن ابنا لآمون من قبل أحد الكهنة في حرم معبد سيوة، ثم أصبح الملك الإسكندر إلهاً، الامر الذي منحه تميزا مهما في مجتمع متدين كمجتمع مصر.
وقد ساوى الإغريق آمون برئيس آلهتهم الأولمبية زيوس، وتم تقديم القرابين له في قلعة أثينا في القرن الرابع قبل الميلاد ويمكن العثور على المعابد المخصصة لآمون في اليونان.
ربما تذكر الإسكندر التعاليم اليونانية لمعلمه السابق أرسطو، والتي قد يكون الفيلسوف قد نقل فيها وجهة النظر الشائعة في ذلك الوقت: أن الثقافة المصرية كانت أكثر تعقيدًا بكثير من ثقافة الإغريق، وأن طقوسها ومعتقداتها سبقت تلك التي كانت تمارس في بلادهم.
ربما أراد المقدوني أن ينجح حيث فشل قمبيز، وربما يكون قد تذكر أيضًا كيف أغدق الشاعر اليوناني الموقر بيندار بالثناء على آمون في ترنيمة منحوتة في المعبد.
وربما تكون العِرافة، أو العلامات المنذرة بمصير عظيم، المحيطة بميلاد الإسكندر قد عززت الاهتمام بالمعتقدات الصوفية، خاصة وأنها كانت تمنح الألوهية والخلود.
ولا يزال بعض علماء الآثار، مثل ليانا سوفالتزي، يدعون أن قبر الإسكندر يقع في مكان ما في سيوة.
تأكيد السيادة المصرية الحديثة
ومن المحتمل أن سكان سيوة استمروا في ممارسة الطقوس الدينية التوفيقية بعد فترة طويلة من العصور القديمة، ولم ينفتحوا على الإسلام إلا في عهد الفاطميين، تقريبا في القرن الثاني عشر.
بعد تعرضهم لهجمات القبائل البدوية، غادر السيوانيون الموقع الأقدم للعرافة، حيث يقع معبد سيوة، لإنشاء مستوطنة مسورة جديدة، تُعرف باسم شالي (“المدينة”)، وضمت 40 رجلاً وسبع عائلات في عام 1203.
تسجل إحدى المخطوطات أن بعض السيوانيين انقسموا إلى مجموعتين استقرت إحداهما في الجزء الشرقي من المدينة الجديدة، بينما بقيت الأخرى في الأقسام الغربية.
وتم تأكيد السلطة المصرية في سيوة في عام 1820، عندما أرسل محمد علي باشا قواته إلى المنطقة كجزء من غزوه لليبيا والسودان، ثم سافر العديد من الأوروبيين إلى الواحة، في ظل الهوس بمصر وفضول المستشرقين لاستكشاف افريقيا.
ومنذ أوائل القرن التاسع عشر، قامت بعض البعثات كتلك التي قادها القنصل الألماني في القاهرة، هاينريش فون مينوتولي، بتسجيل دقيق للمواقع الأثرية الهامة في سيوة وما حولها.
كما قدمت الصور المبكرة من هيرمان بورشاردت في عام 1893 سجلات تاريخية ثمينة وسط أجواء من الاضطرابات المتواصلة.
نشأ عدم الاستقرار هذا نتيجة للتوتر بين الشرقيين والغربيين داخل الواحة، ورفض دفع الضرائب للسلطات المركزية.
كما جرت محاولات لتسجيل لغة السيوان، وهي مجموعة فرعية من عائلة اللغة البربرية أو الأمازيغية الشرقية والتي يُقدر الآن أنها “مهددة بالانقراض” حسب اليونسكو.
وفي عام 1904، زار عباس الثاني، كأول حاكم لمصر سيوة منذ عهد الإسكندر، حيث رافقت زيارة الخديوي العثماني قافلة مؤلفة من أكثر من 200 جمل، لقيت استحسان السكان المحليين.
شرع عباس في توسيع إدارة المياه ومشاريع الري في الواحة لكن اندلاع الحرب العالمية الأولى أوقف هذه المشاريع.
وخلال فترة الحرب، أصبحت سيوة عالقة بين مختلف المصالح المتعارضة، فمن ناحية، كان هناك البريطانيون الذين احتلوا مصر، ومن ناحية أخرى، كان الأتراك العثمانيون، الذين حموا النظام الديني السنوسي النافذ، والذي كان متمركزًا في ليبيا، ولكنه كان مهيمناً في سيوة أيضًا.
انخرط السنوسيون في نزاع طويل الأمد مع الإيطاليين الذين غزوا ليبيا في عام 1911، وبقيت القوات الموالية للنظام لفترة وجيزة في الواحة حتى أن بعض السيوانيين انضموا إلى صفوفهم.
وفي النهاية، دخل البريطانيون الواحة عام 1917، ووضعوا حداً للأعمال العدائية، على الأقل داخل سيوة.
وبعد انتهاء الحماية البريطانية والاستقلال الجزئي لمصر عام 1922، مارست الدولة سيطرة أكثر تصميماً على الواحة مع الزيارة الرمزية للملك فؤاد عام 1928.
سعى الملك فؤاد، الذي سافر بالسيارة، باستخدام نفس خط سير الإسكندر الأكبر، إلى الترويج للثقافة المصرية الحديثة في واحة ذات أغلبية غير عربية.
مكث ليوم واحد، وعرض فيلمًا لأول مرة على مجموعة من السيوانيين، وأمر بإكمال بناء مسجد والبدء في تشييد مدرسة.
وكما فعل عباس الثاني، طبق فؤاد أحدث التقنيات الزراعية لتحسين إنتاج المحاصيل في المنطقة المحيطة بالواحة.
وعندما علم الملك أن بعض السيوانيين يمارسون الشذوذ الجنسي، من خلال عقود الزواج بين رجلين، أمر بإرسال عالم دين إلى سيوة ليشرف على المسجد الجديد فور الانتهاء من بنائه.
رومل والحرب في شمال إفريقيا
عندما اندلعت الحرب العالمية الثانية، اكتسبت سيوة أهمية إستراتيجية في حملة شمال إفريقيا، وتعرضت للاحتلال من قبل قوات الحلفاء، بما في ذلك القوات البريطانية وقوات الأنزاك (الجيشين الأسترالي والنيوزلندي).
تم إغلاق الواحة أمام الزوار غير العسكريين باستثناء عالم الآثار المصري أحمد فخري، الذي زارها لفترة وجيزة.
وعندما تمكن أخيرًا من الحصول على تصريح للزيارة، وجد فخري سكانًا يبحثون عن مأوى في كهوف جبل الموتى، ومقابر مشوهة وقطعا أثرية تباع كتذكارات.
وضع فخري ذكرياته ومعرفته بالواحة التي لا مثيل لها في كتابه المؤثر لعام 1973، بعنوان “واحة سيوة”.
رحب السيوانيون، الذين كانوا على وشك الوقوع في مجاعة، بالوافدين الجدد عندما غادرت قوات الحلفاء فجأة في يونيو 1942، وبعد شهر، وصل الإيطاليون من ليبيا عن طريق الجو والبر دون مقاومة.
تمركز ما يصل إلى 2000 إيطالي في سيوة وتبعتهم القوات الألمانية بعد فترة وجيزة، حيث جاء القائد الألماني الشهير، المارشال إروين رومل من الفيلق الافريقي لهتلر، للزيارة في سبتمبر واستقبلته قواته، وكذلك سلطات سيوان المحلية.
هنا اعترف رومل لأحد ضباطه، الرائد هانز فون لاك، بخسارة الحرب وغادر الإيطاليون بعد ثلاثة أشهر من وصولهم بعد أنباء هزيمة المحور في العلمين.
استحوذ فنان الحرب البريطاني إدوارد باودن على مشهد سيوة الجوي أثناء الصراع بألوان مائية مثيرة للذكريات وغير مؤرخة.
وبألوان غير مشبعة، رسم الرسام مناظر للمدينة نفسها، تظهر جبل الموتى وقلعة شالي المدمرة، بالإضافة إلى صورتين قصيرتين للعراف، أحدهما مليء بأشجار التمر والحمير ورجل محلي.
وبعد سبعة عشر عامًا من زيارة والده، زار الملك فاروق الواحة في عام 1945 بينما مرت أوقات الهدايا الفخمة وربما كان الملك المتعلم في الخارج، الذي كان يبلغ 25 عامًا فقط في ذلك الوقت، يفتقر إلى جاذبية فؤاد.
أفاد أحمد فخري عن زيارة باهتة، حيث سأل فاروق السيوانيين الذين رحبوا به ما إذا كانت “رذائلهم” الاجتماعية قد تم قمعها أخيرًا.
سيوة اليوم
وأخيرًا، وبواسطة طريق معبد، تم ربط الواحة بمدينة مرسى مطروح في عام 1984، حيث جلبت السياحة اللاحقة المزيد من الزوار إلى سيوة.
ينجذب الزوار إلى سيوة بسبب بعدها وأصالتها المتصورة وهالتها التاريخية، فضلاً عن بساتين النخيل الخصبة، والينابيع الطبيعية الوفيرة، والمنسوجات الفريدة، والمجوهرات، والكثبان الرملية، والمناظر الطبيعية الخلابة، والآثار القديمة.
وفي عام 2011، استقبلت سيوة ما يقدر بنحو 20 ألف زائر، مما مثل ثلثي إجمالي سكانها.
وفي أواخر عام 2020، أعيد افتتاح قلعة شالي التي كانت تحت التجديد منذ عام 2018، وانتُخبت أول نائبة أمازيغية من سيوة، فتحية السنوسي، لعضوية البرلمان المصري.
وفيما يشكل تحديا في عالم ما بعد الجائحة، يتحتم على الحكومة المصرية والسيوانيين المحافظة على ثقافتهم المحلية الفريدة، مع جذب الإيرادات التي ستوفر للناس الأدوات لنقل هذا التراث إلى الأجيال القادمة.