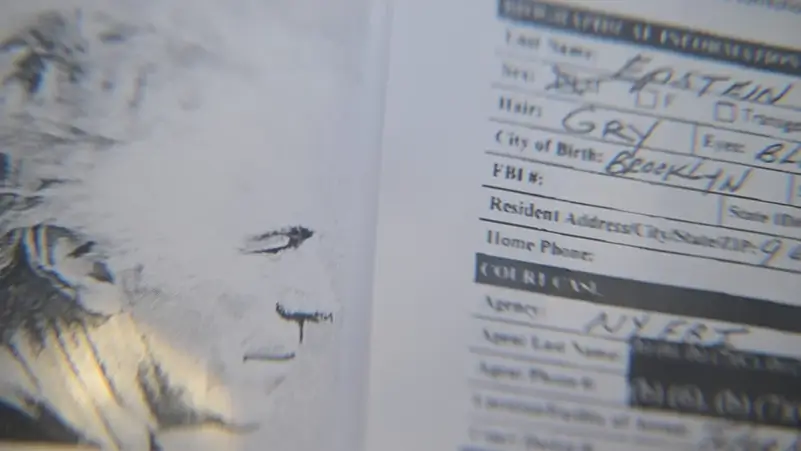بقلم علاء الترتير
ترجمة وتحرير نجاح خاطر
بعد انقضاء ثلاثة عقود، لا يزال إطار اتفاقات أوسلو يؤثر على الفلسطينيين ويرسم الجوانب الرئيسية لحياتهم وموتهم، فمنذ توقيعها، خلقت أوسلو عمليات ومؤسسات وترتيبات في المجتمع الفلسطيني أدت إلى تحولات وأوجه قصور هيكلية كبيرة، خاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين.
لقد شوه إطار اتفاقات أوسلو المجتمع المدني الفلسطيني، وأعاد تعريف وصياغة الركائز الأساسية للعقد الاجتماعي، وزاد من تجزئة الشعب الفلسطيني وعمّق انقسامه.
لقد عززت أسلو الاعتماد الاقتصادي الفلسطيني على الاقتصاد الإسرائيلي وكرست الاحتواء غير المتكافئ، مما أدى إلى إنشاء اقتصاد يعتمد بطبيعته على المساعدات الدولية وإضفاء الطابع البيروقراطي على عملية حرمت الفلسطينيين من التنمية.
كان النموذج الأمني للسلطة الفلسطينية الذي تبنته اتفاقات أوسلو مثقلاً بالعيوب الهيكلية التي كان المقصود منها حرمان الفلسطينيين من التخلص من السبب الرئيسي لانعدام أمنهم، ألا وهو الاحتلال الإسرائيلي.
وفي الجانب السياسي، أدى إطار أوسلو إلى هيمنة أنماط الحكم الشخصية على أسس المنظومة الخاضعة للمساءلة والتشاركية.
بالتأكيد، أدى ذلك إلى عزل الشعب الفلسطيني عن مركز النظام السياسي وإبعاده عن الهيئات الحاكمة عبر تغذية الفساد والفشل في إنشاء آليات فعالة للمساءلة والشفافية.
لم تكن مثل هذه العيوب عرضية أو غير مقصودة، بل هي جزء لا يتجزأ من تصميم اتفاقيات أوسلو وتشكل المتطلبات الأساسية لعمليات “السلام وبناء الدولة”.
ورغم ذلك، يتم تذكير الفلسطينيين في شهر أيلول / سبتمبر من كل عام، أن قيادتهم السياسية تصب اهتمامها على إطار فاشل عفا عليه الزمن ينكر حقوقهم الأساسية.
كما يتم تذكيرهم بأن فكرة السلام تضاءلت إلى مجرد ترتيبات أمنية وظيفية بين المحتل والشعب المحتل للحفاظ على الوضع الراهن وضمان عدم تحقيق التوازن في القوى.
وبالتالي فإن إطار أوسلو ينتهك الحقوق الفلسطينية، بما في ذلك السلامة والأمن، ويعزز نظام القهر والسيطرة والقمع متعدد الطبقات الذي عانى منه الفلسطينيون لفترة طويلة.
وبعد مرور ثلاثين عاماً، أثبتت أوسلو أنها ليست سبيلاً للسلام ولا إطاراً من شأنه أن يقرب الشعب الفلسطيني من انتزاع حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
بل إنه جعل الفلسطينيين أكثر ضعفاً وأكثر تشرذماً، وترك احتمالات إقامة الدولة، ناهيك عن تحقيق المساواة والعدالة والحرية، أكثر بعداً.
مصممة للفشل
رغم أنها خذلت الشعب الفلسطيني وشوهت المعنى الأساسي للسلام، إلا أن اتفاقيات أوسلو لم تفشل تماماً.
كما انها لم تخذل إسرائيل، القوة المحتلة، ولا حلفائها، فقد عرضت أوسلو على إسرائيل إطارًا برعاية دولية للحفاظ على احتلالها وتعزيز سيطرتها الاستعمارية على فلسطين والشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة على مدار الأعوام الثلاثين الماضية.
ومن بين أمور أخرى، فرض الاتفاق بيروقراطية متضخمة، تضم المؤسسة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، والتي تعمل ضمن حدود اتفاق مصمم على وجه التحديد لمنع نضال الفلسطينيين من أجل الحرية وتقرير المصير.
ويستحوذ قطاع الأمن في السلطة الفلسطينية، الذي يحظى بدعم كبير من جهات فاعلة خارجية ويعمل فيه حوالي 44% من جميع موظفي الحكومة، على ما يقرب من مليار دولار من ميزانية السلطة الفلسطينية ويستوعب حوالي 30% من إجمالي المساعدات الدولية المصروفة للفلسطينيين.
ويستهلك القطاع الأمني في السلطة الفلسطينية، بمؤسساته وهيئاته المتعددة، من موازنة السلطة الفلسطينية أكثر مما يستهلكه قطاعا التعليم والزراعة مجتمعين، فيما تشير التقديرات إلى أن نسبة أفراد الأمن إلى عدد السكان تصل إلى 1 إلى 48، وهي واحدة من أعلى المعدلات في العالم.
غير أن هذه الظروف أخفقت في توفير قدر أكبر من الأمن للشعب الفلسطيني، فقد ظل النموذج الأمني للسلطة الفلسطينية، الذي تقوده اتفاقات أوسلو، يعاني من عيوب هيكلية متعلقة بحرمان الفلسطينيين من التخلص من السبب الرئيسي لانعدام أمنهم، وهو الاحتلال الإسرائيلي، بما يشمل التنسيق الأمني سيئ السمعة الذي تقوم به السلطة الفلسطينية والذي يهدف، في المقام الأول، إلى ضمان أمن إسرائيل.
لقد بدأ نموذج التنسيق الأمني خلال العقدين الأولين من وجود السلطة الفلسطينية وبرز باعتباره “التزامًا تعاقديًا” بسبب التدخلات الدولية المختلفة التي ترعاه وخطط إصلاح القطاع الأمني (كل ذلك ضمن إطار اتفاقات أوسلو ومشتقاته)، لكنه تحول خلال العقد الماضي إلى سلوك مؤسسي متجذر وهوية شكلية، حتى أصبح عقيدة راسخة ومحفورة في عقول وتصورات قيادة السلطة الفلسطينية وتصرفاتها الحالية والمستقبلية.
استدامة الاحتلال
على مر السنين، دافعت قيادة السلطة الفلسطينية بلا هوادة عن التنسيق الأمني باعتباره جسراً لمحاربة التطرف والعنف “ينبغي أن يقودنا إلى استقلالنا”، وهي تصر أيضا على أن التنسيق الأمني ” جزء لا يتجزأ من إستراتيجية تحررنا”، إلا أن الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني تعارض التنسيق الأمني كأسلوب عمل للسلطة الفلسطينية ومؤسستها الأمنية.
وتدرك قيادة السلطة الفلسطينية هذا الانقسام الصارخ حيال موضوع التنسيق الأمني، لكنها غير راغبة ولا قادرة على سد هذه الفجوة من خلال خطوات ملموسة قابلة للتنفيذ تتجاوز الوعود الفارغة والتصريحات الجوفاء.
وعلى الرغم من أن السلطة الفلسطينية أعلنت أكثر من 60 مرة أنها أوقفت أو ستوقف التنسيق الأمني، إلا أنه لا يزال جارٍ على قدم وساق، خاصة في الأوقات التي تشهد تصاعد التعبئة الشعبية الفلسطينية والمواجهة والمقاومة المسلحة.
ولهذا السبب سوف تتمكن السلطة الفلسطينية من إيقاف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وسوف تفعل ذلك، فقط عندما تتوقف عن الوجود، على الأقل في شكلها الحالي ووظيفتها وقيادتها الحالية.
تتضمن خطة التنسيق الأمني في أوسلو تجريم المقاومة الفلسطينية، و”إضفاء الطابع المهني” على الاستبداد الفلسطيني، والتهديد المستمر لسلامة الفلسطينيين، الذين يتعرضون لمستويات إضافية من القمع الفعلي.
ولذلك، فإن السبيل الوحيد المجدي للتعامل بشكل بناء مع فلسطين وإسرائيل هو الاعتراف أولاً بواقع القضية الفلسطينية كقضية نضال ضد الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري، اللذين يسيطران على كافة المناحي على الأرض.
وأي شيء آخر سيكون بمثابة تجاوز للمشكلة وعدم معالجة للقضايا من جذورها.
وعلى مدار ثلاثة عقود وحتى اللحظة، لم تقدم اتفاقات أوسلو شيئاً أكثر من “إطار سلام” زائف أدى إلى إدامة الاحتلال وانتهاكاته، لقد حان الوقت للتخلي عن إطار أوسلو ومشتقاته، فالسلام والاستعمار يعتبران مسارين غير متوافقين، حتى لو كانا يسيران بالتوازي.
وكجزء من استراتيجية التحرير الخاصة بهم، يجب على الفلسطينيين تفكيك أنظمة الهيمنة هذه وإنهاء الاستعمار في هياكل القمع والسيطرة المفروضة عليهم، بشكل مباشر وغير مباشر، من قبل القوى الداخلية والخارجية.
في أيار/ مايو 2021، عندما أعلن الشباب الثائر في فلسطين أن “التحرير في متناول أيدينا”، استهدفت رسالتهم السلطات الداخلية والخارجية على حد سواء، وبات واضحاً في أذهان الناس ما تحتاجه قيادتهم، لكن ذلك لا يمكن تحقيقه دون بوصلة تشير إلى الكرامة والحرية.
ومن المؤكد أن التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل لن يكون الجسر الذي سيقود الفلسطينيين إلى ذلك، بل الجسر الذي يؤدي إلى اللامكان.
إن تجاوز المسار الذي أملته اتفاقات أوسلو وأضرارها يتطلب إعادة التفكير جذرياً في الإطار المهيمن القائم ويتطلب التشكيك في دور السلطة الفلسطينية في النضال الفلسطيني من أجل تقرير المصير.
كما أن معالجة أوجه القصور البنيوية التي تعيب اتفاقات أوسلو ومعاكسة اتجاهها يعني تبني نموذج “المساءلة والناس أولاً”، وهو ما سيتطلب من الفلسطينيين إعادة اختراع نظامهم السياسي ونظام الحكم، وإعادة بناء قيادتهم الديمقراطية والتمثيلية والشرعية والشاملة والفعالة، وأخيراً، إعادة تعريف السلام باعتباره نتيجة للمساءلة والعدالة الدائمة والمساواة، وبالتالي استعادة معناه الحقيقي.
للإطلاع على النص الأصلي من (هنا)