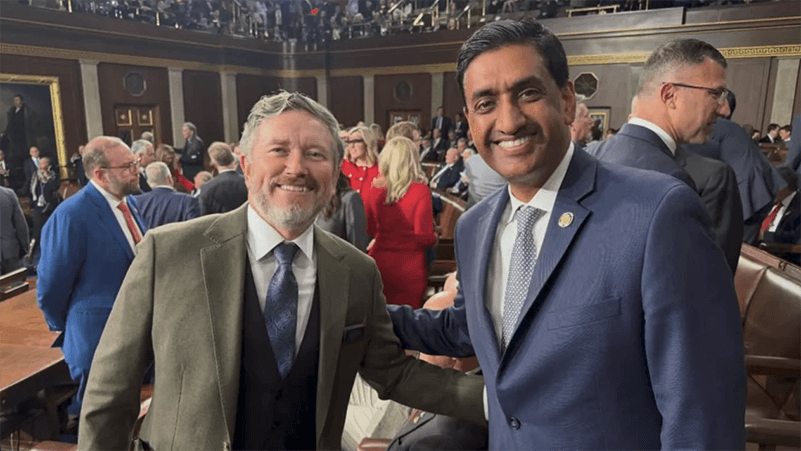عائلتي في غزة تبحث عن مكان آمن يكاد لا يكون موجوداً
بقلم هالة الصفدي
ترجمة وتحرير نجاح خاطر
أقف على بعد حوالي 4000 كيلومتر من الخوف والجوع والعطش والقصف والدمار والركام والدبابات والطائرات الحربية وضجيج الطائرات المسيرة التي تحلق على ارتفاعات منخفضة وصفارات سيارات الإسعاف وبكاء الأطفال ووجوه أحبائي.
أقيم في قرية مسالمة على نهر تاين في بريطانيا، حيث تتمثل أكبر المخاوف في إضرابات السكك الحديدية وارتفاع تكاليف المعيشة، وفي الوقت نفسه، فإن أحبائي موجودون في غزة، حيث تتمثل أكبر مخاوفهم في العثور على كوب آخر من مياه الشرب وتجنب التعرض للقتل في غارة جوية إسرائيلية.
في 29 تشرين الأول/ أكتوبر، وإثر استعادة الاتصالات بعد انقطاع التيار الكهربائي، أرسل لي أخي محمد صورة شخصية على تطبيق واتساب يظهر فيها مع عشرات زجاجات المياه، لقد شعر بالبطولة لأنه استطاع تأمين الماء للعائلة.
ثم أرسل صورة شخصية أخرى له مع ابنه بعد أن قاما بحلق شعر رأسيهما، معتقداً أن تكون الحرب قد انتهت بحلول موعد الحلاقة القادم، فضحكنا كيف أن الحروب تجعلك قادراً على الاستمتاع فيما كنت تعتبره من المسلّمات، فكل شيء يتحول إلى رفاهية: وجبة ساخنة، ليلة هادئة من النوم في سريرك، مياه شرب نظيفة، واستخدام الشامبو المفضل لديك أثناء الاستحمام الدافئ.
ولكن محمد توقف بعد ذلك عن الرد، وبعد نصف ساعة أرسل صورًا لغرفة معيشتنا، إذ أصبحت كلها رمادية اللون ومتضررة جزئيًا، شعرت بالذعر وطلبت منه مغادرة المنزل بما انه قد تعرض للقصف، شعرت وكأن شيئًا أسوأ على وشك الحدوث.
غادرت عائلتي المنزل، وأخذوا حقائبهم المجهزة مسبقًا والتي كانت بجوار الباب منذ اندلاع الحرب، واصطحبوا الأطفال وخرجوا، وبعد بضع دقائق، ضربت غارة جوية أخرى ودمرت منزلنا، ولحسن الحظ، تمكنت عائلتي من الخروج على قيد الحياة.
ليلة طويلة
قضى أفراد عائلتي الليل في منزل أحد الجيران، كانت تلك الليلة طويلة جدًا، وعندما شاهدت الأخبار، رأيت أن المنطقة التي تسكن فيها عائلتنا، تل الهوى، تتعرض لقصف عنيف.
كنت أخشى أن لا يشهدوا صباح اليوم التالي، توسلت إليهم أن يذهبوا إلى الجنوب، لكن الرحيل لم يعد خياراً إذ لم يتمكنوا من العثور على سيارة، ولم يكن من الآمن الذهاب إلى أي مكان.
مستشفى القدس قريب من منزلنا، وقد أصبح ملجأ لآلاف الفلسطينيين في غزة منذ اندلاع الحرب، أرادت عائلتي التوجه إلى هناك معتقدة أنه لا يوجد مكان أكثر أمانًا، وتوسلت إليهم مرة أخرى ألّا يذهبوا، لأنني كنت أشاهد مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر غارات جوية حول المستشفى.
قال أخي إن أحد الأصدقاء وعده بأن يصحبه في الصباح نحو الجنوب إذا توقفت الغارات الجوية، وكان علينا جميعا أن ننتظر الصباح، لم يكن هناك شيء آخر يمكننا القيام به.
كانت تلك الليلة هي الأطول في حياتي، ظللت أفكر في أسوأ السيناريوهات، فقلت بهدوء وداعاً لعائلتي.
بقيت أتذكر منزلنا المكون من ثلاثة طوابق، حيث كان والدي وأختي وأخي يعيشون مع عائلاتهم، وفي أقل من ساعة، انقلبت حياتهم رأسًا على عقب، لقد أصبحوا الآن بلا مأوى.
“لا بأس”، ذكرّت نفسي، “إنهم على قيد الحياة، على الأقل، من يهتم ببعض الحجارة على أي حال؟ لقد خلقت المنازل لحمايتنا، وبمجرد فشلها في ذلك، فإنها لم تعد ذات قيمة.”
نقول لأنفسنا هذا الكلام لأننا نشعر بالعجز، في الحقيقة كان هذا المنزل أكثر من مجرد مجموعة من الحجارة، لقد كان منزلنا، وكنت حزينة على تلك الخسارة.
ذكريات المنزل
كان عمري 13 عامًا عندما بنى والديّ هذا المنزل، أتذكر أنهما كانا ينظران إلى التصاميم ويسألوننا أين نريد غرف نومنا، أتذكر جلسات ما قبل النوم والضحك في ذلك المنزل، أتذكر احتفال التخرج الخاص بي، وأذكر أن ابني أمضى الشهرين الأولين من حياته في ذلك المنزل بعد ولادته حيث كان والداي يعتنيان بنا.
كان منزلنا جميلاً، مليئاً بصور الأطفال والأحفاد والمطرزات الفلسطينية اليدوية التي تصنعها والدتي، كانت كثيراً ما تعد الطعام وتستضيف الناس، يمكنك أن تشم رائحة طعامها بمجرد فتح الباب.
لكن كل الذكريات لم تكن سعيدة، فقد تذكرت أيضًا الخوف الذي شعرت به في ذلك المنزل، تذكرت حرب 2008-2009 على غزة، وهي أول حرب أعيشها في حياتي، كنت قد دخلت إلى غرفتي لأصفف شعري وفجأة رأيت من نافذتي مبنى ينهار في الخارج.
أمضينا تلك الحرب جميعاً ونحن جالسين تحت الدرج، بينما كانت الدبابات الإسرائيلية تقتحم تل الهوى، ولا زلت أسمع هدير الدبابات، وصرخات رجل أطلق عليه جندي إسرائيلي النار ونزف حتى الموت وفجأة توقف صراخه.
لم أكن أريد أن أتذكر حربًا أخرى بينما نحن نعيش هذه الحرب.
أعادتني الذكريات إلى عام 2020، آخر مرة رأيت فيها عائلتي في غزة، يومها قامت أمي بطهو جميع الأطعمة التي أحبها بمجرد مجيئي لزيارتها من المملكة المتحدة، مكثت في غرفة نومي القديمة، ولكن هذه المرة مع ابني الصغير، لم أكن أعلم أبدًا أن هذه ستكون المرة الأخيرة التي أكون فيها في المنزل الذي نشأت فيه.
وبينما كنت أتذكر كل هذا، ذكّرت نفسي بأن قلقي الوحيد الآن يجب أن يكون على سلامة عائلتي، لقد قتلت إسرائيل ذكرياتي، لكن عندما يتعلق الأمر بعائلتي، تمنيت ألا يكون حظها كذلك.
“لقد تم تدمير كل شيء”
وفي 30 تشرين الأول/ أكتوبر، اتصل أخي ليخبرني أن عائلتي تمكنت من المغادرة، لقد تم تدمير “الطريق الآمن” الذي أشارت إليه إسرائيل، لذلك سلكوا طريقًا آخر في نزوحهم، وما كان ينبغي أن تكون رحلة مدتها 15 دقيقة، انتهى بها الأمر إلى ساعتين.
وصف أخي الدمار الذي لحق بغزة كما شهده وهو يقود السيارة قائلاً: “لم أتمكن من التعرف على مكان وجودي، لقد تم تدمير كل شيء”.
ذهبت العائلة إلى منزل أحد الأصدقاء جنوب وادي غزة للمرة الثانية، وكانوا قد ذهبوا إلى هناك لفترة في وقت سابق من الحرب بعد أن أمرت إسرائيل في البداية الجميع في الشمال بالمغادرة، لكنهم سرعان ما عادوا إلى ديارهم، بسبب الظروف الإنسانية الصعبة في الجنوب.
قال أخي إنه اضطر ذات مرة لقضاء ساعتين في التنقل من متجر إلى آخر بحثًا عن مياه الشرب وسط الغارات الجوية المتواصلة، وعاد ومعه ست زجاجات من المياه.
ولأن مئات الآلاف من الأشخاص نزحوا إلى الجنوب في نفس الوقت، فقد فاق الطلب العرض بكثير.
ولم تبق عائلتي هناك سوى بضعة أيام هذه المرة أيضًا، بعد أن تعرض الحي الذي كانوا يقيمون فيه لقصف جوي في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر، مما أسفر عن مقتل العشرات.
تتذكر أختي أن الناس كانوا يطرقون باب المنزل الذي كانت تقيم فيه، ويسألون عما إذا كان بإمكانهم الصعود إلى السطح للبحث عن الأطفال المفقودين أو الجثث.
وعندما شنت إسرائيل الغارات الجوية لم يصرخ أحمد، ابن أختي البالغ من العمر أربع سنوات، ولم يبكِ، اعتقدت أختي في البداية أنه مات، حيث تحطمت جميع النوافذ في غرفة النوم التي كان يجلس فيها.
في ذلك اليوم، نزحت العائلة إلى مركز في رفح يستضيف نازحين من الشمال لم يكن لديهم مكان أو عائلة يذهبون إليها، كل أفراد عائلتي على قيد الحياة اليوم، ينامون على الفرش والبطانيات في فصل دراسي، ليس لديهم مطبخ أو ثلاجة، ويتشاركون دورات المياه مع جميع المقيمين هناك، ولا يزال يتعين على أخي الخروج كل يوم للعثور على الطعام والماء والحفاظات.
في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر، أرسلت شقيقتي رسالة تقول: “هالة، لقد استحممت أخيرًا”، لم أستطع أن أستوعب السعادة التي منحتها لي تلك الرسالة.
عندما أفكر في كل هذا، أشعر أنني محظوظة وغير محظوظة في نفس الوقت، فمن حسن حظي أن أفراد عائلتي ما زالوا على قيد الحياة، ولكنني لست محظوظة لأسباب عديدة أخرى، فلم أقابل قط ابن أخي البالغ من العمر خمسة أشهر، سلام، إنني فقط أتساءل عما إذا كان سيعيش طويلاً بما يكفي لأراه، أو سيفارق الحياة بسلام.
للإطلاع على النص الأصلي من (هنا)