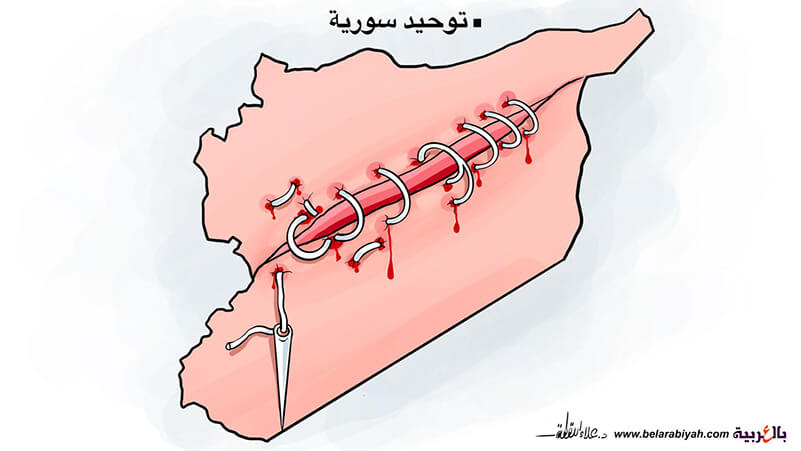بقلم جوزيف مسعد
لا تكل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة من الدفاع عن حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني من خلال استخدام التعويذة المبتذلة التي تنادي بـ”حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”. ففي آب/ أغسطس 2022، قصفت آلة القتل الإسرائيلية الفلسطينيين في غزة على مدار ثلاثة أيام، مما أسفر عن مقتل 49 شخصا، من بينهم 17 طفلا. وكان رد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على المذبحة هو الإعلان بشكل قاطع عن دعمهما لـ”حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها” والتعبير عن الأسف الخافت الصوت على قتل المدنيين الفلسطينيين.
ورغم أن تلك كانت المذبحة الكبرى الأخيرة التي ارتكبتها إسرائيل في غزة قبل حرب الإبادة الجماعية الحالية، فإنها لم تكن الأولى بكل تأكيد. فلكي نؤرخ لحروب إسرائيل على غزة وشعبها، ينبغي أن نعود إلى عام 1951، عندما بدأت إسرائيل بالإغارة على قطاع غزة الذي طردت إليه مئات الآلاف من الفلسطينيين بين نهاية عام 1947 وصيف عام 1950، عندما طردت مَن تبقى من الفلسطينيين البالغ عددهم 2500 فلسطيني من مجدل عسقلان، البلدة فلسطينية الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط. وقد قام الجيش الإسرائيلي بتحميل فلسطينيي مجدل عسقلان (المعروفة بمستوطنة “عشقلون” اليهودية اليوم) على شاحنات وطردهم إلى غزة.
كما قامت إسرائيل بطرد 7000 فلسطيني بدوي إلى مصر خلال تلك الفترة وحتى عام 1955. وفي تشرين الأول /أكتوبر 1951، أغار الإسرائيليون على غزة وقتلوا “العشرات” من الفلسطينيين والمصريين، وهدموا “عشرات المنازل” وفجّروا الآبار، لردع محاولات الفلسطينيين المهجّرين من العودة إلى ديارهم عبر الحدود الدولية الجديدة التي أقامتها المستعمرة-الاستيطانية اليهودية.
وفي وقت سابق من آب/ أغسطس 1949، اعتقل الجنود الإسرائيليون لاجئَيْن فلسطينيَيْن (رجل وامرأة) حاولا العودة إلى وطنهما. فقتلوا الرجل، وتناوب 22 جنديا على اغتصاب المرأة قبل قتلها. وفي آذار/ مارس 1950، اعتقل الجنود الإسرائيليون فتاتين فلسطينيتين وصبيا عادوا من غزة عبر الحدود الجديدة، فقتلوا الصبي واغتصب الجنود الفتاتين ثم قتلوهما.
وقد كان اغتصاب الجنود ورجال الشرطة الإسرائيليين للاجئات فلسطينيات أثناء محاولتهن العودة إلى ديارهن أمرا شائعا في تلك الفترة، ولم يكن أمرا جديدا نظرا لمدى انتشار اغتصاب الصهاينة للنساء الفلسطينيات خلال نكبة 1948، أي قبل ذلك بعامين. فعلى سبيل المثال، في آب/ أغسطس 1950، اغتصب أربعة من رجال الشرطة الإسرائيلية لاجئة فلسطينية كانت تقطف الفاكهة من بستان عائلتها عبر حدود الضفة الغربية.
وقد استمرت الغارات الإسرائيلية على غزة في عام 1952، وبلغت ذروتها في مذبحة مخيم البريج للاجئين في آب/ أغسطس 1953، عندما قتلت الوحدة العسكرية الإسرائيلية رقم 101 ما لا يقل عن 20 لاجئا فلسطينيا، من بينهم سبع نساء وخمسة أطفال، عن طريق إلقاء القنابل عبر نوافذ أكواخ اللاجئين بينما كانوا نائمين، وأطلقت النار على الفارين فأصيب العشرات. وتشير مصادر أخرى إلى أن العدد النهائي للفلسطينيين الذين قتلوا في هذا الهجوم الإسرائيلي لا يقل عن 50 فلسطينيا. لم يذكر المراقبون الأجانب في تلك الفترة “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، بل وصفوا المذبحة بأنها “حادثة مروعة من القتل الجماعي المتعمد”.
وفي العام نفسه، ذبح الإسرائيليون 70 مدنيا فلسطينيا في قرية قبية بالضفة الغربية، وهو ما دفع حتى جريدة “البريد الوطني اليهودي” الصادرة في مدينة إنديانابوليس والموالية لإسرائيل إلى مقارنة مذبحة قبية بالمذبحة التي ارتكبها النازيون في مدينة ليديسي في تشكوسلوفاكيا إبان الحرب العالمية الثانية. وفي شباط/ فبراير 1955، أغار الإسرائيليون على معسكر للجيش المصري في غزة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 36 جنديا مصريا بالإضافة إلى مدنيَيْن فلسطينيَيْن، أحدهما طفل.
وحتى ذلك الحين، كانت السلطات المصرية تعمل على استرضاء الإسرائيليين من خلال حراسة الحدود ومنع “التسلل” الفلسطيني، ولكن بعد الغارة على غزة، انتفض الفلسطينيون ضد السلطات المصرية مطالبين بأسلحة للدفاع عن أنفسهم من الغارات الإسرائيلية المتواصلة. ونتيجة غضبه من الوحشية الإسرائيلية وعدوانيتها وتحت ضغط اللاجئين الفلسطينيين، استجاب الرئيس جمال عبد الناصر للمطلب الفلسطيني. وقامت مجموعة من الفدائيين الفلسطينيين بالانتقام من إسرائيل بمداهمة المستعمرة-الاستيطانية الغاصبة في آب/ أغسطس 1955 والتسلل إلى مسافة تصل إلى 27 ميلا داخل حدودها، ونصبوا كمائن للجنود وزرعوا الألغام وقاموا بمهاجمة المركبات والمباني، مما أسفر عن مقتل خمسة جنود وعشرة مدنيين.
وحتى لا يظن أحد أن الحكومة الإسرائيلية العنصرية اليهودية الحالية هي أول من استحضر قصة “العماليق” التوراتية لتوفير تبرير ديني لحرب الإبادة الجماعية الحالية ضد الفلسطينيين، كما فعل بنيامين نتنياهو مؤخرا، فقد كان في الواقع رئيس الوزراء العلماني ديفيد بن غوريون هو أول من استخدم هذا التشبيه قبل سبعة عقود. فبينما كان عبد الناصر يستعد لصد الغزو الإسرائيلي المتوقع في عام 1956، أعلن بن غوريون أن “جنود العماليق” قد شرعوا في إعادة تسليح أنفسهم من أجل “تدمير دولة إسرائيل وشعب إسرائيل”.
وقد سبق كل هذه الأحداث الغزو الإسرائيلي لغزة ومصر في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 1956. وعندما بدأت إسرائيل باجتياحها لغزة، قصف الإسرائيليون مدينة خان يونس في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 1956 من الجو، مما أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين قبل أن تدخل الدبابات الإسرائيلية المدينة يوم 3 تشرين الثاني/ نوفمبر. وقد قامت قوات الاحتلال باعتقال المقاومين وإعدامهم ميدانيا أو في منازلهم. وفي تلك الأثناء، وفي مخيم اللاجئين المجاور قام الإسرائيليون بجمع جميع الرجال والفتيان فوق سن 15 عاما في ساحة البلدة وشرعوا في إطلاق النار عليهم، مما أسفر عن مقتل ما بين 300 و500 شخص، الغالبية العظمى منهم من المدنيين ونصفهم من لاجئي عام 1948. وقامت إسرائيل بعد تلك المذابح باحتلال غزة وشبه جزيرة سيناء حتى تم إجبارها على الانسحاب من قبل الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي في شهر آذار/ مارس 1957.
أما في الأسابيع القليلة الماضية، فقد شملت المجازر الإسرائيلية المتواصلة في خان يونس، وهي ثاني أكبر مدينة في غزة (والتي أطلقت عليها إسرائيل اسم “منطقة قتال خطيرة” بعد أن كانت بمثابة منطقة آمنة لمليون فلسطيني كانوا قد فروا إليها من شمال غزة)، ذبح 30 مدنيا كانوا يحتمون بمدرسة من القصف الإسرائيلي الوحشي. فالمذبحة المستمرة والتي قتلت فيها إسرائيل عشرات الآلاف منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر تجعل المجازر الإسرائيلية الوحشية في عام 1956 تبدو إنسانية ورحيمة بالمقارنة.
وقد غزت إسرائيل قطاع غزة واحتلته مرة أخرى في عام 1967، وقامت بطرد 75 ألف فلسطيني من القطاع، ومنعت 50 ألف آخرين (كانوا يعملون أو يدرسون أو مسافرين خارج القطاع عندما غزته إسرائيل) من العودة إلى ديارهم. وقد صادرت إسرائيل 60 في المئة من أراضي الفلسطينيين وجميع مصادر المياه، التي خُصص معظمها للاستخدام الحصري للمستوطنين اليهود الذين كانوا يحصلون على 18 ضعف كمية المياه المتاحة للسكان الأصليين الفلسطينيين. وقد خُصص لكل مستوطن من اليهود 85 ضعف مساحة الأراضي (المسروقة) التي خُصصت لأصحاب الأرض الفلسطينيين. وأخضعت إسرائيل كافة السكان الفلسطينيين لاحتلال عسكري عنصري، دمرت خلاله البنية التحتية الاقتصادية للقطاع حتى عام 2005.
ومنذ إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي حول غزة في أيلول/ سبتمبر 2005 واحتجازه لمليونين ونصف مليون فلسطيني في معسكر الاعتقال الذي حوّلت قطاع غزة إليه، شن الإسرائيليون عددا من حملات القصف ضد المدنيين الفلسطينيين والمقاومة الفلسطينية المحتجزين داخل معسكر الاعتقال هذا، بما في ذلك في الأعوام 2006 و2008-2009 و2012 و2014 و2021، قتلت خلالها آلاف المدنيين.
وبما أن النصر الوحيد الذي حققه الجيش الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر هو ذبح الآلاف من المدنيين، وإصابة عشرات الآلاف، وتشريد أكثر من مليون فلسطيني، ناهيك عن تدمير المنازل والمباني السكنية والمستشفيات والمدارس والمكتبات والمباني البلدية والكنائس والمساجد، فقد فقدت إسرائيل سمعتها عن جاهزيتها العسكرية في المستقبل المنظور. ومع تزايد التفاصيل التي تتسرب حول قيامها بقتل مدنييها وتدمير منازلهم في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، فسوف تمر فترة طويلة قبل أن تتمكن إسرائيل من استعادة بعض من الجاذبية العسكرية غير المستحقة التي كانت تتمتع بها في الغرب وبين حلفائها العرب في السابق.
لكن إحدى المفارقات الأكثر إثارة للاهتمام في ظل الحرب الإسرائيلية الحالية هي أنه في حين بدأت الإمبراطورية الأمريكية وأذنابها، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، في إعادة تسليح إسرائيل منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر دون توقف حتى تتمكن المستعمرة-الاستيطانية من مواصلة حرب الإبادة الجماعية، فإن المقاومة الفلسطينية التي لم تصلها أية أسلحة جديدة منذ ذلك التاريخ هي من تواصل تحقيق انتصارات عسكرية ضد الغزاة الإسرائيليين القساة الذين يمارسون الإبادة الجماعية. لم يكن الأمريكيون هم الطرف الرئيس في هذه الحرب ضد هذا الشعب المستعمَر والجريح فحسب، بل ذهب جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس بايدن، إلى أبعد من ذلك أيضا من خلال ربطه الولايات المتحدة بإسرائيل لدرجة أنه أشار إلى الفلسطينيين على أنهم “العدو”. فقد ذكر سوليفان أنه “ناقش الشروط والتوقيت المناسب لإسرائيل لإنهاء المرحلة الحالية من عملياتها مع القادة الإسرائيليين”. لكنه رفض تحديد إطار زمني، قائلا إن أيا منهما لا يريد “إرسال برقية للعدو حول الخطة”.
فإذا كان أمريكيون مؤيدون لإسرائيل قد شبهوا مذبحة قبية عام 1953 بالمذبحة النازية في ليديس، وكتب كاتب العمود الإسرائيلي الأشكنازي الشهير يهوشوا رادلر فيلدمان، المعروف بالاسم المستعار “الحاخام بنيامين”، عن المذبحة التي ارتكبها الجنود الإسرائيليون في قرية كفر قاسم داخل إسرائيل في عام 1956 والتي راح ضحيتها 50 فلسطينيا من “مواطني إسرائيل”: “إننا قريبا سنصبح مثل النازيين ومرتكبي المذابح”، فإنه يشير اليوم كل من المسؤولين الإسرائيليين والمتحدثين باسم المقاومة الفلسطينية إلى بعضهم البعض بصفة “نازيين”.
ولكن إذا كان المسؤولون الفلسطينيون في المقاومة يشيرون إلى الحكومة الإسرائيلية وجيشها على أنهم نازيون وفاشيون، فإن المسؤولين الإسرائيليين يشيرون إلى الشعب الفلسطيني ككل على أنهم “نازيون”. ونظرا للخطاب العنصري البغيض الذي تستخدمه إسرائيل الرسمية بشأن الفلسطينيين باعتبارهم “حيوانات” و”دون البشر”، والقوة غير العادية لآلة القتل الإسرائيلية العشوائية، والنطاق الفلكي لفظائع الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، فإن مدى ملاءمة أو عدم ملاءمة هذا التشبيه هو أمر متروك للمراقبين. ولكن الحقيقة الساطعة أنه وعلى الرغم من أن الحجم المهول للفظائع الإسرائيلية في غزة لم يسبق له مثيل، إلا أن طبيعة هذه الجرائم غير الإنسانية تبقى جزءا لا يتجزأ من حلقات الحرب المستمرة التي تشنها إسرائيل بدعم لا محدود من حلفائها الأمريكيين وأتباعهم على الشعب الفلسطيني منذ عام 1948.
للإطلاع على النص باللغة الانجليزية من (هنا)