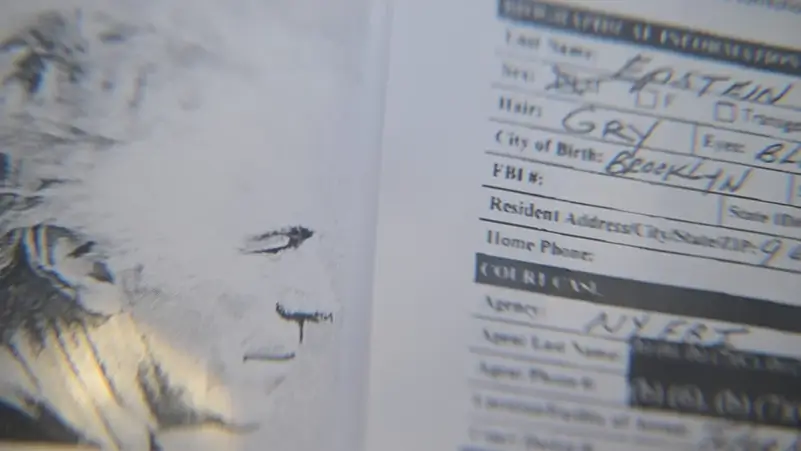بقلم حمزة صالحة
ترجمة وتحرير مريم الحمد
كان هناك أمامنا خياران لا ثالث لهما عندما اضطرت عائلتي إلى النزوح من جباليا قبل شهر، فإما أن نموت وندفن تحت الأنقاض أو على الطريق لتمزقنا الكلاب الضالة، أو أن نبقى على قيد الحياة مع التهديد المستمر بالموت الذي يلوح في الأفق فوقنا ونتحمل الطعم المرير لنكبة أخرى حتى نموت.
لقد تحولت جباليا إلى صحراء قاحلة حقاً خلال هذه العملية، فلم يكن هناك ماء أو طعام أو مكان آمن، وتحولت المستشفيات والمدارس إلى أنقاض فأصبح العيش هناك أصبح مستحيلاً
منذ اللحظة التي اخترنا فيها الخيار الثاني، فقد أصبحنا لاجئين للمرة الثانية خلال زمن لم يتجاوز جيلين من العائلة، فقد اضطررنا إلى ترك الشقق والمباني والأراضي التي كانت تعني لنا كل شيء، وفي لمح البصر لم يعد لدينا أي شيء.
في جباليا، كرّس والدي سنوات من العمل الشاق لبناء شقة لي بمساحة 200 متر مربع لعائلتي المستقبلية، حيث تم اختيار كل بلاطة وزخرفة بكل حب، ولكن بعد أن بدأت الحرب، اشتريت معدات الطاقة الشمسية للشحن والإضاءة ولم أعد أفرط في الإنفاق لأنني كنت أخشى من مجيء يوم حيث أضطر لترك كل شيء خلفي فيه.
صحراء قاحلة
منذ بداية الحرب على غزة، شن الجيش الإسرائيلي 3 عمليات برية وحشية على جباليا، وفي الوقت الذي لا تزال فيه العملية الثالثة مستمرة، فلا زال هناك مئات الجثث التي بقيت تحت الأنقاض أو متناثرة في الشوارع وداخل المنازل.
بدأت العملية الثالثة في مساء يوم 5 أكتوبر عام 2024، عندما بدأ الجيش الإسرائيلي بتنفيذ غارات جوية مكثفة، مما مهد الطريق لغزو بري في صباح اليوم التالي من الجانبين الشرقي والغربي لجباليا.
أجبرنا التوغل الإسرائيلي على الفرار من الملجأ الذي بحثنا عنه والعودة إلى منزلنا في وسط جباليا، حيث تجمع جميع أقاربنا، فقد كنا نأمل أن تكون العملية محدودة وأن ينسحب الجيش بعد يومين.
لقد تحولت جباليا إلى صحراء قاحلة حقاً خلال هذه العملية، فلم يكن هناك ماء أو طعام أو مكان آمن، وتحولت المستشفيات والمدارس إلى أنقاض فأصبح العيش هناك أصبح مستحيلاً.
وبعد يومين، في مساء يوم 7 أكتوبر، شن الجيش غارة جوية عنيفة على مقربة منا، مما أدى إلى اهتزاز أساسات منزلنا، وبعد دقيقتين فقط، لفظ جدي أنفاسه الأخيرة وتوفي، حيث قضى يومه الأخير وهو بالكاد يلتقط أنفاسه لاهثاً من الخوف وشفتاه ترتجفان حتى فارق الحياة.
في ذلك الوقت، كانت الآليات العسكرية الإسرائيلية على بعد أمتار قليلة من منزلنا وقد حاصرت المقبرة، مما جعل دفن جدي أمراً مستحيلاً، وفي صباح يوم 8 أكتوبر، اتصلنا بالمستشفى وطلبنا سيارة إسعاف، لكنهم أخبرونا أنهم لا يستطيعون التحرك أو الوصول إلينا، فاضطررنا لدفنه في المنزل.
بدأنا أنا وإخوتي بحفر القبر، فمنا باختراق طبقة من الخرسانة بسمك 7 سم، ثم حفرناها في الرمال بعمق 60 سم وطول 170 سم، وكنا نعمل تحت وابل الضربات والتفجيرات وإطلاق النار، واستعرنا قطعة قماش كبيرة من جارنا الخياط لتكون بمثابة كفن في غياب سيارات الإسعاف والمواد المناسبة.
قمنا بتغسيل جثمان جدي وصلينا عليه وودعناه وقمنا بدفن جدي الذي لم يحرمه الجيش الإسرائيلي من الطعام والماء والدواء والأمن فحسب، بل حرمه أيضاً من حقه في العزاء والدفن بكرامة، ومع ذلك يظل جدي محظوظاً لأنه وجد من يدفنه على عكس الكثيرين في غزة!
دوار الموت
في مساء اليوم التالي، يوم 8 أكتوبر، جلست على الكرسي أستمع إلى الأخبار وقلبي يخفق، فقد كان كل تقرير بمثابة العد التنازلي لكارثة، مما دفعني إلى التحرك، خاصة بعد أن أعلنوا أن العملية قد تستمر لأسابيع أو أشهر، فنظرت من النافذة إلى الشارع المؤدي إلى مدينة غزة ورأيت مجموعتين من العائلات تعبران أحد الممرات.
في تلك اللحظة، خطرت في ذهني العديد من الأفكار المتسارعة، فقد تكون هذه فرصة قد لا تأتي مرة أخرى، فمن ناحية أنا طالب جامعي ولن أستطع تحمل تكاليف الابتعاد عن دراستي عبر الإنترنت لأسابيع أو أشهر في كل مرة.
علاوة على ذلك، فإن مياه الشرب والطعام في المنزل، الذي يتقاسمه حوالي 50 شخصاً، سوف ينفد في غضون أيام، فماذا سيحدث لو استمر هذا لأسابيع أو أشهر؟!
لم يكن لدي الكثير من الوقت، لذلك ارتديت حذائي بسرعة وحزمت حقائبي واستعدت للنزوح إلى مدينة غزة، فانتقدتني عائلتي وحثوني على عدم المغادرة، لكنني صممت على الإخلاء والمرور عبر ذلك الدوار الذي أطلق عليه مؤخراً اسم “دوار الموت”، حيث قُتل العديد من المدنيين أثناء محاولتهم العبور.
على طريق صلاح الدين، كانت الدبابات تنثر الغبار في وجوه الناس، والأطفال يبحثون عن آبائهم، والحقائب متناثرة في كل مكان على الأرض، ومع تطاير الرصاص في الهواء، كانت العائلات تحاول الإسراع فسقطت النساء على الأرض من ثقل الألم والتعب، وكانت قلوبهن ترتجف من الخوف
حاولت والدتي مساعدتي بسرعة في تجهيز حقائب الإخلاء، بما في ذلك الطعام والمناشف والملابس، لكن والدي قاطعني قائلاً: “لا تخرج، فقد أعلنوا على الأخبار للتو أن الجيش يقصف الطريق الذي ستمرون به الآن بشدة”.
تجاهلت مناشداتهم وأنا أدرك أن نتيجة هذه الرحلات الصعبة غالباً ما تعتمد على قرارات سريعة وتفاصيل دقيقة يمكن أن يكون لها عواقب تغير الحياة، ولذلك كان المطلوب هو السرعة والحسم، فاندفعت مسرعاً إلى الشارع المؤدي إلى “دوار الموت”، أخطو بخطوات سريعة فيما كان أهلي يراقبونني من النافذة مذعورين.
تضخم الخوف الشديد في داخلي عندما حانت اللحظة التي سأقطع فيها تلك الأمتار القليلة عند وصولي الدوار، وشعرت وكأن قلبي على وشك أن يخترق قفصي الصدري من قوة نبضه، فقد كان الطريق مليئاً بالركام، لكن جسدي كان معتاداً على الركض لساعات، وكنت على استعداد لعبور المسافة فوق أنقاض المنازل المدمرة بأسرع ما أستطيع.
دفعت نفسي وركضت حتى وصلت إلى بر الأمان، حيث وجدت صحفيين يخاطرون بحياتهم لالتقاط بعض الصور وإجراء مقابلات مع النازحين الذين يعبرون ذلك الدوار، وبمجرد وصولي إلى مدينة غزة، أرسلت رسالة نصية إلى والدي: “لقد فعلتها، هههه!”، فقد أردت أن أطمئنه وبقية أفراد عائلتي بأنني في أمان، وكنت سعيداً لأنني هربت من الجحيم من ناحية، ولكنني حزين لفراق عائلتي أيضاً.
رعب لا ينتهي
فقدت الاتصال بعائلتي لمدة أسبوعين بعد تلك اللحظة، ثم التقيت بهم مرة أخرى على مراحل، فلم أتمكن من الاتصال بهم بسبب انقطاع الاتصالات والإنترنت، ولكن عندما التقينا أخيراً مرة أخرى، كان لدى أخواتي، إيمان وإيناس الكثير ليحدثوني به من قصص الرعب التي عاشوها مع أسرتيهما.
أخبرتني إيمان كيف قام الجيش بزرع طائرات بدون طيار متفجرة قبل أيام في المنازل المجاورة، وفي ليلة 17 أكتوبر، استيقظت إيمان وزوجها عطية على أصوات غريبة قادمة من الخارج، وسرعان ما امتلأت المنطقة المحيطة بهم بأصوات نيران الطائرات بدون طيار، وتصاعدت أصوات إطلاق النار التي أصابت جدران الغرفة الصغيرة التي كانت تؤوي أسرتها.
احتضنت إيمان أطفالها وهمست لهم بصوت يكاد يكون مسموعاً، بينما أطفأت الضوء الخافت ووضعت هواتفهم على وضعية الطيران، في محاولة لجعل المنزل يبدو خالياً، وفجأة، دوى انفجار هائل، فشعرت إيمان بالدوخة وصرخت بزوجها: الأولاد يا عطية، أين مؤمن؟
تجمد قلبها عندما لم تعد ترَ ابنها البالغ من العمر سنة واحدة حتى رأته أخيراً يطل برأسه من بين حجرين، وخرجت الأسرة من تحت الأنقاض سالمة ولكن بدون ممتلكاتهم التي تركوها وراءهم.
أما إيناس وعائلتها النازحة في منزل إيمان، فقد عاشوا أهوالاً لن ينسوها، حيث وصفت لحظات انفجار البرميل، حين شعرت بتوقف قلبها، مشغولة البال على سلامة أطفالها، عندما ناداها صوت زوجها: “هل أنت بخير؟” وعندما سمعت أصوات أبنائها وهم يستجيبون لها، عادت إليها الحياة من جديد.
رغم تقدمه في السن، إلا أنه لم تظهر على والدي أي علامات للشيخوخة حتى ويلات هذه الحرب الوحشية
هربت كل من إيمان وإيناس إلى مستشفى كمال عدوان، لكن الجيش اجتاحه بعد يومين، فاضطروا هم ومرضى آخرون إلى إخلاء المكان تحت أعين الطائرات والجنود، ولم يكن أمامهم خيار سوى حمل أطفالهم والمغادرة سيراً على الأقدام بحثاً عن ملجأ آخر.
مسافات مؤلمة
في 24 أكتوبر، لم تعد أسر إيمان وإيناس الصغيرة قادرة على تحمل صدمة الحياة في جباليا، فقد كان قرار الإخلاء مؤلماً لكن لا مفر منه، فجهزت كل من إيمان وإيناس ما أمكنهما من الإمدادات الطارئة وبدأتا رحلتهما نحو شارع بيت لاهيا الطويل.
عند وصولهما إلى نقطة التفتيش العسكرية قرب المستشفى الإندونيسي، صدر أمر باعتقال الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاماً، فوجدت إيمان نفسها تحمل حقيبتها على ظهرها وأطفالها بين يديها، وتستمر في السير بمفردها في الطريق مع طفلها البالغ من العمر 5 سنوات دون زوجها.
على طريق صلاح الدين، كانت الدبابات تنثر الغبار في وجوه الناس، والأطفال يبحثون عن آبائهم، والحقائب متناثرة في كل مكان على الأرض، ومع تطاير الرصاص في الهواء، كانت العائلات تحاول الإسراع فسقطت النساء على الأرض من ثقل الألم والتعب، وكانت قلوبهن ترتجف من الخوف.
كانت رموش زينة بيضاء من الغبار، وهي تبكي بصوت منخفض وتقول: “أين بابا؟”، ولكن إيمان، التي تعثرت بأقسى تجارب حياتها ممسكة بأطفالها وسط رائحة الموت والغبار، لم تكن تملك إجابة.
كان والداي اللذان يبلغان من العمر 66 عاماً، لا يزالان محاصرين لوحدهما في المنزل الواقع في قلب جباليا، حيث أمضوا ما يقرب من 20 يوماً محاطين بصفوف من الجنود والمركبات، ولم يتوقف القصف وإطلاق النار حتى أصبح الوضع لا يطاق.
وقد نجا والداي من الموت بأعجوبة عدة مرات خلال هذا الحصار، خاصة أثناء تفجيرات المنازل المجاورة، حيث هلك من ظلوا بالداخل تحت الأنقاض وما زالوا هناك حتى يومنا هذا، وهذا ما دفع والدي إلى اتخاذ قرار بالإخلاء إلى مدينة غزة، فحزموا بعض الحقائب وأقنعوا أحد جيران المنزل المجاور، الذي كان بمفرده، بالخروج معهم عبر طريق فرعي.
لقد شكل هذا النزوح تحدياً كبيراً لوالدي، فوالدتي، التي تعاني من مرض السكري وتحتاج إلى استبدال الركبة، بالكاد تستطيع المشي، فكيف يمكنها قطع هذه المسافة سيراً على الأقدام على طريق وعر تتناثر فيه أنقاض المنازل المدمرة؟!
رغم ذلك، أصر والدي على الذهاب، ممسكاً بيد والدتي بينما كان جارنا يساعدنا في حمل الحقائب، ثم وجد والدي عصاً ليتكئ عليها في الرحلة، ويتنقل عبر الطريق تحت نيران الطائرات بدون طيار.
رؤية والدي في مثل هذه الحالة المؤسفة عندما رحبت بهم واحتضنتهم عند وصولهم إلى مدينة غزة، ملأتني بالغضب، فقد كانت خدودهم غائرة وأجسادهم هزيلة من قلة الطعام، فرغم تقدمه في السن، إلا أنه لم تظهر على والدي أي علامات للشيخوخة حتى ويلات هذه الحرب الوحشية.
للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)