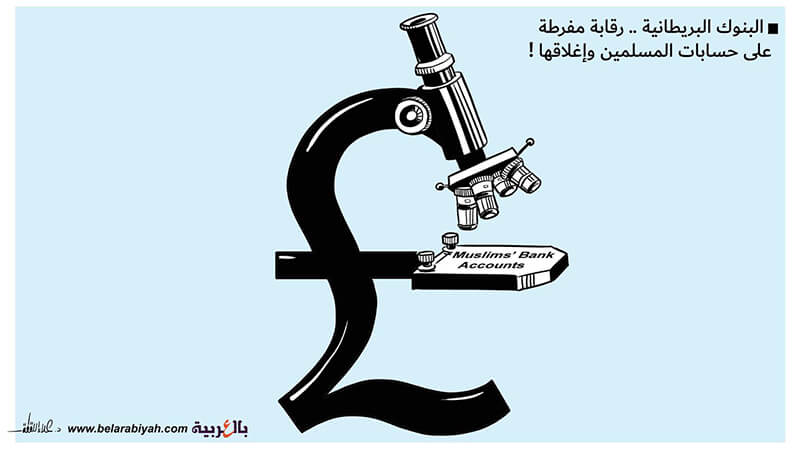بقلم هالة درة
ترجمة وتحرير مريم الحمد
خلال 16 شهراً، كان روتيني اليومي يبدأ وينتهي بمراجعة القصص الإخبارية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي حول غزة، فقد كنت أستيقظ صباحاً أتصفح رسائل الواتساب من أفراد عائلتي في غزة، وفي نفس الوقت أجهز أطفالي ليصبحوا جاهزين لتلقي دروسهم المدرسية عبر زوم.
كان لابد من تلك الخطوة الصباحية لتدريب نفسي على مواجهة الخوف والرهبة التي أشعر بها كل صباح، فمع مرور الوقت، أصبح عدد الشهداء من أفراد الأسرة 10 ثم 20 ثم 30، واستمرت الأرقام في الارتفاع، حتى فقدنا ما لا يقل عن 100 من أفراد الأسرة وأفراد الأسرة الممتدة.
تعرفت على الفور على اسم الطبيب الشهيد، وسرعان ما أرسلت رسالة إلى والدتي التي أكدت شكوكي، فهو ابن عمنا، أحمد، كان عمره 35 عاماً ويعمل في المستشفى الأوروبي في غزة
أحاول أن أتمالك حزني كل يوم، فأن يصبح جزءاً من روتيني هو قراءة الأخبار لمعرفة ما إذا كان أحبائي أحياء أم أمواتاً، أصبح هو الأمر الطبيعي الذي جعل حياتي بائسة، فقد رأيت وجوه أطفالي في كل صورة وفيديو من غزة، وبكيت مع الأمهات وهم يقبلون أطفالهم وبكيت مع الأطفال وهم يعانقون قبور أمهاتهم.
أمسح دموعي بعد ذلك كل يوم لأوهم نفسي بأن كل شيء في حياتي كان طبيعياً مع علمي بأنه لن يكون طبيعيا مرة أخرى!
يعيش عدد من الفلسطينيين من غزة في الشتات، في دولة آمنة في مكان ما بالعالم، ولكننا نحمل معنا عقدة ذنب لأننا نجونا من الإبادة، فنحن مصابون بالصدمة ونحن نراقب العالم يعمل على تطبيع المذبحة التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة، وندرك أننا، كامتداد لهم، سوف نعاني من نفس المصير إذا انقلبت الأدوار.
ألم لا يتوقف
تغير شهادتك على القتل الجماعي لأفراد عائلتك حياتك إلى الأبد، فهو ألم ثقيل ولا يلين، يسحبك مثل تسونامي، يشبه ما شعرت به حين عرفت أن ابنتي مصابة بمرض عضال.
تعلمت أن أحمل الألم بداخلي وأنا أمارس أدواري كأم وفي العمل بكثير من الحب والأمل، فأسوأ ما حصل في شهور الإبادة، بخلاف تحمل فقدان أحبتنا، كان سماع الآخرين ينكرون آلامنا ويبررون جرائم القتل ويحاولون تجريد شعبنا من إنسانيته.
كانت ابنة عمي نسرين ذات عيون زرقاء لامعة ومثلها إحدى بناتي، وقد قُتلت نسرين في غارة جوية، مما دعاني للتساؤل عن لحظاتها الأخيرة؟ هل سمعت صراخ صغارها قبل أن يقتلوا؟ كان من الممكن أن أكون نسرين، ولكنه القدر الإلهي والحظ فقط.
أما ابن عمي وسيم، صاحب الابتسامة اللطيفة، فقد شوهد آخر مرة على إنستغرام وهو يصرخ في وجه حرس الحدود المصريين، مناشداً إياهم بفتح الحدود: “سنموت جميعاً هنا، سوف يقتلوننا جميعاً”، ثم ما لبث أن استشهد وسيم في الأسبوع التالي، ولكن كلماته على انستغرام سوف تطاردني إلى الأبد.
أصيب ابن وسيم الأصغر بإصابة في الدماغ نتيجة الهجوم، وقد علمت بالأمر من خلال منشور على موقع إنستغرام يظهر فيه وهو نائم على صندوق من الورق المقوى ملفوف بقطعة قماش ملطخة بالدماء.
أحلام تحطمت
في شهر ديسمبر الماضي، قرأت قصة طبيب تجمد حتى الموت في خيمته في غزة، فالكثير من الناس في غزة يعيشون في الشوارع أو في خيام واهية، مما يجعل الطقس البارد أكثر فتكاً.
تعرفت على الفور على اسم الطبيب الشهيد، وسرعان ما أرسلت رسالة إلى والدتي التي أكدت شكوكي، فهو ابن عمنا، أحمد، كان عمره 35 عاماً ويعمل في المستشفى الأوروبي في غزة.
اعتنت عائلة أحمد بجدتي خلال سنواتها الأخيرة، وكان عمي الأكبر ممتناً جداً لدرجة أنه وعد بتمويل التعليم الطبي لأحمد عندما يحين الوقت، وقد أوفى بهذا الوعد.
كانت هذه قصة نجاح لصبي في غزة كان يحلم بأن يصبح طبيباً وحوّل ذلك إلى حقيقة، حيث يحلم الكثير من الأطفال في غزة بأحلام كبيرة، ولكنهم يرون تلك الأحلام تتحطم تحت وطأة القمع الإسرائيلي وانعدام الفرص كل يوم.
سأحكي للعالم، الذي يحاول تجريدهم من إنسانيتهم، كل يوم عن إنسانيتهم، وسأحمل أسماءهم في قلبي دائماً وأشارك قصصهم، فأنا لا أريد أن يحصل تطبيع مع كل هذه الجرائم ويصبح موت الغزاوي طبيعياً!
تمت إضافة اسم أحمد إلى قائمة طويلة من العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين قتلوا في غزة، فقد بقي مع مرضاه حتى أغمض عينيه في خيمته ولم يستيقظ قط.
يطاردني تخيل جثة أحمد المتجمدة والهامدة في الخيمة، تماماً كما تفعل كلمات وسيم الأخيرة، هنا في الولايات المتحدة حيث أعمل كناشطة لتحسين مجال الرعاية الصحية في غزة، فقد شعرت بالهزيمة عندما قرأت اسم أحمد، ورغم عملي وشغفي لتحسين الرعاية الصحية في وطني غزة، إلا أنني أدركت أنه لم يكن بإمكاني فعل أي شيء لإنقاذه.
في قلبي للأبد
على مدى 16 شهراً متواصلة، قمت بالاتصال بممثلين في الكونغرس للدفاع عن شعب غزة، وحضرت الاحتجاجات وحملات التوعية المنظمة، كما تطوعت بوقتي لدعم الطلاب والأسر التي كانت تعاني من التنمر والتمييز، ولكن كل هذه المحاولات المتواضعة بدت وكأنها فشل ذريع عندما قرأت اسم أحمد.
لقد مات أحمد، قُتل في هذه الإبادة الجماعية الوحشية، وقد بات الآن رقماً آخر لصبي في غزة أصبح رجلاً قد قُتل حلمه، لكم أن تتخيلوا بأنه عامل رعاية صحية انقطعت أنفاسه في مكان يستهدف فيه!
وأنا، التي يُطلق عليها مدافعة عن مجال الرعاية الصحية، عاجزة عن فعل أي شيء، فأنا أدافع عن زملاء أحمد هنا في الولايات المتحدة فقط، رغم أن معظمهم لم يدافعوا قط عن أحمد وزملائهم في غزة.
رغم وقف إطلاق النار في غزة، إلا أن روتيني اليومي مستمر، وذلك تكريماً لذكرى أحبابنا، فلا أستطيع أن أسمح لنفسي بالتوقف عن الاهتمام بالآخرين، فقد استمر أحمد في رعاية مرضاه حتى النهاية، ويجب أن أستمر أنا في رعاية أولئك الذين أدافع عنهم كل يوم.
في الوقت نفسه، لن أتخلى عن الدفاع عن عائلتي في غزة وعن جميع الفلسطينيين، سأحكي للعالم، الذي يحاول تجريدهم من إنسانيتهم، كل يوم عن إنسانيتهم، وسأحمل أسماءهم في قلبي دائماً وأشارك قصصهم، فأنا لا أريد أن يحصل تطبيع مع كل هذه الجرائم ويصبح موت الغزاوي طبيعياً!
للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)