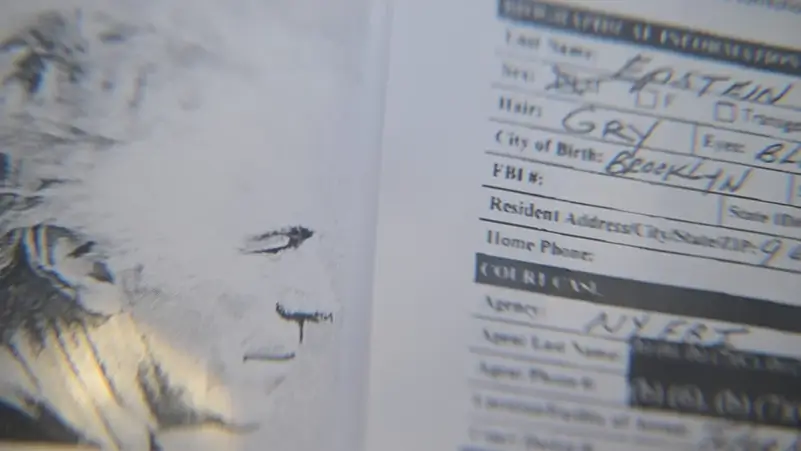بقلم جودي السعافين
ترجمة وتحرير نجاح خاطر
“جودي، أرجوكِ أخرجيني من هنا. أنا منهك.”
“جودي، هل من أخبار جديدة؟”
كانت تلك آخر رسائل أرسلها لي أبناء عمي وديع (23 عامًا) وأحمد (22 عامًا) عشية استشهادهما في 27 أبريل/نيسان 2025.
في ذلك اليوم، كانت حرب دولة الاحتلال على غزة قد دخلت يومها الـ 568 — إبادة جماعية امتدت لأشهر، اجتثت أرواحًا لا تُعد، بينهم اثنان من أقرب الناس إلى قلبي.
أنا إحدى قريباتهم القلائل المقيمات في ما يُسمى “أرض الأحلام والفرص”، الولايات المتحدة، لكن تلك البلاد، بدل أن تمنحهم الأمل، موّلت كوابيسنا.
كان ذلك ظهيرة أحد الأيام، حين خرجا إلى مقهى بسيط على شاطئ النصيرات لشحن هواتفهما والوصول إلى الإنترنت، دقائق فقط فصلت تلك اللحظة عن استهداف الطائرة المُسيّرة التابعة لجيش الاحتلال للمكان ، بقي المبنى سليمًا، لكن مَن بداخله قضوا جميعًا.
استشهد ستة شبان: محمد الجبدي، هاشم الصفطاوي، سلامة الصفطاوي، إبراهيم وشاح، أحمد السعافين، ووديع زيادة.
لم يكونوا مجرد أسماء أو أرقام، بل أرواحًا نضرة، وإخوة وأبناء وأصدقاء أعزاء
في أعقاب المجزرة، انتشرت صورهم على وسائل التواصل الاجتماعي، جالسين حول طاولة، مجمّدين في لحظاتهم الأخيرة، أحد المعلقين الغربيين توقف عند “هدوء” ملامح أحمد، فيما كانت والدته تنوح على جثمانه.
لكن تلك الصورة، رغم انتشارها، لم تقل شيئًا عنهم، عمّا كانوا عليه في حياتهم.
أكتب الآن لا لأحكي فقط عن موتهم، بل لأذكّر العالم أنهم عاشوا.. وأنهم كانوا جديرين بالحياة.
كانت أول زيارة لي إلى غزة في عام 2013، كنت حينها في التاسعة من عمري، وجئت مع عائلتي لزيارة جدي المريض، لا أذكر سوى القليل من تلك الرحلة، لكنني ما زلت أحتفظ بلطف وديع ووالده في ذاكرتي.
كنا نحشر أنفسنا في غرفة صغيرة، يتقاطع فيها الضحك مع الجدال حول أي فيلم نشاهد، ذهبنا إلى الشاطئ، سبحنا، لعبنا في الحدائق، كانت لحظات عشنا فيها معنى الحياة البريئة، لم نكن نعلم أنها ستمزّق قريبًا.
بعد عام، خلال العدوان الإسرائيلي عام 2014، استشهد والد وديع، وكنت آنذاك في الولايات المتحدة، أتابع أخبار المجازر من خلف الشاشة، لحظة واحدة كانت كافية لتسرق منا الطفولة وتصبغ ذكرياتنا بالحزن.
غيّر فقدان والد وديع مسار حياته، حيث كرّس نفسه ليجعل أباه فخورًا به، وسعى ليصبح طبيبًا، ولم يتوقف يوماً عن المحاولة.
وعندما عدت إلى مدرستي الأمريكية، لاحظت أن لا أحد من زملائي أو المعلمين كان يدرك شيئًا مما حصل في غزة، حينها، أدركت أنني أريد أن أكون صحفية.
وفهمت منذ صغري، أن وسائل الإعلام لا تكتفي بعدم تغطية جرائم دولة الاحتلال، بل تتواطأ في طمسها.
كنت أريد أن أروي حكاية الرجل الذي اصطحبنا لتناول المثلجات على الشاطئ — لكنني رغبت أيضًا أن أُظهر للعالم النظام الذي قصفه حتى الموت، والمؤسسات التي سمحت له بالاندثار.
لقاء جديد وحكايات لا تُنسى
عدت إلى غزة عام 2019، لزيارة جدتي التي كانت تعاني من تدهور في صحتها، هذه المرة كنت أكبر سنًا — وربما أكثر غرورًا — وأقل فهمًا مما اعتقدت.
بدأت أتكلم عن فلسطين كما لو كنت خبيرة، وكان أقاربي ينصتون بلطف، لأن هذا أكثر مما يتوقعونه من معظم الأمريكيين.
في تلك الزيارة، استعدت علاقتي بأبناء عمومتي، توطدت صلتي بشكل خاص مع وديع الذي كان يحب مثلي الأحاديث الطويلة، سواء أكانت عميقة أم عبثية، منذ ذلك الحين، لم نتوقف عن التحدث.
كان وديع رومانسيًا للغاية، يعشق المسلسلات، من “باب الحارة” إلى “فريندز”، و يتجادل معي حول ما إذا كان روس ورايتشل في “فترة انفصال” فعلًا.
كان فخورًا بحزامه الأسود في الكاراتيه، و بحصوله على المراتب الأولى في البطولات، لكنه لم يُمنح أبدًا فرصة المنافسة خارج غزة بسبب حصار الاحتلال.
لم تكن أحاديثنا بعيدة عن السياسة، بل كانت تتقاطع دائمًا مع السخط من القوى التي حبست عائلتنا داخل غزة ومنعتني من زيارتهم متى شئت — الاحتلال والحصار، بدعم أمريكي مستمر.
وبحلول عام 2023، كنت أدرس العلوم السياسية، وكان وديع يدرس الصيدلة، كنا نُنفذ ما خططنا له ونحن أطفال، ثم اندلعت الحرب!
عندما غطّت الحرب على الأحلام
مع بدء عدوان دولة الاحتلال على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، استبد بنا الذعر، وكان وديع يعلم أنه يجب أن يغادر غزة، لكن ذلك لم يكن ممكنًا.
بعد استشهاده، لم أفكر إلا في أمر واحد: كان يجب علي أن أفعل المزيد، لم أملك المال الكافي لإخراجهم، ولا العلاقات الكافية لإنقاذهم، كنت طالبة جامعية فقط، لكن ذلك لم يمنعني من الشعور بالذنب العميق.
كان أقصى ما أستطيع فعله هو الحفاظ على التواصل، كنا نتحدث بانتظام كلما عادت خدمة الكهرباء في غزة، وأصبح تطبيق “سناب تشات” وسيلتنا السريعة الوحيدة، ليرسل لي علامة صغيرة يطمئنني بها أنه ما زال بخير.
وفي ظل الحصار المتصاعد، بدأت أتحدث أكثر مع أحمد، ابن عمي الآخر، الذي كان كلما سألته عن حاله، أنهى إجابته بنكتة — غالبًا ما كانت قاتمة إلى درجة لا يمكن لغير أهل غزة أن يفهمها.
منذ أن كان في الثالثة عشرة، عمل أحمد في كل شيء: من بيع الحاجيات على شاطئ البحر إلى أعمال البناء المؤقتة، لم يكن يسعى للمال فقط، بل كان يكره الجلوس بلا فائدة.
حتى خلال الحرب، ظل يبحث عن عمل، ينتقل من مكان إلى آخر بعدما تُقصف المتاجر أو تُغلق بسبب شحّ الإمدادات، لقد كان على وشك التخرج هذا العام، وكان حلمه أن يصبح مصمم ديكور داخلي.
في محادثاتنا، كان واضحًا أن صوتهما بات أكثر تعبًا، وصورهما تُظهرهم أنحف وأكثر إنهاكًا، كانا يعتمدان على بعضهما البعض، وعلى أصدقائهما، للبقاء متماسكين نفسيًا.
الطعام كان شحيحًا، والعمل نادرًا، والمساعدة عبئًا لا يريدان طلبه، لكن الحرب بدت أبدية، بلا مخرج.
كان وديع وأحمد يُعيلان أشقاءهم وأقاربهم، فأي قرش يحصلون عليه كان يتبخر سريعًا، تخيل أن أحمد لم يتذوق “الرامين” (الإندومي) — تلك الوجبة السريعة التي نأكلها في الجامعات دون تفكير — إلا بعد شهور من بدء الحرب.
ومع ذلك، كانا يصران على سؤالي عن يومي، عن مشاكلي، عن دراستي، كنت أتحدث عن واجباتي الجامعية، أو عن خلافاتي مع صديقتي، وكان وديع يطلب مني أن أتحلى بالقوة، بينما كان أحمد يضحك ويطلب مني أن أكون صبورة.
كنا نتحدث عن كل شيء: العائلة، المستقبل، الله، وحتى مؤثري إنستغرام، لم يخطر ببالي يومًا أن هذه المحادثات ستتوقف فجأة، و أنني سأفقدهم إلى الأبد.
لمن تُكتب هذه الكلمات؟
أكتب هذه الكلمات لأن أبناء عمي لم يكونا مجرد “ضحايا” أو “أرقام”، بل كانا بشراً، طيبين، مجتهدين، مرحين، أذكياء — وكانوا أحياء، لم يطلبا الموت، بل أرادا فقط أن يعيشا بحرية، خارج دائرة العنف والقمع التي فُرضت عليهما.
تخرج وديع من الجامعة قبل استشهاده بأربعة أشهر فقط، محققًا حلم والده، فيما كان أحمد يعمل بلا توقف، دائمًا ما كان مشغولاً، يبحث عن وسيلة للصمود.
كل ما احتاجاه لم يكن “مساعدة”، بل وقفًا دائمًا لإطلاق النار، نهاية للحرب، وكسرًا لحصار دام عقودًا.
بعد استشهادهما، انتشرت مقاطع قديمة لوديع يتحدث فيها عن دراسته وسط القصف وانقطاع الكهرباء، رافضًا أن يسمح للدمار أن يسلبه مستقبله، لكن وجه أحمد الهادئ، بينما تبكي والدته فوق رأسه، أسَر قلوب الملايين.
إلا أن هذه اللحظات — رغم قوتها — لا تُظهر إلا القليل عنهم.
بعد أسبوع من استشهادهما، قتلت قوات الاحتلال عمنا يحيى السعافين، بينما كان يوزّع المساعدات على أقاربه الناجين، تاركاً خلفه أربعة أطفال.
لا توجد فسحة للحزن، ولا مكان للشفاء، فأحباؤنا يُطاردون حتى في حدادهم، وهم يتضورون جوعًا
لهذا أكتب، لأحافظ على ذكراهم حيّة، ولأخبر العالم الذي لم يعرفهم في حياتهم، أن لهم حياة تستحق أن تُروى.
رحمهم الله وأسكنهم الفردوس الأعلى، ومنح أحبّاءهم الصبر والثبات.
ومنحنا، نحن الأحياء، الإرادة لا لوقف إطلاق النار فقط، بل لإنهاء هذه الإبادة الجماعية، وألّا نغضّ الطرف مرة أخرى.
للاطلاع على المقال الأصلي من (هنا)