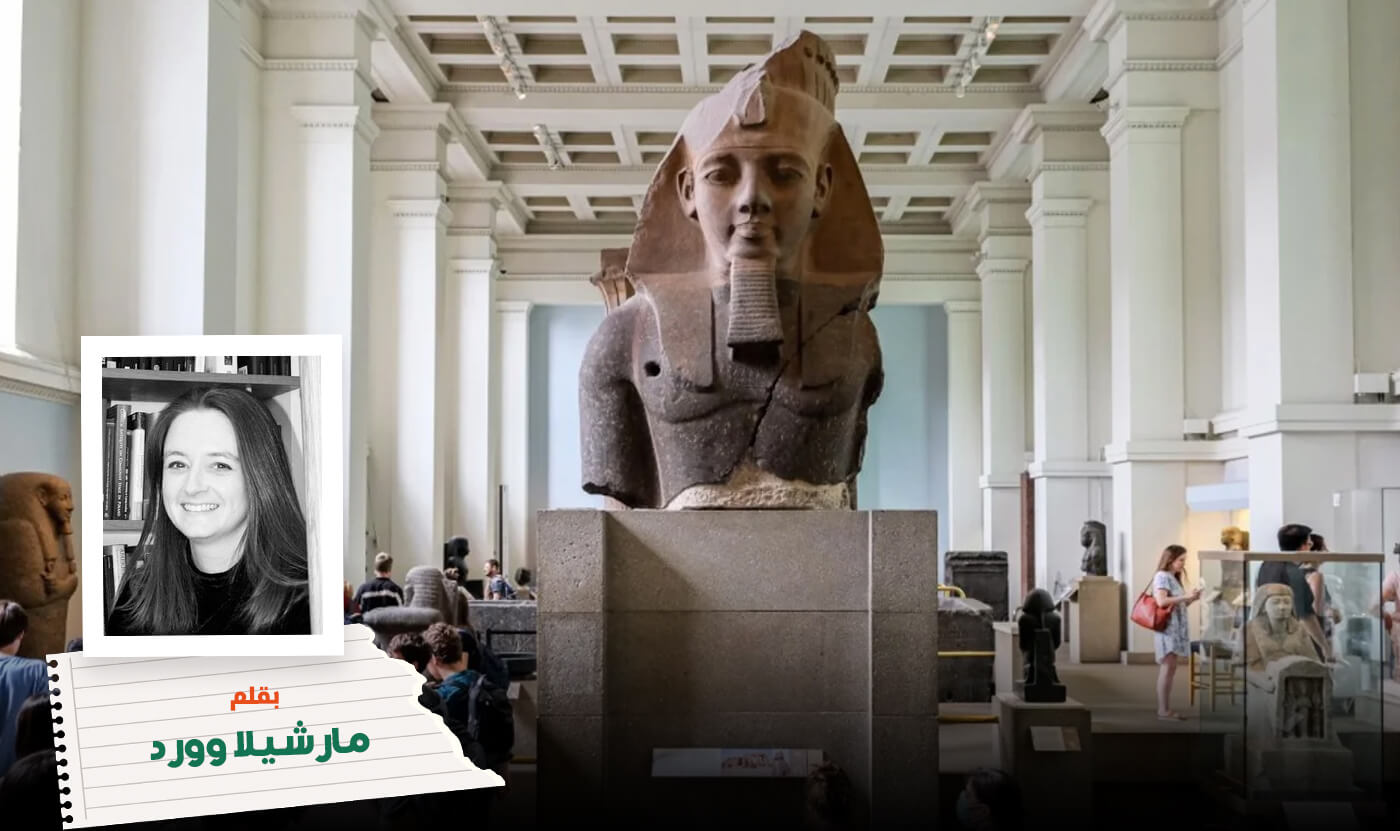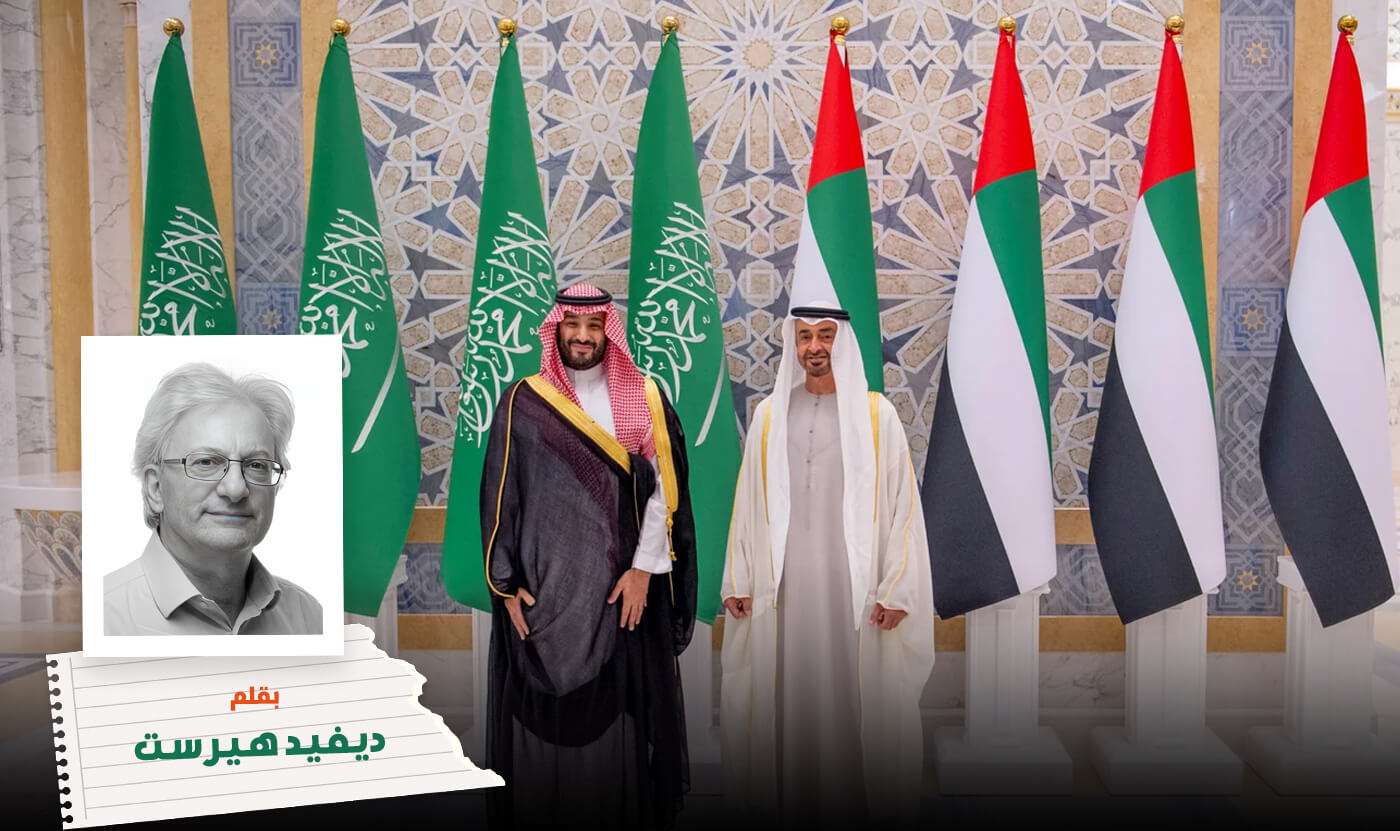بقلم هنريتا زيفرت
ترجمة وتحرير نجاح خاطر
في كتابه The Location of Culture كتب هومي بابا أن “البيت هو موقع أعقد الغزوات في التاريخ”، يمتد هذا التاريخ من الدخول القسري إلى البيت، وتدميره، وطرد ساكنيه في فلسطين لزمن أطول بكثير من الإبادة الجارية اليوم، وأبعد حتى من نكبة 1948.
لكن حجم الدمار الذي لحق بالمنازل في غزة خلال الأشهر الـ22 الماضية، وعمق المعاناة الإنسانية المصاحبة له، غير مسبوق، وهو ما دفع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن اللائق، بالاكريشنان راجابوبال، إلى وصف التدمير الواسع والممنهج للبيت بأنه “إبادة عمرانية” (domicide).
صور الأقمار الصناعية كشفت أن أكثر من 70% من بنية غزة التحتية قد سويت بالأرض، وبحلول أغسطس/آب 2025، تجاوز عدد المنازل المدمرة 282 ألف منزل, أي ما يعادل نحو 78% من إجمالي المباني في القطاع، حيث أدت هجمات الاحتلال على البيوت إلى تهجير جميع السكان تقريباً وغالبًا مرات متعددة.
قد تبدو هذه الأرقام مألوفة إلى درجة قد تُخدّر ردود أفعالنا، لكن من الضروري التوقف أمامها والتفكر فيها، فهي تكشف أيضًا أوجه القصور في القانون الدولي، بل وتواطؤه أحيانًا، وتدلّ من جهة أخرى على إمكانات كان يمكن أن يُوظف فيها بشكل أفضل.
البيت كأداة استعمارية
البيت متشابك مع أنظمة العنف، ففي سياق الاستعمار الاستيطاني، يُعدّ البيت استعارة مركزية.
وكما يوضح آرييل هاندل وهاجر كوتيف، فإن الاستعمار الاستيطاني هو “قصة بيوت تتحول في ذاتها إلى أدوات تدمير، بيوت أقيمت على أنقاض بيوت الآخرين”، إنه مشروع بناء بيت جديد وخلع بيت قديم، كما هو حال المستوطنات التي ولدت وتهدد بابتلاع غزة.
تفكيك البيت لا يعني فقط تدمير البنى المادية، بل ضرب الإحساس العميق بالبيت والروابط المكانية، وقطع الصلة بالمكان الذي يُسمى “بيتًا” فعل مدمّر بعمق، وله تداعيات لا حصر لها.
وقد أكدت شهادات من غزة الخسائر النفسية واللامادية المرتبطة بتدمير البيت، فقال أحدهم: “فقدان البيت يعني فقدان الاستقرار النفسي”، وقال آخر: “لم يعد هناك أفق للأمل بعد أن فقدنا بيتنا”.
الخرائط كسلاح
المكانة المركزية للبيت في منطق الاحتلال والفصل العنصري والإبادة الجماعية، ودوره المعقد بوصفه موقعًا للعنف والسيطرة، وفي الوقت نفسه مجالًا للمقاومة والفاعلية، مفاهيم أساسية لفهم التدمير الشامل للبيوت في غزة.
في الأشهر الأولى، حين كانت بعض البيوت لا تزال قائمة، استخدم جيش الاحتلال خرائط قسّمت غزة إلى أحياء مرقمة لتحديد أي المنازل ستُستهدف وأيها يجب أن يُخليها سكانها.
بهذا التوظيف للخرائط تحولت غزة إلى فضاء “لا منزلي”، مكان غريب من اللاانتماء والخوف والاغتراب، بعيد كل البعد عن صورة البيت المأمون الدافئ.
ومع تصاعد الغارات، شارعًا بعد شارع، وبيتًا بعد بيت، بدا واضحًا أن البيت لم يعد مساحة محايدة، بل ميدانًا تتجلى فيه صراعات الهوية ذاتها.
حين يُحرم الناس من السيطرة على بيوتهم أو حتى من شروط السكن نفسها، تتغير جذريًا معاني “البيت” و”الوجود في البيت” في العالم.
وألم “الإبادة العمرانية” لا يقع فقط على من دُمرت بيوتهم، بل أيضًا على من لا يستطيعون العودة، أو من فُقدت كل مقومات إعادة بناء البيت لهم.
غزة كـ”بيت بلا مكان”
تحولت غزة إلى ما تسميه نادرة شلهوب كيفوركيان “بيتًا بلا مكان”، ومع ذلك، تظل غزة وفلسطين هي البيت، ويجسد مفهوم “الصمود” تلك الجذور الراسخة في الأرض، “الوقوف العنيد”، والرفض المستميت لمغادرة البيت والوطن، والمقاومة عبر أفعال يومية مثل إعادة بناء البيت، ممارسة الضيافة، والحلم بالبيت.
ورغم التدمير الشامل، يجب أن يكون جزء من مقاومتنا إبراز جمال غزة وإبداعها وفنونها وثقافتها، والتصميم الغني لأهلها.
ما معنى البيت؟
البيت ليس مجرد مكان للعيش، إنه مفهوم معقد متعدد الأبعاد، يجمع بين المشاعر والتجارب، وهو في الوقت نفسه مساحة مادية وعاطفية وخيالية.
وفي معناه الأوسع، فإن البيت هو إحساس بالوجود والانتماء في العالم، وكما تقول شلهوب كيفوركيان، إنه “فضاء نفسي ومعرفي من الحنين، ومن التفكير الراديكالي والانتماء”.
عملية “بناء البيت” أو “التحوّل إلى بيت” هي فعل “تشكل”، أي نحت الهوية الاجتماعية-المكانية الخاصة بنا، ولهذا السبب تحديدًا كان البيت الفلسطيني دائمًا هدفًا للتدمير.
وبالنسبة للفلسطينيين، فالبيت مكان وفكرة وقوة منظِّمة في آن واحد، إنه الوطن والذاكرة والهوية.
وكما كتبت شلهوب كيفوركيان وسارة إهمود، فإن البيت الفلسطيني “مشبع بالمعاني الفردية والجمعية، الثقافية والسياسية”، إنه المكان الذي تنتقل فيه الذاكرة والتاريخ، للحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية، وصون فكرة الوطن الفلسطيني.
ورغم المستوى غير المسبوق لتدمير البيوت في غزة، فإن القانون الدولي لم يتمكن من وقف ذلك، فالقانون لا يتضمن نصوصًا مباشرة لحماية “البيت” بحد ذاته.
ويمكن استنتاج حماية ما من خلال بعض الحقوق، مثل الحق في السكن والملكية والخصوصية.
وفي مواضع أخرى، يظهر مفهوم “الوطن” في اعتراف القانون الدولي بالشعوب الأصلية وعلاقتها الروحية بالأرض، كما تحظر قوانين الحرب استهداف “الممتلكات المدنية” و”الأعيان المدنية”، وهو ما يمكن أن يشمل البيوت.
لكن البيت أبعد من أن يكون مجرد تجربة مشتقة من نصوص قانونية، إنه الحياة نفسها، مكان متجسد وملموس، متعدد المعاني؛ فمعظم الناس يرون بيوتهم في أكثر من مكان واحد، ويحملونها معهم عبر الزمان والمكان.
أي أن البيت حاضر في الماضي كحنين، وفي المستقبل كيوتوبيا، وكما كتبت سارة أحمد، البيت هو السرديات، والاستعمار، والتمييز العرقي، والعلاقات الطبقية، وسياسات الجندر.
ولهذا ظل البيت، بوصفه عنصرًا أساسيًا في الممارسة التحررية، غائبًا عن القانون الدولي الحديث، الذي يقوم على تصورات أبوية للنضال من أجل العدالة وتقرير المصير والدولة، والمتجذرة في نظام استعماري.
ولا يعني هذا أن القانون الدولي غائب تمامًا عن مجال البيت، فهو حاضر فعلًا، يرسم ويحدد شروط البيت وحدوده بطرق متعددة، بعبارة أخرى، القانون الدولي نفسه يقوم بعمل “بناء البيت” و”هدمه”.
على سبيل المثال، قوانين الحرب هي التي تضع وتدعم البنية القانونية للاحتلال، ورغم أن محكمة العدل الدولية أدانت هذا الاحتلال، فإن هذا الإطار القانوني الدولي يفتح الباب في جوهره لدخول البيوت الفلسطينية والسيطرة عليها.
هناك أيضًا تشابكات رمزية وفلسفية بين مفهوم البيت والقانون الدولي، تظهر في فلسطين، فالدولة-الأمة كثيرًا ما يُشبَّه وجودها بالبيت.
المطالب بالسيادة، وتقرير المصير، والسيطرة على الأرض تُصاغ كثيرًا بلغة البيت والوطن، والبيت في المخيلة القانونية هو الفضاء السيادي الأقصى، مكان الانتماء الحصري والنظام الكوني.
وهكذا، فإن الإنكار المتكرر لحق الفلسطينيين في الدولة وتقرير المصير، ورفض الاعتراف بوجود وطن فلسطيني، يتحقق من خلال المسارات القانونية الدولية، ويُمنح شكلًا رسميًا بينما يؤدي عمله في صناعة البيت أو هدمه.
على نحو أكثر مباشرة، استدعت دولة الاحتلال القانون الدولي خلال الأشهر الـ22 الماضية لتسهيل عملية هدم البيت في غزة، بالاستناد إلى قوانين الحرب لتبرير إعادة تصنيف بيوت غزة من أماكن محمية إلى أهداف عسكرية.
هذا جعل القانون الدولي شريكًا في تدمير البيوت، وجزءًا من سردية تصور الفلسطينيين شعبًا بلا بيت، بلا جذور في “أرض ذات معنى” وهي السردية اللاإنسانية التي أعادت دولة الاحتلال إنتاجها لعقود.
مقدمة للإبادة
وفي ظل غياب حماية صريحة للبيت أو حظر تدميره في القانون الدولي، ومع تواطؤ القانون أحيانًا في عملية الهدم، برزت دعوات مؤخرًا لتجريم “الإبادة العمرانية” وجعلها جريمة دولية مستقلة.
قد يجادل البعض بأن ذلك غير ضروري، إذ إن تدمير البيوت يمكن أن يُصنف ضمن جرائم الحرب، وقد يُشبَّه أيضًا بجريمة ضد الإنسانية حين يؤدي، كما يحدث غالبًا، إلى الترحيل القسري أو الفصل العنصري أو أعمال لا إنسانية أخرى.
تدمير البيت قد يمهّد أيضًا للإبادة الجماعية، ففي قرار محكمة العدل الدولية في يناير/كانون الثاني 2024، الذي أقر بحق الفلسطينيين في الحماية من الإبادة، ورد ذكر “البيت” ثماني مرات في وثيقة لا تتجاوز 29 صفحة، في إشارة واضحة إلى الصلة بين تدمير البيت والإبادة.
هذه الصلة ليست بلا سوابق تاريخية، ففي ميانمار ورواندا والبوسنة والهرسك، ارتبطت الإبادة الجماعية ارتباطًا وثيقًا بالإبادة العمرانية.
وهذه المقارنات القانونية والتاريخية تفتح الباب لنقاش جوهري حول مفهوم البيت، ولماذا نفكر فيه عبر غيابه أو محوه، وهنا يكتسب مفهوم “الإبادة العمرانية” قيمته، لأنه يلفت النظر إلى الطابع السياسي للبيت وتعقيدات تدميره.
يمكن تعريف “الإبادة العمرانية” بأنها “التدمير المتعمد للبيت على يد البشر لتحقيق أهداف محددة، بما يسبب معاناة للضحايا”، وكما أن البيت متعدد الأبعاد والزمنيات، فإن الإبادة العمرانية تتكرر كذلك مرارًا عبر أماكن مختلفة، بوسائل ونيات متنوعة.
تتجسد هذه العمليات في حرمان الناس من بيوتهم عبر تدميرها أو منعهم من العودة إليها، وحرمانهم من حقوق الإقامة والعودة، وتقييد وصولهم إلى الموارد الطبيعية، وفرض قيود تمييزية في التخطيط العمراني، وتنفيذ برامج “تمدين” منحرفة.
اهتزاز دائم
الإبادة العمرانية تُبقي المجتمع في “حالة اضطراب دائم”، تمنعه من الاستقرار أو بناء بيت جديد، وتجعله يعيش في “لا يقين مستمر” بلا إحساس بالاستمرارية.
هذا التعريف ينقل الإبادة العمرانية من كونها حدثًا منفردًا إلى عملية متكررة، غير خطية ولا نهائية، تتكرر باستمرار، والتكرار بحد ذاته يكشف الطابع الممنهج والقصدي لهذا الفعل، والمنطق القائم على المحو العنيف الذي يحركه.
أي مقاربة قانونية لمفهوم “الإبادة العمرانية” لا بد أن تفسح مجالًا للأبعاد العاطفية والنفسية المرتبطة بتدمير البيت: فقدان الذاكرة الجمعية والروابط بالمكان والناس، ضياع الأمان الوجودي والشعور بالانتماء، والصدمة النفسية الملازمة لفقدان البيت والعيش في غموض بناء بيت آخر.
إن ما تفعله دولة الاحتلال في غزة هو سياسة “إبادة عمرانية” متكررة، سياسة قائمة على محو المكان والذاكرة معًا، بحيث يُحرم الفلسطيني من إمكانية العودة، ويُجرد من البيت كوطن وهوية.
ففي المخيمات التي كانت أصلًا مؤقتة للاجئين عام 1948، أُعيد إنتاج الفقد مرارًا، البيوت تهدم مرة بعد أخرى، والعائلات تهجَّر من جديد.
هنا لا يعود البيت مجرد جدران مهدمة، بل يصبح رمزًا لفقدان الماضي والمستقبل معًا، أي لفقدان القدرة على الاستقرار وبناء حياة ممتدة.
الإبادة العمرانية بهذا المعنى لا تُفهم فقط كتدمير فيزيائي للمنازل، بل كمحو منهجي للعلاقة بين الفلسطيني وأرضه، بحيث يُختزل وجوده في حالة ترحال دائم.
وكما يشير باحثون في هذا المجال، فإن التكرار المتواصل للهدم والترحيل يمنع المجتمع من إعادة بناء ذاته، ويُبقيه في حالة اهتزاز هوية دائم.
ولذلك، فإن ما يحدث في غزة اليوم ليس مجرد “حرب” أو “هجمات” كما يصفها الخطاب الغربي السائد، بل هو إنتاج ممنهج لغياب البيت، سياسة تُعيد تعريف الفلسطيني بوصفه “بلا بيت”، وبالتالي بلا وطن، بلا استقرار، وبلا أفق للعودة.
هذا النهج يتقاطع مع منظومة استعمارية عالمية أوسع، إذ يشكّل البيت موقعًا رئيسيًا لممارسات السيطرة، سواء عبر المصادرة أو التخطيط العمراني العنصري أو سياسات الطرد القسري.
لكن في الحالة الفلسطينية، يتجسد ذلك بأقصى درجاته: بيت يُهدم فوق ساكنيه، وبيت يُقصف في لحظة نوم، وبيت يُمحى من السجلات ومن الذاكرة معًا.
ومع أن القانون الدولي بدأ مؤخرًا يأخذ إشارات محدودة من مصطلح “الإبادة العمرانية”، فإن غياب تعريف صريح لها يترك الباب مفتوحًا أمام مزيد من الإفلات من العقاب.
ذلك أن الصلة بين “الإبادة العمرانية” والإبادة الجماعية ليست ثانوية، بل أساسية؛ فالتدمير المتكرر للبيت هو أداة رئيسية لتفكيك المجتمع وصولًا إلى محوه.
إن الاعتراف القانوني والسياسي بالإبادة العمرانية ليس مجرد شأن قانوني، بل هو ضرورة وجودية للفلسطينيين، لأن بقاءهم ذاته مرتبط بقدرتهم على إعادة بناء البيت، لا كجدران فقط، بل كحيز للذاكرة والانتماء والمستقبل.
وبينما تتواصل الجرائم على الأرض في غزة، يصبح لزامًا على العالم أن يرى الهدم المتكرر للبيوت ليس “أضرارًا جانبية”، بل سياسة مقصودة تهدف إلى إنتاج شعب بلا بيت، بلا وطن، وبلا ذاكرة، وهذا هو جوهر الإبادة العمرانية.
للاطلاع على المقال الأصلي من (هنا)