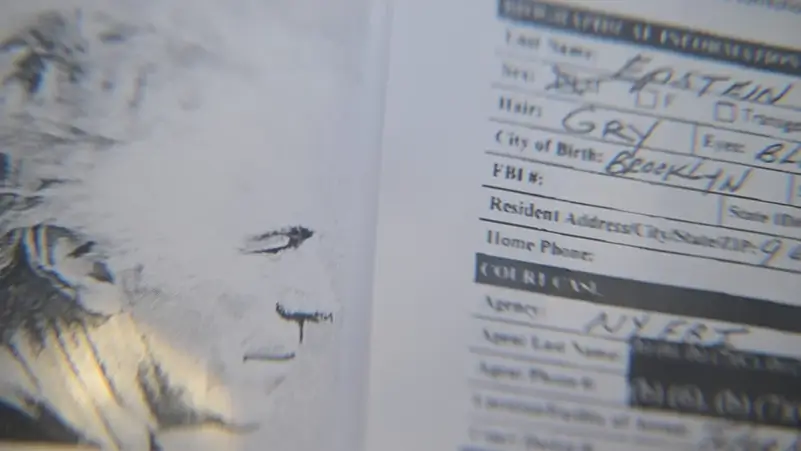بقلم أندريه بوبو فيكي
في طور إعداد تقرير لموقع ميدل إيست آي، زار الصحفي أندريه بوبوفيكي مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، ليبحث عن سر ارتباط الفلسطينيين بتقاليدهم الثقافية وتحديداً التطريز، ولماذا يعتبرونه شكلاً من أشكال المقاومة، إليكم القصة على لسان أندريه:
في مدينة بيت لحم، تجلس ملك التكروري وبيدها إبرة تمررها في قطعة قماش، تسحبها من طرف حتى تكون شكل x، كررت ذلك مراراً وهي تكدس x فوق x، تتبع بدقة ما علمته إياها معلمتها مارجوت زيدان، ما تفعله ملك يسمى التطريز، وهو نمط تقليدي من الزخرفة على الأقمشة موطنه فلسطين ومنطقة الشام.
تقول مارغوت التي تقوم بالتطريز منذ 30 سنة، “التطريز يمثل هويتنا الفلسطينية المتفردة، من غير الممكن استبدالها أو نسخها يوماً، من غير المقبول أن يتوقف الفلسطينيون ويختفي يوماً”، حيث يؤمن الفلسطينيون بمقاومة الاحتلال الإسرائيلي من خلال الطعام والموسيقى والتطريز والشعر، بالنسبة للفلسطيني يعد التمسك بهذه التقاليد علامة على مقاومة لا تختلف عن مقاومة قمع الاحتلال.
خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987 والثانية عام 2000، حظرت سلطات الاحتلال الرموز والأعلام الفلسطينية، وأصبح التطريز وسيلة شائعة بين النساء للتعبير عن مقاومتهن من خلال الرموز التي قاموا بتطريزها على الملابس، وأضيف لذلك قيمة جديدة، فصار التطريز وسيلة لكسب المال لدى النساء من خلال لجان وجمعيات ترعى تطريز الفساتين وغيرها من قطع الملابس.
بسبب شعورها بالحنين لفلسطين، بدأت ملك في تعلم حرفة التطريز أثناء إقامتها في الإمارات، فقد كانت لديها ساعات فراغ طويلة كما أنها بعيدة عن أهلها ولا أصدقاء لها إلا من أخت واحدة أكبر منها فعرفتها أختها على ورشة تطريز في أبو ظبي، وبذلك وجدت طريقة للاتصال والارتباط بالوطن مرة أخرى.
الثقافة والاحتلال
جلست أشاهد ملك ومارغو وهما يطرزان، وضعت سماعاتي، ووجهت ميكروفوني إليهما لألتقط الحديث الذي كان يدور بينهما، فقد ذهبت إلى فلسطين بهدف مساعدة ملك و3 شباب آخرين على إنتاج مقال صوتي لكل منهم، ليتحدث فيه عن تقاليد يتمسك بها لأنها تساعده في الحفاظ على هويته، يمكن اعتبارها إقامة بأهداف فنية وبعقل منفتح على استكشاف معنى العيش في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ولدت سلسلتنا الصوتية التي أسميتها “من خلف الجدار”، وبدل أن يكون ذلك مفرحاً فقد كان محبطاً لي، لأن الحديث عن فلسطين لا يأتي إلا مقترناً بالاحتلال دائماً، يصعب الحديث عن ثقافتها أو شعبها أو عنها كوطن بعيداً عن الاحتلال، ففي السلسلة، أردت التركيز على الأشياء الجيدة التي تجعل الفلسطينيين يشعرون بعمق تأثير ثقافتهم في جعلهم فلسطينيين متفردين، الطعام والموسيقى والحرف التقليدية، أي شيء آخر بعيداً عن الاحتلال، لكني سرعان ما اكتشفت أن توجهي كان خاطئاً من حيث المبدأ.
“حتى الطعام شأن سياسي هنا”
عندما قابلت الشباب الأربعة منتجي الصوت، لاحظت أن جميع القصص التي قدموها لي كمقترحات كانت بالفعل عن عادات وتقاليد يتمسكون بها، غير أنها على علاقة بالاحتلال بشكل أو بآخر، اتضح لي أنهم أرادوا جميعاً التحدث عن ذلك، وكأنهم لا يستطيعون فصل قصصهم عن حقيقة الوجود الإسرائيلي في أرضهم.
على سبيل المثال، أراد عبود السعيد، طالب الثانوية الشغوف بالموسيقى والمطبخ الفلسطيني، التحدث عن علاقته بالمطبخ التقليدي الفلسطيني وكيف أنه قربه من وطنه، ولكنه خلال حديثه ظل يركز على أن الحفاظ على تقاليد الطهي شكل من أشكال المقاومة وسط محاولات الإسرائيليين سرقة الأطباق التقليدية مثل الفلافل والحمص وإبعادها عن أي صلة بأصلها الفلسطيني، يقول في حلقته الصوتية “النشأة والمعيشة في الضفة الغربية أمر معقد، حتى الطعام شأن سياسي هنا”!
أراد عبود الحديث عن المسخن، الطبق التقليدي المصنوع من الخبز والدجاج وزيت الزيتون، فبعد الطهي مع والدته، تحول في سرد قصته نحو الصراع المصاحب للطعام والهوية في فلسطين، من خلال أحد مكونات المسخن، زيت الزيتون، فتطرق إلى عنف المستوطنين المصاحب لموسم قطف الزيتون من كل عام.
يعرف عبود معنى أن تشتبك مع المستوطنين في موسم الزيتون، فهو أمر اختبره مراراً، لأنه يعيش بالقرب من مستوطنة غير شرعية، وقد اشتبك مع الجنود الذين يحرسونها قبل ذلك، حيث يتم منع الفلسطينيين الذين يمتلكون مزارع زيتون من الوصول إليها إلا في مرات قليلة جداً خلال العام، الأمر الذي يؤثر على المحصول وقت الحصاد، كما أن المستوطنين غالباً ما يشعلون النار في البساتين أو يحاولون ادعاء ملكية الأرض، مما يؤدي إلى تحويل غصن الزيتون رمز السلام إلى رمز الاضطهاد في موسم الحصاد.
موضوع الاحتلال كان أيضاً مألوفاً في توجه موسى نزال، الممثل والمخرج الشاب من رام الله، حين اختار الحديث عن قصيدة للشاعر الفلسطيني محمود درويش “لاعب النرد”، مشيراً إلى أنه يشعر وكأن درويش قد كتبها له، فبعد أن سلك موسى منعطفاً خاطئاً مرة، وجد نفسه عند نقطة تفتيش لكن لم يكن معه الأوراق المطلوبة للمرور منها، كان موسى يعلم أن ذلك كفيل بالمواجهة مع الجنود في أية لحظة، وهنا خطرت له القصيدة:
أَنا لاعب النَرْدِ ،
أَربح حيناً وأَخسر حيناً
أَنا مثلكمْ
أَو أَقلُّ قليلاً …
قياساً للعشوائية التي أوصلت موسى إلى نقطة التفتيش تلك، يشعر موسى بأن قدره أن يكون فلسطينياً بذات العشوائية، قدره لكنه لا يستطيع تحديد سبب واضح لذلك، فقام موسى بالمقارنة بين حياته تحت الاحتلال والقصيدة في مشروعه الصوتي، بالنسبة لموسى، يقول “شعرت أن لاعب النرد هو من يقرر حياتي”.
أغاني الشوق والحنين
أما روان نصر الله، فوالداها ينحدران من جنين ولكنها تربت في دبي، ولم يكن هناك الكثير من المعاني التي تساعدها على فهم أن تكون فلسطينية، تقول “كنت في الخامسة عشرة من عمري، كنت أعيش في دبي، لكنني فلسطينية، لم أكن أعرف كيف ولماذا؟”.
كانت روان تسمع والدتها وهي تغني أغاني الانتفاضة الثانية عندما كانت طفلة صغيرة، الأمر الذي استثار روان لتبحث عن صلة مع وطنها، فهي لم تكن تفهم المعاني وراء ما كانت تردده أمها، أو لماذا غنت والدتها عن الاطفال المحاصرين تحت الأنقاض والشهداء، لم تفهم ولكنها شعرت بحنين ما، تقول روان “الأغاني التي غنتها أمي جعلتني أشعر بالحزن والارتباك، لكنها جعلتني أشعر بشيء لم أكن أعرف أني قد أشعر به من قبل، الحنين إلى مكان لم أكن أعرفه، الحنين إلى فلسطين”.
وعندما عادت روان إلى فلسطين، وسط واقع الحياة مع الاحتلال، أصبح لتلك الأغاني معاني واضحة وجديدة المعالم بالنسبة لها، فقد استطاعت مطابقة الكلمات مع ما تراه من قمع الاحتلال.
تؤكد تجارب المنتجين الأربعة الذين عملت معهم أنه لا يمكن فصل موضوع الثقافة عن الاحتلال في فلسطين، فالاحتلال وما ينجم عنه من ألم وحزن حقائق يومية ومستمرة في حياة الفلسطينيين، لا يمكن الادعاء بأن هناك ثقافة لا يطالها الاحتلال، ولكن المفارقة أن وجود الاحتلال يشكل الحافز الأقوى والأكثر زخماً في حملة الحفاظ على الثقافة الفلسطينية، كما في قصص الشبان الأربعة الذين قابلتهم، ملك وعبود وموسى وروان.