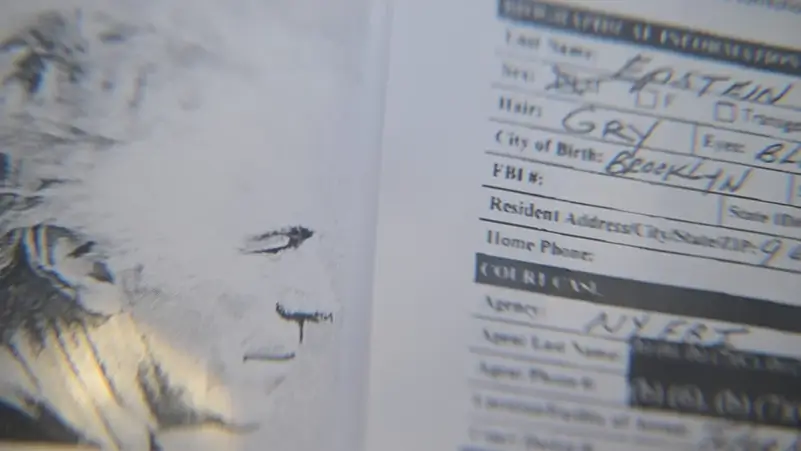بقلم علا مرشود
ترجمة وتحرير: بالعربية
انتقلت للعيش في جنين في مايو 2020، لم يكن لدي فكرة حينئذ كيف ستكون الحياة في جنين، ظننت أني سأستمتع بصباح مشرق مع عائلتي أحتسي فيه القهوة على شرفتنا المطلة على مرج بني عامر والقرى الواقعة شمال شرقي المدينة، تخيلت ليالي هادئة، لا يخترقها إلا صوت طفلي من حين لآخر، تخيلتها بجمال الأيام التي كنت أقضيها مع والدتي في “جنتها” المطلة على تلال نابلس، أتحدث هنا عن شرفة أعتبرها جنة لأن والدتي حولت شرفتها الخرسانية إلى واحة خضراء، فالأمهات دائماً ما يعطين الحياة لكل شيء.
مع دخول الليل، يرتفع صوت إطلاق النار من حولنا ويصبح الخروج من المنزل أمراً غير آمن، كل ما يمكننا فعله هو الانتظار والدعاء بأن يأتي الصباح بسرعة
سرعان ما تلاشى ذلك الخيال، من الأسبوع الأول من زواجي عند انتقالي إلى مدينة جنين، ففي جنين يمكن سماع طلقات نارية في أي وقت من اليوم، خاصة بعد منتصف الليل قبيل الفجر، وفي ساعات الصباح الباكر، فمنزلي يقع على بعد أمتار قليلة فقط من مخيم جنين للاجئين، ولا تكاد تمر ليلة دون أن تقتحم قوات الاحتلال الإسرائيلي المخيم أو الأحياء الأخرى في هذه المدينة الصغيرة، وفي المساء نسمع نعي الشهداء من مآذن مساجد الحي الذي أستطيع رؤيته من نافذة منزلي.
وبعد 3 أشهر فقط من استقراري في جنين، وفي أحد أيام الصيف في آب، استيقظنا فجراً على أصوات اشتباكات بين عناصر المقاومة وقوات الاحتلال الذين اقتحموا حينا، وسرعان ما سمعت صفارات سيارات الإسعاف، مع ورود أنباء عن إصابة امرأة وهي داخل منزلها استيقظت مع الفجر لإرضاع طفلها، اقتربت من النافذة لإغلاقها حتى تحمي صغيرها من الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي، فأصابتها رصاصة اخترقت الكبد والبنكرياس والشريان الأورطي وتوفيت السيدة الفلسطينية “داليا الصمودي” (23 عاماً) متأثرة بجراحها، شهدت القصة لأن منزلها كان يبعد عن منزلي بضعة مبانٍ فقط!
سيظل اسم “داليا” محفوراً في ذاكرتي إلى الأبد، تتكرر هذه المشاهد في جنين، فقد قتل الاحتلال ماجدة عبيد، جدة من المخيم جنين، أيضاً برصاصة أصابتها وهي داخل منزلها في وقت سابق من نفس العام وقد كانت تصلي وتدعو الله أن يحمي شباب المخيم!
خوف يتنامى
في مارس 2022، رُزقت بطفلتي الجميلة، فزاد العبء والمسؤولية، فالأمومة تزيد من شعورنا بالخوف في كل مرة نسمع فيها إطلاق نار، خاصة إذا كانت قريبة، أخشى على زوجي وابنتي في كل مرة، أحياناً أفكر في أن أكثر أماكن المنزل أماناً هو المطبخ، فلا يوجد فيه فتحات أو نوافذ لينفذ منها الرصاص، وخلال الفترات التي تشتد فيها الاشتباكات، أصر على زوجي بأن يتأخر بالخروج لعمله، لأنه بالعادة يتوجه إلى مدينة طولكرم المجاورة بعد صلاة الفجر مباشرة، وهو من أكثر الأوقات التي تحصل فيها اشتباكات.
خلال الاشتباكات الليلة، إذا بكت طفلتي لمرض أو ألم ولم نستطع تهدئتها، يصعب الخروج إلى المستشفى لما في ذلك من الخطورة، فمع دخول الليل، يرتفع صوت إطلاق النار من حولنا ويصبح الخروج من المنزل أمراً غير آمن، كل ما يمكننا فعله هو الانتظار والدعاء بأن يأتي الصباح بسرعة.
في الوقت نفسه أنا صحفية، الأمر الذي يستدعي أن أكون دائماً في قلب الحدث، حتى لو لم أكن أعمل في الميدان، فأنا أجري مقابلات هاتفية مع أمهات وزوجات الشهداء والمعتقلين ومع الوقت وكثرة تكرار الأحداث المرتبطة بالاشتباكات، نصبح أصلب و نتكيف مع الوضع الجديد، ومع ذلك، في كل مرة أحضر فيها جنازة وأرى نعشاً ملفوفاً بالعلم الفلسطيني، أو أتحدث مع عائلات الضحايا، يعتصر قلبي وتسقط دموعي رغماً عني.
خبر عن مجزرة!
كان صباح يوم 16 أغسطس عام 2021، عندما استيقظنا على مجزرة جديدة، فقد استشهد 4 شبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي استولت على جثتين، ومما زاد الأمر لدي حزناً هو أن أحد الشهداء كان يسكن بجواري، وكان والده يؤذن بالمسجد بينما والدته تعد طعام السحور خلال رمضان في ذلك العام، لم أكن أعرف الشهيد نور الدين عبد الله جرار شخصياً، لكني كنت أعرف عائلته الطيبة بشكل عام، فبعد الظهر من يوم استشهاده، ذهبت حتى أبلغهم بما حصل وأقدم لهم التعازي، تأثرت الأسرة كثيراً بالخبر خاصة بعد حرمانهم حتى من الوداع.
في أكتوبر الماضي أيضاً، استشهد الطبيب والمقاوم عبد الله أبو التين برصاص قوات الاحتلال، بعد استشهاده قابلت زوجته التي تحدثت عنه بحب غامر وحزن عميق، بعد المقابلة احتضنتها، شعرت بالعجز في تلك اللحظة فلم أجد كلمات أعزيها بها.
أستطيع القول بأن أصعب صباحاتي كان يوم استيقظت على مكالمة مديري بالعمل يقول لي “قُتلت شيرين أبو عاقلة، تابعي القصة فوراً”، أصابتني صدمة كبيرة، أخذت أمر على الأخبار سريعاً لأفهم ما حدث، فمررت بصور ومقاطع فيديو توثق الحادثة، كررتها 10 مرات أو ربما أكثر، بدأت أفقد صلابتي، فقد قُتلت شيرين على بعد أمتار فقط من منزلي، مرتدية سترة الصحفية، لم أتمكن من التغلب على صدمة وفاتها حتى الآن.
شرف وفخر
قد لا تشكل هذه الحوادث صدمة أو تحدياً نفسياً صعباً لآخرين من جيلي عاشوا الانتفاضة الثانية وما بعدها خاصة في جنين، لما تعرضت له عائلاتها من حصار لأسابيع وحظر تجول وتوغل عنيف لآليات القوات الإسرائيلية، وشهدوا على إراقة الدماء وسحب أفراد من عائلاتهم إلى المعتقلات.
أما أنا، فقد نشأت في نابلس، كل هذا كان جديداً بالنسبة لي، على الرغم من أني قد نشأت على الإيمان بقضية فلسطين من سن مبكرة، فقد كانت الأناشيد الوطنية جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، تابعنا الانتفاضة والحروب التي تلتها على غزة، وشاهدنا الأخبار أكثر من الرسوم المتحركة، أينما ذهبنا كنا صوت فلسطين، فقد شاهدت نبأ اغتيال عمي، الأخ الأصغر لوالدي، عبر قناة الجزيرة، وكانت المرة الأولى التي أرى بها والدي يبكي.
دائماً ما أسمع في شوارع جنين أنغام الأغاني الوطنية عن شهداء المدينة
خلاصة القول، أن العيش في جنين والوجود في قلب الحدث أمر مختلف تماماً، ففي طريقي من المنزل إلى الجامعة، دائماً ما أسمع في شوارع جنين أنغام الأغاني الوطنية عن شهداء المدينة، وفي بعض الأحيان تنجرف الموسيقى عبر حقول الذرة أو من نوافذ سيارة عابرة، في مرة وأنا على متن حافلة، إذ بامرأة تقول للسائق “أوصلني إلى منزل (صبراني)”، فاستدار إليها شاب وسألها “هل أنت والدة ضياء يا خالتي؟ رحمه الله، لقد كان صديقي”، لقد كان المكان الذي تسير باتجاهه الحافلة مليئاً بالرموز عن شهداء المنطقة، وهو قرب بيتي فقلت في نفسي “أمهات الشهداء جيراني، يركبون نفس حافلتي، ويمشون في نفس الشوارع التي أمشي بها ويصلون في نفس المسجد”، شعرت بالشرف والفخر في تلك اللحظة.