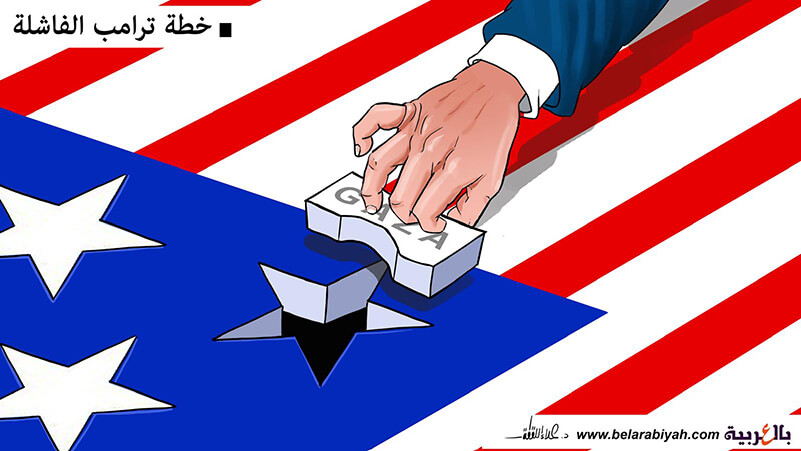بقلم حسام شاكر
ينطلق قطار الديمقراطية على سكّته في أنحاء أوروبا، فتختطف حركتُه الانسيابية الأنظار بعيداً عن حشود لم يُسمَح لها بالصعود إليه. يكشف هذا المشهد الرمزي جانباً غير ملحوظ من واقع ديمقراطيات أوروبية عريقة أو ناشئة تستبعد فئات عريضة نسبياً من جماهيرها من حقوق المشاركة في مواسم الاقتراع العامّة؛ ولو على مستوى التصويت دون الترشّح في أدنى مستويات الحياة الديمقراطية.
تكمن العلّة، أساساً، في عدم اشتمال بعض السكان ضمن نطاق يؤهِّلهم للمشاركة الانتخابية العامّة لأسباب تتعلّق بأوراقهم الثبوتية تحديداً. فهم “ليسوا مواطنين”، حسب الرواية الرسمية، أي لا يحملون جنسية بلد يُقيمون فيه منذ سنوات، علاوة على وجود فئات منهم مصنّفة بشكل مؤقّت أو مُزمِن على أنها “بلا أوراق” يواجه منتسبوها استغلالاً مُزرياً في هوامش اجتماعية.
ذرائع الحرمان
يُحاجِج المدافعون عن حرمان مَن لا يحملون جنسية الوطن الأوروبي المعنيّ من حقوق الترشّح والتصويت في الانتخابات العامّة؛ بأنّ المشاركة في صناعة سياسة البلد لا ينبغي لها أن تُتاح لغير مواطنيها لاعتبارات سيادية أساساً. وإن بدت الحجّة منطقية للوهلة الأولى؛ فإنّها تثير الشكّ في سلامتها في المستويات الجهوية والبلدية على الأقلّ؛ لأنها تختصّ في هذا المقام بتسيير الشؤون المحلية والخدمات المباشرة للسكّان عموماً؛ ولا تتعلّق بصناعة القرارات الوطنية للدولة؛ مثل انتخاب الرئيس أو البرلمان أو تشكيل الحكومة وتنصيب القائمين على وزاراتها السيادية بمقتضى نتائج الاقتراع.
ممّا يُقال في سجلّ الذرائع أيضاً إنّ من لا يحملون الجنسية قد يُغادرون البلد في أيِّ وقت وقد يحوزون حقّ المشاركة الانتخابية في بلدانهم الأصلية، بينما يشير الواقع إلى أنّ هذه الحجّة التي لا تسري على معظم هؤلاء غالباً كما لا تبدو مبرِّراً مقنعاً لحرمان أوساط عريضة من حقّ المشاركة في المستوى المحلي على الأقلّ.
ديمقراطية محدودة النطاق
جوهر المعضلة أنّ بعض السكان يُستبعَدون من حقوق المشاركة في جولات انتخابية تؤثِّر في حياتهم اليومية بصفة مؤكّدة؛ رغم أنّهم يُقيمون بصفة قانونية وتسري عليهم معظم الواجبات كغيرهم ويدفعون الضرائب أيضاً. يتسبّب ذلك في ما هو أسوأ من مجرّد أن يصير هؤلاء في درجة ثانية أو ثالثة من الحياة الديمقراطية، لأنهم في الواقع مستبعدون تماماً منها؛ أي أنّها ديمقراطية محدودة النطاق وليست ديمقراطية طبقية كما قد يُحسَب. ذلك أنّ الحرمان من هذه المشاركة يتجلّى في مستوييْن اثنيْن معاً؛ مستوى الترشّح للمنافسة الانتخابية، ومستوى التصويت في جولات الاقتراع، وهذا بسبب عدم حيازة جنسية البلد ببساطة.
يتسبّب الاستبعاد الصارم من حقوق الانتخاب في إبقاء أوساط واسعة نسبياً من السكّان بعيداً عن صناديق الاقتراع؛ حتى في انتخاب ممثّلي أقاليمهم الجهوية وبلديّاتهم المحلية ومجالس أحيائهم السكنية، علاوة على عزلهم الدائم عن مواسم الانتخابات البرلمانية والرئاسية وانتخابات البرلمان الأوروبي والاستفتاءات الشعبية بطبيعة الحال.
تتفاقم المعضلة عندما تتشدّد بعض الدول والحكومات في سياسات منح الجنسية وتضع العقبات والعراقيل في سبيلها، كما يتَضح من تفاوُت شروط التجنيس ومؤشِّراته بشكل ظاهر بين دولة أوروبية وأخرى، ومن الاتجاه نحو تشديد قوانين الجنسية بسبب تصاعد الهيمنة اليمينية واليمينية المتطرِّفة على الحياة السياسية وتغيُّر المزاج الجماهيري ضمن أوساط “مجتمع الأغلبية”.
لدى التدقيق في شروط تفرضها أنظمة متعدِّدة عبر ديمقراطيات أوروبا لأجل منح الجنسية؛ يتّضح أنّ المواطنة ما كانت لتُمنَح أساساً لبعض السياسيِّين وصانعي القرار وشاغلي مواقع حكومية وبرلمانية لو أنّ الشروط التي يتمسّكون بها طُبِّقت عليهم بأثر رجعي. غنيّ عن البيان أنّ بعض رؤساء الدول والحكومات الأوروبية قاموا بتجاوزات وارتكبوا مخالفات وتورّطوا في فضائح كان من شأنها حرمانهم من امتياز المواطنة إيّاها لو لم يكونوا من فئة “المواطنين” ابتداءً. يسري هذا مثلاً على رؤساء دول وحكومات في فرنسا وبريطانيا وإيطاليا والنمسا وغيرها؛ أدانتهم محاكم بلادهم بسبب مخالفات جسيمة أو لاحقتهم فضائح شديدة الوطأة خلال السنوات والعقود الأخيرة.
من المفارقات أنّ بعض “قادة الديمقراطية” هؤلاء اشتُهروا بمواقف صارمة ضد المنحدرين من خلفية هجرة، وأسرف بعضهم في تقديم دروس قيمية وأخلاقية وصياغة اشتراطات مدرسية الطابع على العالقين في غرفة الانتظار بانتظار حيازة الجنسية. ومن تناقضات الخطاب أن يستعمل هؤلاء مقولة “الاندماج”، ذات الطابع الدلالي الفضفاض وبمغزاها المضلِّل أحياناً، ذريعة للتشدّد في منح الجنسية، رغم أنّ الاستبعاد من المواطنة لا يُعين على الاندماج في الحياة الديمقراطية والمشاركة في الشواغل العامّة وتوليد الإحساس بالانتماء إلى الشعب والوطن أساساً.
قضية مثالية للتسخين الشعبوي
ممّا يزيد الوطأة أنّ هذا الملف عرضة لاستقطابات التسخين الجماهيري في البيئات الديمقراطية عينها. فليس نادراً أن ينزلق ملفّ منح الجنسية إلى استعماله موضوعاً للتراشُق الانتخابي والتصعيد الشعبوي، لأنه يبدو ملائماً لمحاولة حشد الأغلبية في مواجهة الأقلية وتحرِّي كسب أصوات انتخابية عبر هذه الحيلة المعهودة؛ وإنْ تضخّمت كتلة غير المُجنّسين وتزايد ثقلها في الإحصاءات لأنّها لن تجد فرصة تعبير عنها في صناديق الديمقراطية.
ولأنّ كتلة غير المُجنّسين تتعاظم حقّاً في حجمها في بعض البيئات الأوروبية؛ فإنّ الخشية من وزنها الانتخابي يدفع أحزاب الانغلاق الإثني والتحجّر الثقافي المتذرّعة بالهُويّة والتقاليد و”قيَم الوطن”؛ إلى الترافع ضدّ ما تسمِّيه “التساهل في منح الجنسية”. اعتبر رئيس وزراء نمساوي أسبق، مثلاً، أنّ منح الجنسية للذين يطلبونها بعد سنوات مديدة من الإقامة النظامية إنّما “يُقلِّل من قيمتها”، وأنّ “قيمتها الغالية” أعلى من أن تُمنَح على أساس الولادة أو بمقتضى التقادُم في الإقامة القانونية في البلد، كما صرّح في يونيو/ حزيران 2021. كان صاحب هذه المرافعة التبريرية للإبقاء على الشروط المُشدّدة التي تعرقل منح الجنسية لأعداد غفيرة من طالبيها هو سباستيان كورتس، وجه النمسا الشابّ الذي لطّخ سمعة النظام السياسي في بلاده بالتجاوزات عندما أحكم قبضته على الحياة السياسية والإعلامية على مدار سنوات. بلغ نفوذ دائرة كورتس المُقرّبة حدّ التورّط في شراء ذمم وسائل إعلام بالإعلانات الحكومية والتلاعُب بنتائج استطلاعات رأي من خلال تواطؤات جسيمة، علاوة على اشتهار فريقه بسياسات وإجراءات مُتحامِلة على مسلمي جمهورية الألب؛ إلى درجة دفعت المحاكم العليا النمساوية إلى إبطال تشريعات وقرارات عدّة صدرت في عهده؛ لأنها انطوت على تمييز أو خالفت مبادئ الدستور. في النهاية هوى كورتس ذاته في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 على وقع تجاوزات وانتهاكات وفضائح لم تشهد النمسا مثيلاً لها من قبل؛ إلى درجة اضطرّت سلطات تنفيذ القانون إلى مداهمة مقرّ المستشارية (رئاسة الحكومة) ومقرّ الحزب المحافظ الذي يقوده (حزب الشعب) وتفتيش مؤسسات إعلام واستطلاعات رأي تواطأت معه، لكنّ سياسات التجنيس المتشدِّدة بقيت على تشدّدها من بعده. يجوز السؤال بالتالي؛ إن كان سباستيان كورتس وأشباهه عبر أوروبا سيتأهّلون حقّاً لامتياز منح الجنسية حسب شروطهم؛ لو أنّهم لم يُولَدوا بها؟
تشديد سياسات التجنيس
يتّضح من خلال المقارنة أنّ الدول والأقاليم الأوروبية التي تسمح أنظمتها بمشاركة “غير المواطنين” في انتخابات المجالس المحلية والجهوية، شهدت تنوُّعاً إثنياً واضحاً في مشهدها السياسي بشكل يتقدّم بمراحل عن دول أوروبية أخرى تتعثّر تطبيقاتها في هذا الحقل بسبب ربط المشاركة الانتخابية المحلية بحيازة الجنسية.
في المقابل؛ تتفاقم المعضلة في الديمقراطيات “محدودة النطاق” عند التشدّد في قوانين منح الجنسية بصفة عامّة تمسّ “الأجانب” جميعاً أو بحجج انتقائية تتنزّل على فئات منهم بصفة متحيِّزة. تلاحقت في هذا الصدد تعديلات على قوانين منح الجنسية في بعض دول أوروبا فمضت غالباً في اتِّجاهات الصرامة والتعقيد. صيغت بعض الفقرات القانونية على نحو محبوك بشكل يمنح المسؤولين والإدارات فرصاً للتقييد والتشدُّد في بعض الحالات؛ أو لتبرير الحرمان من الجنسية في حالات انتقائية معيّنة.
قد تتعلّق الحالات الانتقائية إيّاها بشبهات ثقافية أو تتذرّع بمزاعم يستلّها قابعون في “مؤسسات الظلّ”، الذين لديهم كلمة فصل في هذا الملفّ غالباً. إنها أجهزة الأمن و”حماية الدستور” والمخابرات الداخلية، التي يسود انطباع بأنّها تضع بعض المكوِّنات السكانية في بؤرة الملاحظة أكثر من غيرها. ثمّة شكوك في بعض البيئات بشأن مدى انفتاح هذه الأجهزة الثقافي أو ترحيبها بمظاهر التنوّع في المجتمع، علاوة على غلبة منطقها الأمني في التعامل مع المسلمين تحديداً ومنتسبي أقليّات وإثنيات معيّنة أحياناً. لهذا المنحى أثره بالطبع على المسلمين وأتباع فئات أخرى في زمن يُوضَعون فيه في بؤرة المتابعة والتعقّب والتحامُل ضمن بلدان أوروبية متعدِّدة.
تنتهج حكومات أوروبية معيّنة مسلكاً مغايراً في سدّ الأبواب والنوافذ في وجه مواطنة المسلمين تحديداً، من خلال تبنِّي سياسة شديدة الصرامة ترفض استيعاب أي لاجئين أو مهاجرين منهم. هذا ما صرّحت به علناً قيادات دول معيّنة في وسط أوروبا وشرقها، هي المجر وبولندا وتشيكيا وسلوفاكيا، في محطات زمنية متعددة بدءاً من سنة 2015. تدفع هذه الحكومات معضلة القصور الديمقراطي باتِّجاه آخر؛ هو توسيع نطاق الاستبعاد من المواطنة ليشمل المقدِّمات؛ عبر التشدُّد في فرص المكوث والإقامة ذاتها قبل أي حديث عن منح الجنسية للمقيمين بشكل قانوني من بعد. امتدّ هذا التقليد إلى سنة 2023 عندما عبّرت القيادة البولندية، في يونيو/ حزيران من هذه السنة عن مناهضة مبدئية لاستيعاب مسلمين أو عرب في بلادها ضمن سياسة اللجوء المتشدِّدة الجديدة التي توافقت دول الاتحاد الأوروبي عليها بصفة مبدئية.
معاناة مكبوتة تحت سطح الديمقراطية
أنضجت سياسات التجنيس المتشددة معاناة غير ملحوظة تحت سطح الديمقراطية تمسّ فئات وأوساطاً دون غيرها. من شواهد ذلك أنّ نخباً أوروبية مسلمة في الحياة الأكاديمية والبحثية والثقافية والإعلامية والمجتمعية بقيت عالقة منذ عقود في غرفة الانتظار بعد إحباط طلباتها المُتلاحقة لحيازة الجنسية، أو لعلّها قنطت من إمكانية ذلك تحت وطأة الصرامة المُتزايدة من حولها في هذا الشأن.
تتسبّب تقارير تشويه وتحريض تتفرّغ أذرع “صناعة الإسلاموفوبيا” لإنتاجها وتتلقّفها وسائل إعلام ومنصّات شبكية عبر أوروبا؛ في تكثيف هالة الشكوك حول الشخصيات والقيادات المحلية والدينية والناشطين في المجتمع المدني إن كانوا من المسلمين، ما ينتهي على الأرجح إلى إثقال ملفّاتهم التي تنظر فيها سلطات الاختصاص إنْ تقدّموا بطلبات حيازة الجنسية.
لا صوت مسموعاً لبعض الفئات المُتضرِّرة ولا نصير لها تقريباً في الحياة السياسية والمجتمع المدني، رغم الهواجس المحقّة التي تطاردها من إمكانية حصولها على الجنسية في الحاضر والمستقبل قياساً على صعوبات غير منطقية تواجهها في الحصول على الإقامة أساساً؛ أو بمقتضى أسئلة اتِّهامية الطابع تنضح بالتحيُّز الثقافي وُجِّهت إليها في استدعاءات أجهزة الأمن أحياناً.
من ضغوط الواقع أن لا يجد المتضرِّرون من هذه الوقائع والممارسات، غير النادرة، فرصة بوْح بتجاربهم أو امتياز تعبير عن قلقهم؛ كما عليه الحال مع أئمّة وعلماء مسلمين في بعض البلدان الأوروبية مثلاً، أو مع ناشطين في مؤسسات المجتمع الأهلي وشبكات مناهضة العنصرية والإسلاموفوبيا أحياناً؛ التي يطاردها سياط الذمّ والتشهير ومساعي الحظر والتقييد في بلدان أوروبية معيّنة. ممّا يزيد الضغوط المعنوية ويُفاقم العواقب الإجرائية أنّ المسلمين ظلّوا وجهةً قنص مُفضّلة لأحزاب أقصى اليمين؛ وحتى لبعض أحزاب الوسط ويمين الوسط التي تراهن على جدوى لعبة التسخين والمزايدة هذه في تحسين فرصها الانتخابية.
ثمّة انطباع يتولّد لدى بعض المسلمين بالتالي، بأنّ النشاط في المجتمع المدني والحياة الثقافية وإبداء الرأي وإظهار التعبير الحرّ في البدايات قد يجرّ كلفة باهظة على أصحابه في النهايات؛ أي عندما تحين لحظة التقرير في مصيرهم؛ بين الاستيعاب ضمن عباءة “المواطنة” والاستبعاد الصارم منها. يُحرِّض هذا المفعول الرادع على تفضيل الانكفاء والانزواء واختيار مسلك التهميش الذاتي وتخفيض الصوت خلال المكوث المديد في هوامش بيئة ديمقراطية لا تحتفي بهم. ومن مفارقات الواقع أن يتحدّث بعضهم بانفصام مثير للدهشة عن مزايا العيْش في “بيئة ديمقراطية” دون التصريح بأي انزعاج من أنّها تستبعدهم من حقّ الانتخاب في المستويات جميعاً.
“ديمقراطية ليست لنا”
لا يخلو رفض طلبات التجنيس من دلالات ذات وطأة؛ فقرارات الرفض الرسمية التي يتلقّاها بعضهم بعد سنوات مديدة من الانتظار والتهيّؤ؛ ستأتي بنكهة الاستبعاد، وقد تُشعِر هؤلاء بأنّها “ديمقراطية ليست لنا”، فسادة القرار لم يروا فيهم أهلية الانتماء إلى هذا الوطن وإنْ أُفنى العالقون عقود العمر فيه.
يقضي منطق الاستبعاد من خيمة الديمقراطية بأن تتطرّق مداولات “المعارك الانتخابية” إلى هؤلاء، ضمن ملفّ “المهاجرين” الذي يحظى بصدارة مزمنة وأولوية في التسخين في العديد من البيئات الأوروبية، فيأتي الحديث التصعيدي عنهم وليس معهم أو باسمهم.
من نافلة القول أن لا يجد المُستبعَدون من المواطنة أيّ “لوبي” يدافع عنهم من داخل الحياة السياسية لأنّهم بلا أصوات انتخابية أساساً، ولأنّ أيّ “جماعة مصالح” خاصّة بهم ستبقى “بلا أسنان” بمقتضى توازنات انتخابية لا نصيب لهم منها.
من هم المواطنون وما هو الشعب؟
تُحدِّد مسألة منح الجنسية مَن هم “المواطنون” تحديداً، وما يكون “الشعب” تعييناً، فتتأهّل أوراق الجواز الأوروبي القرمزي لأن ترسم خطّاً فاصلاً بين “المواطنة” وانتفائها، مع ما يترتّب على هذا من حقوق دستورية ومكتسبات معنوية. يتقرّر في لحظة معيّنة أن يصير أحدهم أو إحداهنّ “مواطناً” أو “مواطِنة” فجأة لأنّ قرار الموافقة بشأنه صدر حقّاً، بينما يُستبعَد آخرون من هذا الامتياز ويبقون رغم ذلك مُطارَدين بإملاءات “الاندماج” و”التكيّف” ضمن البلد وأنظمته وثقافته. لكنّهم جميعاً، سواء أكانوا “مواطنين” أم غير مُجنّسين، يُطالَبون بدفع الضرائب وبأداء التزامات وواجبات بشكل متكافئ، ويتأثّرون على نحو مباشر ومتساوٍ تقريباً بالسياسات المحلية وخدمات الإسكان والصحّة والتعليم والمرافق والبنى التحتية؛ ممّا يندرج ضمن مسؤوليّات السلطات البلدية والجهوية التي يُدعى “المواطنون” وحدهم لاختيار من يشغلونها عبر الأنظمة الانتخابية.
يُلاحَظ الأثر الأيجابي لمنح غير المُجنّسين حقّ المشاركة في التصويت أو حتى حقّ الترشّح في الانتخابات المحلية أحياناً من خلال فحص تجارب الانفتاح عليهم كما استقرّت في دول البينيلكوس مثلاً، أي هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ، وفي دول اسكندنافية، علاوة على تجارب جزئية ضمن أقاليم أو فئات محدّدة في بلدان أوروبية معيّنة. شجّعت هذه التجارب على انخراط مكوِّنات سُكانية أعرض في العملية الانتخابية ورسمت للبرلمانات والمجالس المحلِّيّة مشهداً نيابياً يُعبِّر بشكل أقرب نسبياً عن واقع التنوّع السكاني القائم، وإن حصل هذا أحياناً بصفة تنتقي فيها بعض الأحزاب وجوهاً معيّنة لتشكيل مظهر تنوُّع شكلي يتيح لها في الوقت ذاته امتصاص أصوات التجمّعات الإثنية.
على أنّ كثيراً من الدول الأوروبية ما زالت تحرم مَن لا يحملون جنسيّاتها من حقّ الانتخاب الإيجابي (الترشّح والتصويت) أو السلبي (التصويت دون الترشّح) في الانتخابات العامّة البرلمانية والرئاسية وفي المقاطعات والأقاليم والبلديات والأحياء السكنية علاوة على انتخابات البرلمان الأوروبي والاستفتاءات الشعبية، ويُستثنى من ذلك مواطنو دول الاتحاد الأوروبي الأخرى الذين يُمنَحون حقّ التصويت ضمن مستويات محلِّية معيّنة. دفعت “فجوة الديمقراطية” هذه إلى إطلاق مبادرات وتحرّكات في دول أوروبية عدّة لمعالجة هذا الخلل. تشهد ألمانيا، مثلاً، منذ نهاية سنة 2022 مساعٍ لإرخاء قبضة قانون الجنسية المُتشدِّد نسبياً على نحو يتيح تجنيس فئات عالقة في رواق الانتظار المُكتظّ بالساعين إلى “المواطنة”، بعد أن تعاقبت سياسات التشديد على قانون الجنسية الألماني خلال سنوات سابقة مع تضمين بنود تتيح سحب الجنسية من المجنّسين دون غيرهم في بعض الحالات.
ثمّة تطوّرات تشريعية طرأت في هذا الشأن، من قبيل منح حقّ التصويت للمقيمين جميعاً في انتخابات البرلمان المحلي والانتخابات المحلية في كل من اسكتلندا وويلز في المملكة المتحدة بدءاً من عام 2022. ويتفاوت منح هذا الحقّ حسب كل كانتون في سويسرا، طبقاً للصلاحيات الدستورية الممنوحة لكلٍّ منها في أن يُقرِّر بذاته في هذا الشأن، لكنّ معظم الكانتونات السويسرية ما زالت تحرم غير المُجنّسين من حق الترشّح والانتخاب معاً، وبقيت تجارب انفتاح الديمقراطية عليهم محدودة جغرافياً ضمن هذا البلد. وفي المحصلة يبقى ربع سكّان سويسرا مُستبعدين من نطاق الديمقراطية لأنّهم لا يحملون الجنسية ببساطة (معطيات 2023). تضغط مبادرة “أربعة أرباع” باتجاه تخفيف سياسة التجنيس السويسرية المتشدِّدة التي تسبّبت في وجود مليونيْ شخص، من أصل ثمانية ملايين، في البلاد خارج الحياة الديمقراطية، لأنهم لا يحملون جنسيتها. تترافع هذه المبادرة لأجل الوصول بسويسرا إلى “ديمقراطية حقيقية”، من خلال “إنهاء العراقيل والتعسّف” واستحداث “معايير موضوعية ومعاملات عادلة” في ملف الجنسية.
ديمقراطية أثينية في فيينا مثالاً
تميّزت التجارب الديمقراطية التي تُعدّ مبكِّرة تاريخياً باستثئار فئات معيّنة بامتيازاتها، حتى أنّ الديمقراطية الأثينية التي يُشار إليها عادة على أنها ريادية في طليعة خطّ الزمن؛ بقيت حكراً على المحظيِّين بها فقط، الذين كانوا أدنى من ثلث السُّكان وضمن نطاق جغرافي محدود فقط، وكان المُقيمون “الأجانب” في تلك الرقعة الضيِّقة مُستبعَدين أيضاً من التصويت فيها بطبيعة الحال.
أمّا اليوم؛ فإنّ قرابة ثلث الأشخاص الذين يعيشون في العاصمة النمساوية لا يحقّ لهم المشاركة في أي عملية اننخابات عامّة؛ للبرلمان الأوروبي، ولرئاسة الجمهورية، وللبرلمان الوطني، ولبرلمان مقاطعة فيينا ومجلسها البلدي، ولمجالس الأحياء السكنية أيضاً، علاوة على الاستفتاءات الشعبية، رغم أنّ أكثر من نصف هؤلاء يعيشون في المدينة منذ أكثر من عشر سنوات (حسب معطيات سنة 2020). يُتوقّع أن تتصاعد هذه النسبة بشكل واضح مع مرور الوقت بالنظر إلى أنّ النمسا تتميّز بسياسة متحفِّظة للغاية في منح الجنسية قياساً بدول أوروبية أخرى.
حاولت سلطة الحكم المحلي في فيينا معالجة هذا الخلل الجسيم جزئياً فقرّرت في عام 2003 منح حقّ التصويت دون الترشّح في مجالس الأحياء السكنية للمقيمين عموماً، لكنّ المحكمة الدستورية النمساوية أبطلت قرار حكومة فيينا في السنة اللاحقة استناداً إلى تعارُضه مع قانون الانتخاب. تصاعدت نسبة هؤلاء المُستبعَدين من التصويت المحلِّي من 13 في المائة سنة 2003 إلى أكثر من ثلاثين في المائة من سكّان فيينا المشمولين بالسنّ الانتخابي سنة 2020، وقفزت النسبة بوضوح في بعض الأحياء السكنية وضمن بعض الشرائح العمرية بشكل خاصّ، رغم أنّ 80 في المائة من هؤلاء يعيشون في فيينا منذ خمس سنوات على الأقلّ. كما تضاعفت أعداد المولودين في فيينا الذين لا يحقّ لهم التصويت في أيّ انتخابات رغم دخولهم في السنّ الانتخابي؛ إلى أكثر من الضِّعف خلال العقديْن الأوّليْن من القرن الحادي والعشرين؛ من 40 ألفاً إلى قرابة 90 ألفاً عبر المدّة ذاتها.
ظلّت مُطالبات حكومة فيينا المحلية المُنادية منذ ذلك الحين بمنح حقّ التصويت لسكّان المدينة جميعاً بلا استجابة تشريعية تدعمها من المستوى الاتحادي الذي يُهيْمن عليه اليمين وأقصى اليمين، رغم تنبيهها المتكرِّر إلى أنّ استبعاد نصف مليون من سُكّان فيينا من الانتخابات المحلِّيّة (معطيات 2020) يمثِّل “قصوراً في الديمقراطية” وفجوة عجز في تطبيقها.
سقف زجاجي ينتظر الصاعدين
تشهد حالة فيينا النموذجية تلك على معضلة يمكن العثور عليها بأبعاد متعدِّدة في عواصم ومدن أوروبية أخرى. تُحُول حالة الاستبعاد هذه دون انخراط فئات سكانية عريضة في الحياة الديمقراطية، ومن شأنها أن تُعرقِل نضوج تفاعلهم وتجاربهم إن سُمِح بصعود بعضهم بصفة مُتأخِّرة إلى قطار المشاركة السياسية دون أن يجدوا ثقافة ترحيب بهم، فالاستبعاد لا يُعين على نموّ خبرة المشاركة كما أنه يمنع بالأحرى تمثيل مصالح هذه الفئات في الحياة الحزبية.
على أنّ حيازة حقّ التصويت والترشّح لا يقضي من تلقائه بانفتاح آفاق الصُّعود في مراتب الحياة العامّة في وجه “المواطنين الجُدُد”، ذلك أنّ “السقف الزجاجي” النمطي من شأنه أن يضع عوائق غير مرئية تعرقل ارتقاء منتسبي بعض الفئات والأوساط في مواقع العمل الحزبي والمسؤوليات السياسية. ليس نادراً من هذا الوجه أن يجد بعض الداخلين الجُدُد إلى رواق المشاركة أنّ خلفياتهم الإثنية والدينية تجعلهم في مرمى تحامُل سياسي وإعلامي قد ينتهي بإخراج بعضهم من الحياة السياسية سريعاً قياساً بأقرانهم المحسوبين على “مجتمع الأغلبية”.
لا مناص، في النهاية، من الاعتراف بأنّ جودة الحياة الديمقراطية تتضاءل إن لم تضمن مشاركة أوسع فئات ممكنة من جمهورها في مواسمها الانتخابية. يتجلّى القصور عندما تحول بعض العراقيل، أكانت مقصودة أم غير مقصودة، دون تكافؤ الفرص في المشاركة الانتخابية أو في الارتقاء في مراتب المواطنة أو في الصعود في الحياة السياسية؛ حتى مع حيازة حقوق التصويت والترشّح أحياناً.